الحرب في زمن الكورونا
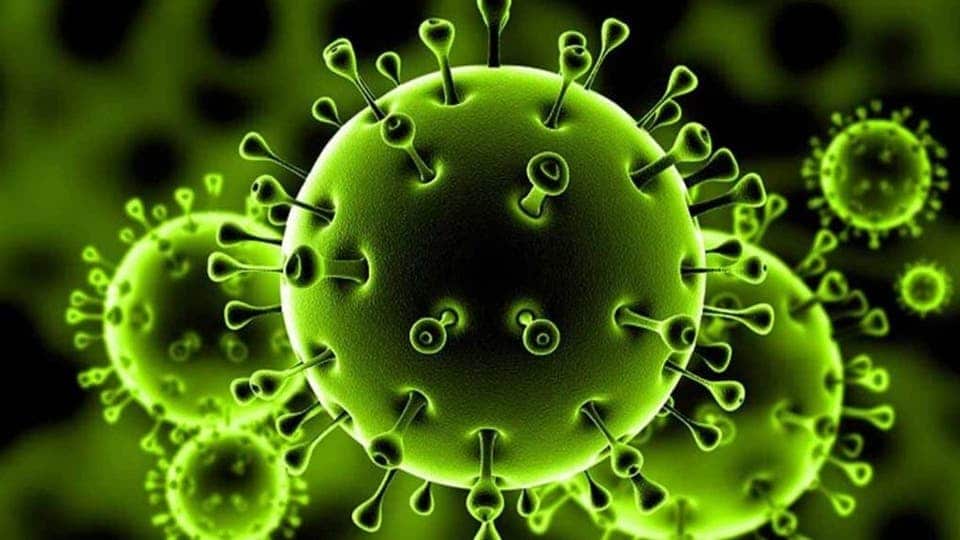
ولَكَم هو من الجلي أن الطبيعة لا تعترف بمقدسات البشر، مهما آمن بها الإنسان وتشبع بها، وعاش وفقًا لها، ولكم هو من الواضح أن المعنى غير موجود فعلًا في هذا العالم، أن الطبيعة الباردة للوجود تكاد تتلاعب بالإنسان كما يتلاعب المهرجون بكراتهم الملونة، كما أنها لا تحمل أي اهتمام لكل ما حققه هذا الإنسان، من حضارة وثقافة وعصرنة، العلم نفسه الذي لعله أرقى مرحلة من مراحل الفكر البشري يقف عاجزًا أمام المعضلات البيولوجية.
والحرب في زمن الكورونا ليست إلا تعبيرًا عن الصراع الأيديولوجي والوجودي الذي يعيشه إنسان اليوم. بين رغبة وتخوف، بين أمل وتشوش. ومما لا شك فيه أن هذا الصراع ليس حديث العهد على الكائن البشري، بل هو منذ مطلع فجر البشرية، وسيلازمها إلى أن تنتهي الحياة على أرض هذا الكوكب.
إلا أن هذا الصراع قد اتخذ شكلًا مميزًا خلال الأشهر القليلة الماضية، أمام الموجة الإعلامية التي صارت تستقي كل مواضيعها من الحديث عن هذا الوباء. والوباء في حد ذاته ليس إلا تعبيرًا من الطبيعة عن عبث تكوينها البيولوجي، بيد أن هذا الإنسان الذي ظل يعتقد لقرون أنه مركز الكون، وأن ماهيته تكمن في وجوده لا غير، هو مهدد بالزوال بسبب فيروس يعجز جهاز الإنسان المناعي عن مقاومته، فإن كان الإنسان كائنًا مثاليًا، وإن كان وجوده بعيدًا كل البعد على أن يكون صدفة، لكانت له مناعة كاملة تحميه عن كل اختلال بيولوجي أو فيزيولوجي، لكن الواقع يثبت العكس في حقيقة الأمر، والكائن الإنساني هو بعيد كل البعد عن المثالية. والأمر هنا يتعلق بالمثالية البيولوجية، ناهيك عن المثالية الوجودية والأخلاقية التي يفتقدها المرء هي الأخرى في هذا العالم، بل لعله يكون اليوم في أمسّ الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
وظهور وباء يعني أن حياة الإنسان في خطر، والخطر يعني الفناء، والزوال والاضمحلال. والفكرة هي واحدة: الموت! وهي فكرة تبعث في روح الإنسان قلقًا وجوديًا لا يُحتمل، لأن أقدس شيء عند الإنسان الموجود هو الوجود ذاته، بيد أن هاته الحياة مهما حملت في طياتها من المعاناة والألم والشقاء فإن الإنسان سيبقى مفضلًا لها على الموت! وسيظل متشبثًا بحافة الوجود إلى أن تنزلق أظافره المدماة واحدًا تلو الآخر، دون رغبته، ويصير بالتالي عدمًا، وكأنه لم يكن أبدا !
والحق أن ما يقلق الإنسان حول الموت ليس هو التخلي عن الحياة، بل هي صدمة الانتقال من حالة لأخرى كما تسمى في علم النفس الإكلينيكي. تلك الصدمة تخفي مكامن الخوف من المجهول، الخوف مما لا نعرفه، فأما ما نعرفه فإننا نعلم مسبقًا كل شيء عنه، ولا سبيل لكي نتفاجأ منه، فمن يدخن يعلم مسبقًا بأن السيجارة ستقتله، ومع ذلك يدخن طيلة حياته، إلى أن يموت. وهذا لأنه يعلم النتيجة المحتملة من فعله ذاك، تمامًا كما يتبخر الماء في مئة درجة مئوية. لكن، الحال مع الموت أننا لا نعلم أي شيء عما يجري بعدها، ولا حينها، لذلك يختار الإنسان، بشكل لاواعي، في مرحلة ما، أن يتجاهل فكرة الموت أقصى ما أمكنه ذلك، أن يعيش دون أن يفكر ولو للحظة بحقيقة الموت، فيتجاهلها هكذا، بسذاجة لامبررة، لاواعية. لكن مسؤولة في الوقت ذاته !
إن التفكير في الموت يحيلنا إلى فكرة أساسية: ما جدوى الحياة؟ ولعله في عمق هذا السؤال تكمن كل اللامثالية الوجودية للإنسان في هذا العالم، بيد أننا نرمي للوجود دفعة واحدة، دون غاية، ودون ماهية، ودون أدنى معنى! لنعيش الحياة كممثل فوق خشبة، معصوب العينين، دون سيناريو أو أي تعليمات مسبقة، فيطلب منا أن نرتجل، وأن نحقق أهدافنا، الأهداف التي أردنا تصديقها، وأن نتخذ القرارات الصحيحة، وألا نخطئ، وأن نكون مثاليين لأقصى الحدود. لكن، أليس الموت سوى امتدادًا للحياة؟
إعلان
وفي الوقت الذي يحارب فيه الإنسان ليثبت وجوده فوق هاته الرقعة الضئيلة من الكون، نجد المتدينين يحسبون أن هذا الوباء انتقامًا من الإله للطوائف الأخرى، أو لعلهم حينما يجتاح الفيروس بلدانهم يحسبونه ابتلاءً و اختبارًا لمدى إيمانهم، من الإله نفسه. و أمام انتشار الشائعات و الأخبار المزيفة، نجد الهلع المبتذل يتمظهر من كل جهة، رجل هناك ادعى أنه يملك نبتة ما تشفي كل مصاب، آخرون اختاروا الصلاة في جماعات ، كل من جهته يحاول أن يقاوم بطريقة ما، أن يجد عزاءً ما من الوضعية، ويعلن للعالم رغبته في البقاء، ولو كرد فعل لاشعوري!
إن الوعي الجمعي للمجموعات البشرية الممتدة هو ما يشكل أكبر جزء من أيديولوجيا هذا الصراع، الصراع مع الموت، أو بالأحرى، الصراع من أجل الحياة، من أجل البقاء. لطالما عاش الإنسان و آمن بقانون البقاء للأقوى، حينما اعتبر نفسه على رأس الهرم، فهاهو نجده اليوم مهددًا بعدم البقاء، لأنه لم يعد الأقوى، و لعله لم يكن الأقوى في أي وقت مضى. بل إن ما يزعج الإنسان أكثر من أي شيء آخر هو أن هذا الوباء قد قام بمساس النرجسية العليا للكائن البشري، تلك التي تجعله يحس بأن الكون متمركز حول وجوده، و أنه بدونه غير قابل للاستمرار أو الكينونة. و الواقع أن هذا الكون هو أقدم من الإنسان بكثير، فالكائن البشري أو “الهوموسابيان” لم يظهر إلا قبل 000 ,200 سنة، و الكون قد وجد منذ ما يقارب 13.7 مليار سنة. مع أن هاته الأرقام لا تحمل في طياتها أي معنى فعلي أو أي خلاصة معطاة بشكل قبلي ونهائي، إلا أنها تعكس ولو جزءًا من حقيقة وجود الإنسان فوق أرض هذا الكوكب.
إن الجانب الإيجابي، حسب رأيي الخاص، من ظهور هذا الوباء، هو أنه قد جعل الإنسان أكثر حقيقة مع ذاته، بيد أن في آخر المطاف ليس الموت هو الهدف، أو الغاية، بل هو المصير، والمآل، فكل موجود هو بالضرورة خاضع لقانون التناهي، الكون نفسه سوف يؤول نحو الزوال.
لذلك، فالاقتراب من الموت والعيش بين الموت من شأنه أن يضفي على حياة الإنسان من الواقعية ما يكفي أن تسقطه في أحضان حقيقة باردة، تناساها أو كبتها لاشعوريًا، بفعل الثقافة الاجتماعية والصيرورة الديناميكية للحياة، تلك التي نزعت كل قداسة عن دفء الموت و خلاصه، تلك التي أعمت بصيرة الإنسان المعاصر، و وضعت عنق إنسانيته تحت شفرة المقصلة. لذلك فلا غرابة أن يهرع الناس للمحلات التجارية فيستنفذون مخازينها، لأنه رغم أن الوباء كوني، ولا يميز بين عرق وآخر، أو مجتمعات دون أخرى، إلا أن فردانية الإنسان قد أوقدت النار في هشيم أنانيته لامحالة! وقد دفعته، بشكل أو بآخر، للبحث عن طوق النجاة، وسط يمّ التيه والخذلان الذي تعيشه البشرية في اللحظة ذاتها، منتهاها وكلها.
إعلان
