أُفول العَقل الإسلاموي بين التاريخ والعصر “مفهوم الخلافة أنموذجًا” ( ١ )
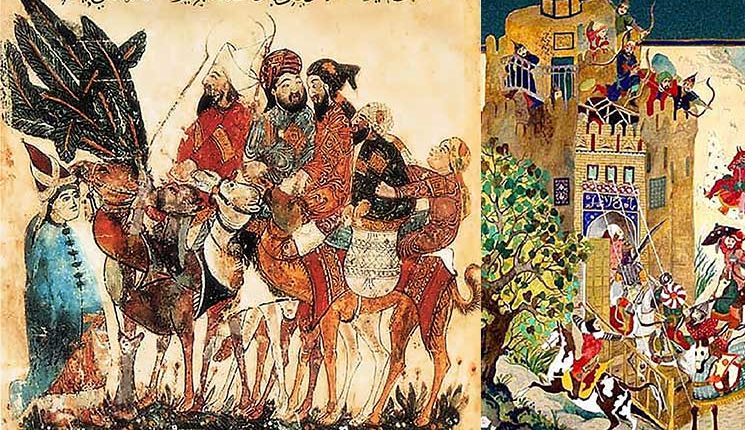
مازالت أزمة الفكر العربيّ المعاصر تدور حول موضوعات الهوية بامتياز -الصراع بين الأصالة والمعاصرة، وبين التأكيد والنفي- وهي مشكلة حادة في التفكير والجِدال السّجالي الدائر والذي يُحدث وضعًا صفريًّا مُفارقًا بين أصحاب السلف التراثي وأصحاب الخلف التحديثي. وبالرغم من كُل المقاربات التي تحاول شَقّ الأفق لرؤى أكثر عمقًا في كلّ الجوانب -سياسية واقتصادية واجتماعية- إلا أنّ حالة التخلف الحضاري المعاصر وضع قائم بدون مخرج حتى الآن، وفي هذه المقالة (على جزأين) سوف نحاول القراءة في جانب الهوية وأحد أشكال وتبعيات وضع التخلف الحضاري؛ من النظر للماضي والحنين لاستنساخ فتراته إلى المستقبل في نموذجِ منظور الخلافة الإسلامية.
ويأتي مفهوم الخلافة كنموذج لرمز ومثال الحكم السياسي الرشيد، وطريقةً لمعالجة حالةِ التخلف والتأخر وحلّ أزماتنا المعاصرة لاستعادة أمجاد السابق، وذلك من المنظور الديني المتأصل في الهوية الثقافية المجتمعية، والمفارقة في الخطاب الرائج ثقافيًا ههنا، ترجع لانفصال المفهوم عن سياقه التاريخي من الأساس، وفي أنّ التسويغ لإعادة نفس النموذج والتجربة مرة أخرى تعتمد على إضفاء طابع القداسة الدينية على الشكل السياسي.
ومن هنا نحاول بشكل مبدأيّ تحليل أهم العوامل الأيديولوجية التي تؤثر في الخيال والانفعال الشعوري الجمعي للهوية الثقافية الإسلامية، والتي تُبقي مفهوم الخلافة القديم قيد التصور والاستحضار النوستاليجي وتَظهر تجليات وتبديات ذلك في أدبيات حركات الإسلام السياسي.
ميتافيزيقيا نهاية التاريخ
تحتل السرديات الكبرى على نبوءات واعتقادات ماورائية عن مسار التاريخ، وكلّ سردية تُؤَصّل لرؤيتها الأيديولوجية في اتجاه انفرادها الشامل بالحل الأخير للأوضاع . نهاية التاريخ تعني هنا تفوّق سردية ما ومناسبتها النهائية لحياة مجموعة من البشر كمطاف أخير لهم.
وفكرة نهاية التاريخ ليست خاصة فقط ومرتبطة بالفيلسوف السياسي الأمريكي فرانسيس فوكوياما الذي أعلن عن نهاية التاريخ وتطور الفكر الإنساني عند الليبرالية الديموقراطية في كتابه المشهور “التّارِيخ والإِنسانُ الأخير”، بل نجد نفس الرؤية الماورائية في الطرح المادي للماركسية في نموذج تقسيم كارل ماركس للتاريخ الذي يختم ذروته إلى النهاية الشيوعية للمجتمع، أما من جانب الأديان السماوية -الإبراهيمية- فيسود الاعتقاد بنهاية التاريخ في ظلّ مفهوم الخلافة، فالمستقبل النهائي لمسيرة الحياة هي انتصار أطروحة الإيمان.
إعلان
وإذا نظرنا لطبيعة الهوية الجمعية والمهيمنة ثقافيًا في الأقطار الإسلامية، تتضح جذور روايات نهاية التاريخ الدينية، وكلها تقع تحت قيد شرطي هو توفر دولة الخلافة/الإمامة، فالارتباط وثيق بين التفسير الميتافيزيقي ومفهوم الخلافة، وتنقسم الاختلافات الداخلية حول تحقق المنتظر، فالشائع أنّ المرويات الإسلامية عن قصص المهدي المنتظر وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى، ترسخ كعقيدة لأغلب المسلمين، ولكن التعاطي مع المرويات مُختلِف من حيثُ التأويل، فقطاع كبير يقنع بحتمية حدوث وقائع المرويات دون تدخل من المسلمين وهذا موقف اتكالي سائد، وموقف آخر يتبنى فاعلية التدخل لتحقيق القصص بدلًا من الانتظار، والمشاركة من خلال المجريات الواقعية؛ وانقسما إلى تيارين، إصلاحي من خلال التدرج في بناء الخلافة الإسلامية مجددًا وذلك بداية من أول مكون للمجتمع وهو الفرد المسلم إلى الأسرة المسلمة إلى المجتمع المسلم والدول المسلمة، وحينها يفتح الطريق لإقامة دولة الخلافة مثل نموذج جماعة الإخوان المسلمين.
والتيار الراديكالي الذي يتخذ حركة قطيعة تامة مع الاتكالية ويسعى لفرض واقع، وهذا ما حدث بالفعل مع الثورة الإسلامية في إيران، عندما تخلت الآراء الشيعية المذهبية -الإثنى عشرية- عن الانتظار حتى عودة الإمام من الغيبة، ونجحت في إقامة مفهوم عصري للإمامة وهي ولاية الفقيه.
والحركة الصهيونية أيضًا؛ تزعمت تأويلًا دينيًا لكي تشرع ادّعاءها بالحق في الأراضي الفلسطينية، وقصة أرض الميعاد والوعد التوراتي، فبدلًا من انتظار الماشيَّح -المسيح المخلص- لكي يخلص وينقذ اليهود من حالة الشتات (الدياسبورا) والمنفى ويعيدهم إلى أرض الوعد ويقيم دولتهم ويبني هيكل سليمان ويحكم بالشرائع التوراتية، قام هرتزل والحركة الصهيونية على إعادة تأويل العقيدة الاسترجاعية، وبالقيام بدور الماشيح وإقامة استيطان واحتلال تحت تلك المزاعم الدينية التأويلية.
وهذا التيار الراديكالي إسلاميًا هو ما يتمثل الآن في تنظيم الدولة الإسلامية -داعش- فهم لم يخرجوا من العدم بل من داخل الهوية الثقافية وتأويلاتها، فساروا أيضًا إلى رفض الانتظار والاتكال، واختاروا الصدام لتحقيق العقيدة واقعًا، وهذا موقف عصري متطور داخل الراديكالية في حركات الإسلام السياسي السُني عن الأخرى مثل الجهاد والقاعدة -ولذلك يُفتك بالأخير من قبل تنظيم الدولة لأنهم لم يتخذوا نفس الدرجة من التأويل- فالتنظيم أقام خلافة ودولة بالفعل السيادي سياسيًا وجغرافيًا لا لمجرد معاداة الإمبريالية مثل حركة الجهاد.
سيكولوجية التخلف الحضاري
يقبع إنسان الشرق تحت وطأة الواقع السياسي والاجتماعي الذي لم ينهض بعد من توابع حركات الاستعمار القديم ومن بَراثِن التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية، التي تجعل حالة الجهل والتأخر وضع مُستغَل على أصعدة الهيمنة والمصالح، ومع تردي وفشل مشاريع التنمية والنهوض وسيادة الديكتاتوريات الفاسدة، يكون إنسان الشرق على هامش التاريخ وذلك ما يجعل الهوية النفسية منحدرة في الاضطراب والتناقض؛ ومن الممكن النظر لغالبية سيكولوجية إنسان العالم المتأخر -الثالث- بأنه يقبع تحت عقدة النقص والشعور المتلازم بالعار من جرّاء ظروفه المتأخرة والمتأزمة وجوديًا في الحاضر وانسداد آفاق الآمال والمستقبل، فيشعر بكمّ كبير من الدونية بين العالم المتأخر وبين العالم المتقدم ولذلك يحاول التزلف للماضي ليعزّز الهروب من واقع القهر، فيسهّل اجتياف مفاهيم وأسس الخلافة المستمر في البنية الاجتماعية النفسية تحت أثر الهوية الجمعية المتوارثة تقليدًا، والذي يعوّض به إحساس انعدام السيطرة على المصير الخاص.
يذكر لنا د.مصطفى حجازي في كتابه “التخلف الاجتماعي” خاصيّتين أساسيتين لحالة التخلف الاجتماعي، وهما: التمسك بالتقليد والرجوع إلى الماضي. وليست تلك السلفية خاصة بالبنية الاجتماعية بل تعبر أيضًا عن أوالية دفاعية نفسية للإنسان المقهور، فيقول: “تشيع السلفية بشقيها -الرضوخ للتقاليد والأعراف والاحتماء بالماضي وأمجاده- من الناحية النفسية، بمقدار درجة القهر التي تمارس على إنسان العالم المتخلف، وبمقدار إحساسه بالعجز والضعف والغلبة على أمره إزاء غوائل الطبيعة وعنت المتسلطين. وهي أوالية دفاعية إزاء تحديات لا قبل له بها (……) “تبرز السلفية بوضوح كوسيلة حماية من خلال الانكفاء على الذات، والرجوع إلى الماضي التليد” [١]؛ إذًا التقليد والنكوص إلى الماضي -النوستاليجيا-والاحتماء بفترات الأمجاد هي معبّر عن آلام الحاضر وانفلات زمام المستقبل، وهنا تُضفى رمزية القداسة الدينية على حركة التاريخ المشرف للذات وعصور الخلافة الإسلامية كدلالة على الهوية المفقودة، فذلك معبّر عن حالة الهروب من الحاضر، لا استحضار التراث كنموذج لإعادة تفعيل الذات. “يهرب الإنسان المقهور في أمجاد الماضي، ويتيه نشوانه في مظاهر عظمة تاريخه وتراثه، وهو يختار من هذا الماضي الذي يشكّل الخير كله، على عكس الحاضر الذي يشكل الشرّ كله، مقياسًا للحياة: تلك كانت أيام، تلك كانت الحياة. وفي هذه الرجعة إلى الماضي يتماهى الإنسان المقهور خصوصًا بالبطولات العسكرية، بخوارق الفروسية وبكل مظاهر الأبهة في قصور الخلفاء والأمراء” (………) “يلوذ الإنسان المقهور بتراثه وأمجاد هذا التراث. ويتمسك به بشكل جامد، حتى لا يعود يرى من مجال لخلاص من مأساة الحاضر، إلا بالعودة إلى التراث والسير الجامد على غراره دون مراعاة لحركة التاريخ” [٢]
وحالة التباهي بالتاريخ الماضي هو نوع من كبت لقهر الواقع ومشاعر النقص والعار، فكما اعتدنا في مصر منذ الصغر على التفاخر بالحضارة الفرعونية والماضي السحيق لدرجة الوصول لحالة النُفاج الاجتماعي [٣] يعيش إنسان الشرق في تلك الحالة النفسية مع مفهوم الخلافة، فالخلافة على هذا النحو الاعتقادي والنفسي الاجتماعي، متأصلة في المنشأ الثقافي والتصور الجمعي، ولذلك يكون مجتمع القهر والتخلف في حالته الاتكالية والرضوخية العامة بيئة خصبة لظهور ارتداد حركي راديكالي يحمل نفس السمات السيكولوجية للقهر الوجودي؛ فمن اليسير إذًا تقبل النظرة الاسترجاعية ورواجها، فكلّ ما يتصل بالدين من قريب أو بعيد يرتفع إلى مراتب مقدسة ومحصنة، فتكون عبارةً عن دوجما غامضة.
لذا ولكي يستلزم الحديث عن مفهوم الخلافة، لابدّ أن نرجع إلى طيات التاريخ أولًا، فنحاول إزالة ما يظهر من غشاوة مرتبطة بالخلافة وأن نجري عمل حفريات للعقل العربي لكي نصل لصورة تقريبية عن الذهن العربي عبر تشكّله ونضوجه وذلك حتى نرى ملامح ومكامن التشوه في الهوية المعاصرة بين تشتت الماضي وتيه الحاضر وضياع المستقبل، ولابدّ لذلك أن يكون عبر ردّ الاعتبار للعوامل السياسية والاجتماعية، ووضعِ الشخصيات والرموز الدينية تحت منظور التاريخ الإنساني المرتبط بالسياق الزمني والظرف المكاني والبيئي الثقافي.
حفريات الخلافة
استهلال:
عند الحديث عن الخلافة أو الإمامة كنظام حكم سياسي في التاريخ، دائمًا ما يُثار الكثير من اللغط والريب حول موضوعاتها وذلك مما اعتادت عليه مناهج القراءة التاريخية من الخلط بين العوامل المُشَكِلة للظاهرة، فيكون تحديد ما هو ديني وما هو سياسي بناءً على مواقف ذاتية -أحكام مسبقة- من قراءة تاريخ فترات الخلافة ونشأتها؛ مع افتقاد أداة التفكير النقدي الذي يرد الاعتبار للعوامل المركبة للظاهرة والنظر في مسارتها الجدلية مع حركة الزمن، لسبر أغوار الظاهرة وكشف صور نشاط التفاعل بين أجزائها ومن ثم القدرة على الترتيب والبناء الأقرب للدراسات الموضوعية.
ومن هنا تكون المحاولة في البحث والفهم متحررة من قيود سطوة الكثرة ومنظور المنظومة الثقافية السائدة، فما يهم هو محاولة البحث والفهم المنهجي لالتماس سُبل الموضوعية التي تُقرب الذهن من معرفة تحليلية للأزمات الحالية في العقل العربي الإسلاموي ولذلك يكون من المستهدف هو إثارة نشاط الوعي في مواضع الأزمات المعرفية؛ وبالتأكيد أن موضوع الخلافة إحدى تلك العقبات المترسخة على أصول البنية المعرفية للأمة العربية الإسلامية.
قبل الإسلام:
تشير الروايات التاريخية إلى شأن الصراع القبلي على زعامة محور مكة في التجارة بين عرب الجنوب القحطانيين وعرب الشمال العدناني، وإلى تمكن القريشيين في التغلب والهيمنة وذلك على يد المؤسس قصي بن كلاب الذي استطاع انتزاعها من قبيلة خزاعة بعد مصاهرته لبنت حليل، وملك قصي زمام السيطرة القبلية، فينقل ابن هشام عن ابن اسحاق: “فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكًا، أطاع له به قومه، فكانـت إليـه الحجابـة، والسقاية والرفادة والندوة، فحاز شرف مكة كلها” [٤]
وجعل قصي الزعامة القريشية على مكة لابنه البكر عبد الدار، ومما أثار بعد موته سخط أخوه عبد مناف وتوارث الصراع على الزعامة بين بنو عبد مناف وبنو عبد الدار، ولما هيمن بنو مناف-وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل- على شؤون السقاية والرفادة وتوسع التجارة ورحلاتها انقسم الخلاف داخل بنو مناف والصراع على السيادة بين بنو هاشم وبنو عبد شمس وهو أمية -الذي نفي اختياريًا إلى الشام- وانتقلت من هاشم إلى أخيه المطلب إلى بن أخيه عبد المطلب، وهكذا كانت طبيعة العقلية القبلية العربية حول صراع المكانة القبلية والزعامة الاقتصادية لمكة التي تمثل محطة تجارية للقوافل.
وأما من الناحية الدينية، فلقد ألزمت المصالح التجارية وضع مكة لارتباط التعددية الدينية وما ساعد من استقرار هذا المناخ أمرين، الأول ما تقتضيه أمور التجارة وإيلاف القوافل من تعدد الثقافات والأعراق وبالتالي الاعتقادات، فكانت مكة مركز للتجارة يتقابل بها الوثنيون والحنفيون والصابئة والنصارى واليهود والهنود والمجوس وغيرهم، والأمر الثاني طابع الوثنية كعقائد غير شمولية وتنتشر الوثنية بين القبائل العربية التي تبنى على التعدد والدين والرب الشخصي في اختيار المعبود الخاص، فكانت الأصنام تجاور بعضها على أعتاب الكعبة، وكان من الشائع وجود حالات ونماذج تبشيرية مثل الدعوة إلى الحنفية والتوحيد على ملة إبراهيم ومن أشهرهم أمية بن أبي الصَّلْت الثقفي و زيد بن عمرو بن نفيل والأخير الذي عاصره النبي محمد وشهد له بالإيمان على ملة إبراهيم، ولم تكن تلك الحركات الدعوية تسبب أي ضغائن للقريشيين وزعمائهم بل كانت من الأوضاع العادية.
ويحتل الدين عند العرب قبل الإسلام مكانة عضوية هامة في النسيج القبلي إلا أنها لم تكن هدفًا في ذاتها بل وسيلة أكثر منها غاية، وذلك ما نستقرؤه من الصراع حول المراكز التجارية وتعدد الكعبات وأماكن العبادة حتى أن قصة أبرهة الحبشي التي أوردها القرآن، حيث كان أبرهة منزعجًا من سيطرة كعبة مكة على محور الرحلات التجارية، حتى أن الأشهر الحرم التي حُرم فيها الاقتتال بين القبائل كانت تستخدم لهدف ومصلحة التجارة للمنطقة؛ فكان الاهتمام بالحج أقرب للاهتمام برواج مكة وقدرتها الفاعلة في خلق نشاط أوسع من وراء المناسك الدينية، فاهتمام قريش يدور حول ازدهار التجارة في موسم الحج لذلك يعّد من أفضل وأنسب المواسم “إن أعظم ما يحدو العرب في الجاهلية على قصد تلك الأسواق ما قدمت لك من قيام كثير منها في الأشهر الحرم، ولشيوع الأمن حرمة للشهر، ولأن مواسم بعض الأسواق كعكاظ ومجنة وذي المجاز تقع في أيام حجهم وهي أعمر أسواق العرب بمختلف القبائل يأتونها من كل أوب ومعهم خيرات بلادهم، وتلك ميزة لا تتمتع بها بلدة غير مكة ولا قوم غير قريش” [٥]
والحديث عن الدين كعامل أساسي في التغيير الاجتماعي ونشأة وحدة العرب كدولة، يرجع بنا لتناول أثر الدين في حياة العرب؛ فالدين سابق في الوجود ومحرك الدعوة؛ فكان ملازمًا منذ سعي قصي بن كلاب في تأسيس قبيلة قريش، مرورًا بعبد المطلب ودعوة الحنفية وتأثره بالفرس والروم الذين كان يمثل الدين عندهم أحد الركائز المهمة في السياسية والاجتماع، ولكن تَشكِيل الدين للدولة مر بظروف تاريخية وجغرافية مناسبة لظهوره ونجاح دعوة النبي في لبنة التأسيس، فعند النظر إلى واقع حياة العرب التجارية نجد أن الأديان الوثنية كانت بيئة لها حضور الامتزاج العقائدي الذي يعطي قدر وضرورة للمعاملات التجارية، وكان الاحتكاك العربي وثيقًا مع قبائل يثرب ذات الوجود السامي للديانة اليهودية أو في رحلات الجنوب -وذلك بدون تهميش لشكل الصراع الاقتصادي بين يثرب ومكة حول مراكز الرحلات والتجارة وداخل يثرب مثل مكة كان الصراع بين الأوس والخزرج قائم، فالبنية الاجتماعية بمكة مغايرة للمدينة من حيثُ الاختلاف بين طبيعة الدين اليهودي ذي الشريعة الكاملة التي تحكم العضو في الديانة وبين طبيعة الأديان الوثنية ذات الطابع العائلي والقبلي التي تتمثل في اعتقادات ميثولوجيا وطقسية، والحدود الجغرافية الأخرى شمال الروم وآخر كاتجاه الحبشة حيث معرفة العرب للديانة المسيحية طائفة “النصارى” ووضع تلك الصورة في الاعتبار لمن العناصر الهامة في اتجاه لبنة تأسيس مركز دعوة الإسلام، فالدعوة الإسلامية أكثر أُلفة مع اجتماع يثرب التي ليست بالغريب عن ثقافة اليهود حيث أن الإسلام حمل لواء امتداد الديانات الإبراهيمية، فكانت مكة منشأ النبي على غير قابلية الدعوة لما تمثله من عداء لمصالحها الاقتصادية -دعوات العدل والمساواة بين العرب-، فإن سمات الروابط القبلية تمتاز بالتلاحم والترابط بين أبنائها في طور القبلية البدائي؛ مما يعطي شكل من المساواة والمنفعة المشاعية للثروة، وكان هذا حال العرب قبل تكون طبقية داخل القبائل “في البداية كانت مصادر الثروة لدى القبيلة العربية، قطعان الماشية والعيون والآبار، وكانت ملكيتها مشاعًا بين أفرادها، وشيئًا فشيئًا -مثل كافة المجتمعات- بدأ في الظهور أفراد يمتلكون قدرات خاصة وملكات فريدة “ [٦] ، فتدخلت سمات النفعية والمصالح الفردية في الروابط الاجتماعية وذلك مع تنامي النشاط التجاري، فكانت دعوة الإسلام للمساواة بين أفراد قبائل تحت موضوع الإيمان يمثل خطرًا على الأرستقراطية القبلية .
لذلك كانت يثرب (المدينة) خصبة وجاهزة من جانب طموح منازعة مكة ومناسبة لطبيعة الدين، “كذلك كان للديانتين الإبراهيمتين أو الساميتين جانب آخر ساعد في التمهيد لقيام دولة قريش في يثرب، هو ترسيخ فكرة مسؤولية الإنسان عن أفعاله من خلال الثواب والعقاب على المخالفين وهو ما عرف بـ”الحدود” وهذا أمر لم تكن تعهده بهذا المعنى المنتظم القبيلة العربية” [٧]؛ و أما الاعتقاد التوحيدي الذي ينفي ما دونه، فكان للتوحيد أثر بالغ الأهمية في طريق الدولة المركزية، فالواقع الديني القبلي الوثني صاحب نزعة التعدد -وكان أبناء القبيلة على دين رب قبيلتهم- أما العقيدة الجديدة تضم وتُذعِن القبائل بعقيدة داخل بوتقة واحدة وذلك مما له أثر ارتباط اجتماعي -تشارك وجداني ووجودي -يؤسس نحو المركزية وبناء الدولة.
البعثة المحمدية:
جاءت دعوة النبي محمد من داخل البيت الهاشمي القريشي وحملت معها تطلع سياسي جديد، وطور متقدم عن القبلية المتناثرة، يلم به شمل القبائل العربية -فالواقع يفرز متطلباته- تحت راية عقيدة توحيدية جذورها ملة إبراهيم ومتن مطور من شرائع قديمة ومتطلبات واقعية جدلية، فالعرب يرون الدول والإمبراطوريات ونظمها في رحلاتهم التجارية بل يتواصلون معهم؛ فقد ذُكر أن هاشمًا أبا عبد المطلب كان على صلة طيبة بـ قيصر الروم“يدخل إليه فيكرمه ويحبونه” [٨]، وهذا ما يثري التطلع السياسي فيحدثنا النبي عن نفسه قائلًا: “أنا دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام .. (إلى آخره). [٩] ويضيف ابن عساكر في روايته “فقال أعرَابِي: هاه، وأدنا رأسه مِنه، وكان في سمعهِ شَيء، فقال رسول اللَّه “ووراءَ ذلك ووراء ذلك ” مرتين أَو ثلاثاً. [١٠] فالرؤية والتطلع السياسي في مجابهة الدول العظمى كانت متضمنة في البعثة، فدعوة الإسلام علاوة على كونها دعوة دينية -توحيدية إبراهيمية- ضد الوثنية التعددية فهي تحمل تغيير اجتماعي وبنيوي في الطور القبلي .
وقد استطاعت الحركة الجديدة تحقيق خطوات كبيرة لما تهدف إليه، فبعد فتح مكة وهيمنة المسلمين، تبلورت ملامح أولية للوحدة العربية القبلية “أسلم أبو سفيان وأسلمت معه قريش، وتمت للنبي هذه الوحدة العربية”[١١]، واتسمت فترة التأسيس في السعي لخلق انصهار اجتماعي بين القبائل يقوم على موضوع الإيمان يفكك العصبية القبلية والعائلية للبنية العربية الموحدة الجديدة -عصبية دينية وبداية للمركزية-، ولكن بالطبع لم يكن الاستقرار السياسي مستتب بما يكفي، فما زالت العقلية القبلية هي القاعدة التي يعمل من خلالها الذهن وتقام على أثرها الدوافع.
فكانت عقيدة الإسلام هي دين ودولة ناشئة تتمثل في قيادة سياسية وزعامة عربية للنبي محمد، فحملت الرسالة تشريعات وأحكام لتنظيم المجتمع الجديد ومتطلبات البناء، فكان الدين إذًا ركن أساسي من البنية الناشئة، وقد ساير القرآن غالب وقائع الأحداث طوال الدعوة -تأثيرًا وتأثرًا-، واتسمت النُظم والشرّائع بالمحاكاة والتقرير والتبديل والتغيّر مع مقتضيات وتطورات سير الأحداث، ولكن لم يروى على حد المعلوم أن وجدت رؤية تنظيم لشكل سياسي يُتَبع بعد ذلك، وكل ما يتحدث عن الشأن العام “الشكل السياسي” ينحو شكل الأطر القيمية مثل الدعوة لإقامة العدل والمساواة، ولذلك كان الدين عامل ودافع يفتح الأفق العربي نحو هوية موحدة “البنية الموضوعية”، ولذا كانت الضرورة تحتم وجود خليفة بعد وفاة النبي حتى يحافظ على وضع الوحدة القبلية “هم مسلمون لم يظهروا على العالم إلا بالإسلام؛ فهم محتاجون إلى أن يعتزوا بهذا الاسلام ويرضوه ويجدوا في اتصالهم به ما يضمن لهم هذا الظهور وهذا السلطان الذي يحرصون عليه. وهم في الوقت نفسه أهل عُصبية وأصحاب مطامع ومنافع، فهم مضطرون إلى أن يرعوا هذه العصبية ويلائموا بينها وبين منافعهم ومطامعهم ودينهم” [١٢]
وفاة النبي والسلطة السياسية :
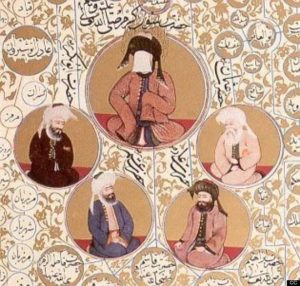
كان العامل المحوري والمنطلق الجوهري في صراع المبايعة لاختيار خليفة للنبي، ينطلق من طبيعة نشأة الدين الإسلامي؛ فالدين في تلك المرحلة غاية والدين هو المؤثر البارز للتغير في التركيب القبلي، والدين مُمثّل في الوحيّ أي النص القرآني -لم يكن قد جمع بعد- والنص يفرض مجموع من التنظيمات والشرائع، فالنص أعطى محتوى الموضوع ولكن لم يعطِ نسق الشكل، ولذلك كان المنظور والحمية القبلية عند المسلمين هي المكون المعرفي للشكل السياسي، فبالرغم من التغير الجذري الذي أحدثه الإسلام في نفوس العرب إلا أن إرث الحمية القبلية لم يفارق الوعي بعد، بل يقف بكل قوة وراء دوافع الصراع حول السلطة، فموت النبي كان حدث جلل في نفوس المسلمين لما يمثله من زعامة وقيمة روحية ولكن سرعان ما تنبه كبار الصحابة لخطورة الوضع داخليًا، فالذي ربط القبائل تحت بوتقة وهدف مشترك هو النبي وحده، ومع ضرورة وجود كيان الإسلام كموضوع؛ فلا بد من وجود شكل لبنية الكيان الوليد، فَعُقد اجتماع السقيفة بشكل عاجل حتى أنه قد تغيب الكثير من الصحابة، وفي ضوء ما ذُكر في بعض المصادر عن الاختلاف والصراع حول السلطة، سنحاول أن نتتبع ملامح تأثير العقلية القديمة “الطور القبلي” مع التجربة والطور الجديد لشكل “دولة الخلافة”، ونستهل بخطبة سعد بن عبادة، يروي ابن قتيبة عن حديث سعد “يا معشر الأنصار إنّ لكم سابقة في الدّين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب (……) فشدّوا أيديكم بهذا الأمر، فإنّكم أحقّ النّاس وأولاهم به” [١٣]، يوجه حديث سعد هنا إلى قبيلته من الأنصار ويُذكرهم بفضلهم في دعمهم للنبي وأهمية ذلك في هيمنة دعوة الإسلام عن قبائل العرب الذين رفضوا الدعوة منذ البداية حتى أنهم حاربوها.
وبعد حضور أبا بكر وعمر بن الخطاب تغير سير الأحداث، فقال أبو بكر “نحن قريش والأمة منا” [١٤] واقترح أحد الأنصار وهو الحباب بن المنذر “منا أمير ومنكم أمير” وذلك ما أثار رفض عمر قائلًا “هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد، إنّه والله لا يرضى العرب أن تؤمركم ونبيّها من غيركم، ولكنّ العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلاّ من كانت النّبوّة فيهم“[١٥]، ويتضح من حديث عمر أصالة النعرة القبلية الخاصة في الاختيار مسوغًا ذلك بكون النبي عربي قريشي، ولكن لم يكن الصراع متوقف بين قبائل قريش وقبائل الأنصار بل ظهرت ملامح الاختلاف داخل القبيلة العربية، وهم بنو هاشم ويذكر تغيب عليّ والعباس والزبير بن العوّام وفاطمة للاهتمام بعملية غُسل النبي وغيرهم مثل ابو ذر وسلمان الفارسي وأبيّ بن كعب، ويذكر أن رد علي على اختيار المبايعة، يقول: ” أنا عبد الله وأخو رسوله. فقيل له، بايع أبا بكر، فقال أنا أحقّ بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليه بالقرابة من النبيّ (صلى الله عليه وسلم) وتأخذونه منّا أهل البيت غصبًا؟ (……) [١٦] ونرى هنا أن عليًا يستخدم نفس محاججة أبا بكر وعمر للأنصار، وموقف عليّ تاريخيًا غامض الثبوت مع وجود مرويات عن مبايعته أو عن تأخر ذلك، وبدون حاجة إلى المزيد من المرويات فما كان لنا إلا أن ندلل على أهمية النظر إلى عنصر الحمية القبلية ومكونات تلك العقلية، فكان خطاب النسب والقبيلة ذو حاجة سياسية فالعُصبة ضرورة تقتضيها مساعي الطموح السياسي في هدف السيطرة ووجود روابط اجتماعية ونفسية شرط واجب التوافر، ويشير ابن خلدون لذلك قائلًا: “فلا بد في الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لأن كل عصبية منهم اذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالاذعان والاتباع” [١٧]
إذًاا فقد استتب الأمر لقريش أو بتعبير طه حسين “منذ ذلك الوقت نشأت في الإسلام أرستقراطية قوامها القرب من رسول الله؛ فأصبح الحكم إلى قريش وحدها ..” [١٨] وما يُكمل شكل الملامح للعامل القبلي في التكوين البنيوي للخلافة، هي التحديات الجديدة لتأسيس دولة الخلافة، فبعد مبايعة أبا بكر كخليفة للمسلمين بعد النبي، تأرجحت الوحدة وارتدت كثير من القبائل والتي كان يغلب عليها طابع الدين القبلي أي أن دين القبيلة يحدده شيوخها وكبارها، فعندما دخلوا في الإسلام تحول الجميع إليه ولذلك فرق القرآن بين الإيمان والإسلام من حيث الدرجة، ولذلك كانت الضرورة السياسية تلزم أبا بكر بفرض السيادة للحفاظ على بناء وحدة دولة النبي، فقاتلوا من تركوا الدين وادّعى النبوة كطي وأسد ومسيلمة، وقاتلوا من منع الزكاة ورفض بيعة أبي بكر من تميم وهوازن، وكانت ثاني الخطوات في ترسيخ دولة الخلافة هو صك الروابط العربية نحو هدف وحلم مشترك وهو التوسع العربي فكانت الانطلاقة للمحاربة في الخارج، وكانت تلك من الاستراتيجيات السياسية الناجحة في توطيد البنية الجديدة، ومن ناحية شكل الحكم فكان ذلك الشكل والطور الجديد هو تجربة عربية خالصة أقيمت على عنصر الأرستقراطية الدينية القرشية العربية، والتي يمتد أصلها للمؤسس الأول لقريش “قصي بن كلاب” إلى دولة النبي التي تلاءمت حينها جل الشروط الموضوعية اقتصادية وسياسية وثقافية لتكون دولة قريشية.
وإذ كان التأكيد على دور العامل القبلي في دوافع وعقلية الجيل الأول في تأسيس دولة الخلافة ليس من قبيل حصر دور الدين وإنما للنظر من خلال التركيب العضوي لعقل المؤسسين بالإضافة لما يقابله الباعث القبلي من التهميش الواضح في ثقافة العقل القبلي وكأن الإسلام كدين قضى على السياق التركيبي للمجتمع، وهذا ضرب من المستحيل فالإنسان لا يستطيع الانسلاخ عن بنيته العضوية وهويته الثقافية حتى مع أعظم التغيرات؛ بالإضافة إلى أن الدين هو ظاهرة اجتماع متفاعل ومؤسس على نفس التركيب الذي خرج من رحمه، حتى مع تأثيره الجدلي مع الواقع وتعديله له.
ولكن موضع الدين وتطوره في تلك الفترة كان قطبًا في ذاته أي أنه كان يُمثل غاية عند المؤسسين الأوائل، وهذا ما سنلحظه بعد ذلك في التمييز بين مفهوم فترة الخلافة الراشدة وبين خلافة الملك حيث سيختلف موضع الدين من الشكل السياسي للسلطة، ونلاحظ سمات تبلور قوة وشكيمة الدولة من خلال القراءة لبعض مظاهر تاريخ الصراع حول الخلافة وذلك في الجزء القادم من المقال..
(يتبع)
هوامش: [١] التخلف الاجتماعي(مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور )، ص:١٠٣/المركز الثقافي العربي.. د.مصطفي حجازي [٢] المصدر السابق :ص/١١٠:١١١ [٣] النُفاج: حالة من التضخم والمبالغة الذاتية بشكل يجعل المحيط يبدو منحسراً أمام الذات ويكون نوع الشعور بالعظمة هكذا مباشرة بدون جهد فعلى يدلل على ذلك، وهو نوع من رد الفعل التعويضي على مشاعر نقص ذاتية. [٤] السيرة النبوية لابن هشام ، الجزء (١) ص :٨٤ ، طبعة جديدة ومنقحة ، دار الفجر للتراث -[٥] الأفغاني، سعيد بن محمد، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، ص ٢٠٣. [٦] قريش من القبيلة الى الدولة المركزية ، ص: ٣٢١، خليل عبد الحكيم [٧] قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية ، ص: ١٨٧ ، خليل عبد الحكيم [٨] خليل عبد الكريم ، قريش من القبيلة إلى الدولة المركزيةً؛ ص: ٦٥ [٩] تاريخ الطبري ،ج٢ ص٣٢٨ [١٠] تاريخ دمشق لابن عساكر(باب ما جاء في اختصاص الشام وقصوره) [١١] في الشعر الجاهلي:ص:٤٧، طه حسين [١٢] المصدر السابق، ص:٥١ ، طه حسين [١٣] ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله، الإمامة والسياسة، دار الكتب العلميّة، ط2، 2006، ج 1، ص 9 [١٤] البلاذري ، انساب الاشراف [١٥]ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله، الإمامة والسياسة ، ص١٣ [١٦] المصدر السابق،ص١٥ (١٧) مقدمة بن خلدون : ص١٤٨ [١٨] الفتنة الكبرى ، جزء (١) ص: ٣٥ ، مكتبة الاسرة.. طه حسين
إعلان
