مِن دُروس الغربة
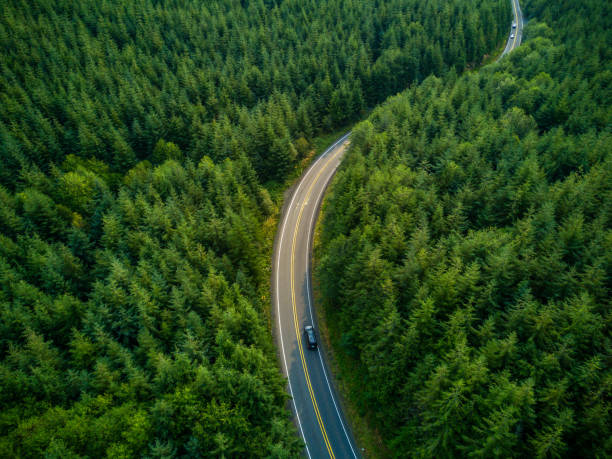
تركتُ مكتبي في ساعات الأصيل وبدأت بالسير مارًّا بأشجار الكستناء التي تغطي المنطقة المرتفعة وتقع عليها الجامعة التي أعمل بها. كنت أراقب أثناء سيري السناجب وهي تأكل ثمار هذه الأشجار الباسقة وتقفز بينها متجاهلةً وجودي بشكل تام. خرجتُ من بين الأشجار لأصل إلى الشارع العام المؤدّي إلى الحي الذي أسكن فيه، والذي ينحدر بشكلٍ قوي في البداية ومن ثم يستوي على مهل حتى يصل السهل الذي يقع عليه بيتي، كنت استأجرته قبل عدة أسابيع. بعد أن وصلت الشارع العام، امتدّ نظري في اتجاه الشمس داكنة الاحمرار وقد غابت معظمها غارقةً في مياه المحيط الهادئ، ترافقها كوكبة من الغيوم الصغيرة الحمراء كأنها فرقة من حرس الشرف التي جاءت لتودّع نهارًا آخر.
أكملت سيري نحو البيت ومن حولي هذا المشهد السحري الذي يليق بِساكني جبل الأوليمبوس، وأخذت أنزل نحو السهل رويدًا رويدًا والشمس أمامي تغيب ببطء، حتى اختفت تمامًا حين أصبح الطريق سهليّ، وحلّ محل المشهد السحري ظُلمة الليل التي نزلت بسوادها على البيوت المتواضعة التي كانت في طريقي، فتخضّبت بها لتحوّل ألوانها الجميلة إلى ظلالٍ رماديةٍ كئيبةٍ.
نقلني هذا التحول الذي جرى حولي من متعة الشعور الجميل الذي ابتدأت به سيري نحو البيت، إلى الإحساس بحصارٍ داخلي فرضته عليّ العتمة التي انسدلت من حيث لا أدري، وشعرت فجأةً بانقباضٍ شديدٍ في صدري وحلّ بي شعورًا قوي من الوحدة؛ فقد أنزلتني هذه الظلماء من علياء النشوة المسحورة الذي أضْفاها عليّ المنظر الخلاب إلى قسوة واقعي الذي صدمني لأول مرة منذ وصولي إلى هنا، فقد فهمت فجأةً وبكل إدراكي وحواسي أنّني هنا غريبٌ تمامًا ووحيدٌ كليًّا!
كان هذا في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1994، بعد حوالي شهر من وصولي إلى مدينة بيركلي في كاليفورنيا، حيث كنت قد سافرت إلى هناك مباشرةً بعد انتهائي من كتابة أطروحة الدكتوراه لأشرع في العمل كباحث في جامعتها المعروفة. كانت هذه المرة الأولى في حياتي التي أترك بها بلادي لأعيش في بلد غريب. وصلت إلى هناك وأنا متلهّف لبدء العمل على المشاريع العلميّة المختلفة التي سأنجزها هناك مع مضيفيّ الذين كانا من أهم العلماء في مجالي، والّذين كنت أحلم بالعمل معهما، لكنّي لم أفكر مسبقًا بحجم التغيير الكبير الذي سيطرأ على الجوانب الأخرى من حياتي، والذي تجلّى لي بكل حدّته في تلك اللحظة “الوجوديّة” التي داهمتني من دون ميعاد.
ما زلت أذكر تفاصيل تلك اللحظة ووقعها عليّ بوضوحٍ تام، فقد شعرت خلالها وكأنّني فقدت حواسي بشكلٍ كليّ، وانفصلت عمّا يدور حولي وترك عقلي وإدراكي جسدي. فأصبحت مثل الرَجُل العائم الذي تخيّله ابن سينا، معلّقًا في الفضاء بحيث لا تستطيع حواسه أن تشعر بأي جزءٍ من جسمه، ليتساءل عندها فيلسوفنا الكبير هل يعرف هذا الرجل المعلّق عن وجود ذاته؟ لكن لم يكن ما طرحته هذه اللحظة أمامي تساؤلًا عن الذات الفلسفية المجرّدة والعامّة التي قصدها ابن سينا بل عن الذات الخاصة، الشخصيِّة والعينيّة التي يتفرّد بها وجودي كشخص جاء في وقتٍ معين ومكانٍ محدد وفي سياق تاريخيّ واجتماعي خاص.
إعلان
حتى أوضّح أكثر خصوصية هذه الأزمة الوجوديّة التي اعترتني، سأستعين بِالفيلسوف الانجليزي جون لوك الذي استعمل الذاكرة كمعيار أساسي في عملية تشكل الهوية الشخصية. حيث ادّعى لوك أنّ ما يميز إنسانًا معينًا عن الآخر هو وعيه لحالته الحاضرة، وذاكرته التي تربط حالاته الماضية بها؛ أي أن الهويّة الشخصيّة للإنسان حسب جون لوك، هي استمرارية الذاكرة التي تربط ماضيه بحاضره والتي تعدّه للتعامل مع ما قد يأتي به المستقبل. طبعًا لم تأتِ هذه الأزمة نتيجة شرخ في استمرارية ذاكرتي لكنّها أتت نتيجة شرخ في استمرارية المحيط الاجتماعي والثقافي والسياسي، وبالتالي في السياق الذي تكونت به ذاتي الشخصية واكتسبت مضمونها، واعتادت التفاعل معه. كانت هذه اللحظة هي التي أدركت بها عمقَ الشرخ الكبير في سياق وجودي، ليس فقط من ناحية ذهنية وفكرية بل وهي الأهم من ناحية نفسية وعاطفية، وأدركت بها أنني أمام تحدٍ كبيرٍ جدًا، عليّ أن أتعامل معه ومع إسقاطاته، والذي أدّى على مدار سنوات إلى تغيير جذري في فهمي لذاتي وعلاقتي مع محيطي، وما زال يضع أمامي التحديات حتى يومي هذا.
عليّ التنويه في هذه المرحلة، أنّ هدفي من كتابة هذا المقال هو التحدث عن تجربتي الشخصية في الغربة، وما هي الأسئلة والتحديات التي وضَعَتَها أمامي، وكيف تعاملت معها. قد تكون هذه التجربة كونها شخصيّة غير مثيرة للاهتمام بالنسبة للقارئ، لكن الجدوى من عرضها استخلاص الخصائص العامّة التي قد تُلقي بعض الضوء على تجربة الاغتراب كحالة اجتماعية ونفسيّة كما عشتها، وإلى حدٍ كبير ما زلت أعيشها، وعمّا نتعلم منها بشكلٍ عام عن ذاتنا، ومحيطنا الاجتماعي وموقعنا فيه.
من الناصرة إلى بيركلي، كاليفورنيا:
إحدى الصفات المميزة للفلسطينيين هو ارتباطهم المحدّد بالمدينة أو القرية التي نشأوا بها، أو أتى آباؤهم أو أجدادهم منها حتى لو تركوها لسنواتٍ عديدة. وأنا كغيري من أبناء شعبي أرتبط ارتباطًا قويًّا بالمدينة التي وُلِدت وترعرعت بها “الناصرة“، حيث تمتد جذور عائلتَيّ والدي ووالدتي فيها إلى ما يقارب الثلاثة قرون، حتى أنّ اسم عائلتي أتى من اسم أحد أحيائها القديمة. وكبرت على قصص الناصرة وتراثها ونسيجها البشري الخاص. فإضافةً إلى مكانتها الدينية في المسيحيّة، هي البلدة التي أحبها ظاهر العمر، وترعرعت بها مي زيادة، وتعلّم في إحدى مدارسها ميخائيل نعيمة، وأنجبت الشاعر والقائد السياسي توفيق زياد، والكثيرين غيرهم من الشخصيات الفذّة والمميزة. فقد كان الجو السائد في الناصرة أكبر مدينة فلسطينية في الداخل وما زال جوّا عربيّا بامتياز، حيث لا يختلط أو يتعامل فيه سكانها مع المجتمع الإسرائيلي إلا من خلال العمل أو الدراسة الجامعية؛ أي أنّ التعامل مع المجتمع الاسرائيلي لدى أغلب مواطنيها لا يبدأ بشكلٍ حقيقي إلّا بعد إنهاء المرحلة الثانوية، أي بعد تبلور أهم ملامح هويتهم الشخصية.
إضافةً إلى ذلك، كانت الحقبة التي ترعرعت بها وتبلورت فيها شخصيّتي خاصةً في سبعينيات القرن الماضي حقبةً خاصةً ومليئةً بالأحداث في تاريخ المدينة، ميّزتها هبّة وطنية عميقة للأقلية الفلسطينيّة في الداخل، كان أوجّها في يوم الأرض. دفعتني هذه الأحداث والروح القومية التي رافقتها مثل الكثيرين من أبناء جيلي إلى النشاط الاجتماعي والسياسي وأنا في ريعان شبابي، ممّا عمّق انتمائي إلى مجتمعي وشعبي وارتباطي بهما.
تركت الناصرة لأوّل مرة عندما كنت ثمانية عشرة عامًا لأسكن في حيفا، ومن ثم القدس، حيث تواجدت المعاهد العليا التي تعلّمت بها. لكن على الرغم من التحديات التي واجهتها في مرحلة تعليمي، كالعيش لوحدي لأول مرة، أو اضطراري أن أتعلّم العبرية على مستوى عالٍ لأنها كانت لغة الدراسة في المعاهد العليا، أو التعامل لأول مرة بشكلٍ مكثّف مع المجتمع اليهودي، أو الوصول للاكتفاء الاقتصادي حتى أموّل تعليمي ومعيشتي بأسرع طريقة ممكنة (بدأت بتعليم الفيزياء في إحدى المدارس وأنا ما زلت في العشرين من عمري) وما إلى ذلك، إلّا أنّ الانتقال إلى حيفا مثلًا لم يُفْقِدني السّياق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي ترعرعت عليه، بل بالعكس فقد أدّى تفاعلي مع زملاء الدراسة الفلسطينيين والذين أتوا من شتّى القرى والمدن العربية إلى تعميق انتمائي إلى مجتمعي وشعبي، وتعزيز السياق التاريخي والثقافي لذاتي، وتوسيع “رقعته”، إن صح التعبير.
لكن تجربة الاغتراب إلى بلد أجنبي كان تجربة مختلفة تمامًا، إذ لم أكن مستعدًا للصعاب التي واجهتني بها، وكان عليّ الغوص عميقًا في داخلي لأجد القِوى التي مكنتني من التعامل معها، لكنّها أتاحت لي أيضًا فرصًا كثيرةً للتطوّر والنموّ الشخصي والفكري. كذلك الأمر علّمتني الكثير عن نفسي وعن علاقتي بالناس والمجتمع. فكم بالحري أن تجربتي مع الغربة امتدت على أكثر من عقدين من الزمن عشت خلالها في ثلاث دول مختلفة، بمفردي أولًا في أمريكا، ومن ثم مع زوجتي وابنتي في ألمانيا وهولندا.
المفارقة الكبيرة أن هذه الأزمة الوجوديّة اعترتني في لحظة كان عليّ أن أكون فخورًا بالإنجاز الشخصيّ الكبير الذي وصلته،
فأنا في النهاية، شخص وُلٍدَ لعائلة صغيرة ومتواضعة ماديًّا، لأمٍّ وأبٍ لم يتعدَّ تعليمهما المرحلة الإعدادية، وتربّى في حي صغير في مدينة لا يتعدّى سكانها في حينه أكثر من ستين ألف نسمة (عام 1982)، والتي على الرغم من مكانتها الدينية لدى المسيحيين وكونها عاصمة الجماهير الفلسطينية في الداخل، ألا إنّها لا تحمل أهمية دولية من نواحٍ سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو حتى تاريخية (باستثناء حدث تاريخي واحد حصل قبل أكثر من ألفي عام). بمعنى أن وصولي إلى أحد الصروح الفكرية المركزية والرائدة في زمننا في العالم، لأعمل مع أفضل العلماء في مجالي، هو إنجاز لا يُستهان به.
فيما يلي سأعرض باقتضاب بعض أهم الدروس التي تعلّمتها من تجربة الاغتراب الطويل الذي عشته، وبمفهوم معين ما زلت أعيشه. أقول “بعض الدروس” لسببين: الأوّل أنها كثيرة بحيث لا تتسع مساحة هذا المداخلة لعرضها كلها، لهذا حاولت التركيز على الدروس التي ارتأيت أنّها أهم وأعمق من غيرها. والسبب الثاني هو أنّ بعض هذه الدروس ولربما أهمّها لا أعي لها ولم أدركها بعد، بل تعلمتها بشكل غير واعٍ، انحفرت في كياني وشخصيتي من حيث لا أدري.
تحدّيات الهجرة:
لعلّ الشيء الأول الذي يجب أن يُقال عن الهجرة والاغتراب هو الشيء البديهي والواضح، وهو أن تجربة الغربة صعبة، حتى كدت أقول أنّها كثيرًا ما تكون قاسية جدًا. فمن الصعب مثلًا أن نتخيّل مدى قسوة التجربة التي يمر بها المهاجرون الذين أُجبِروا على ترك بلادهم خوفًا على حياتهم، مثل لاجئي النكبة الفلسطينية أو اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب في سوريا، أو أولئك الذين يرحلون من بلادهم في الشرق الأوسط وأفريقيا، جنوب ووسط أمريكا، إلى بلاد الغرب (عادةً بشكلٍ غير قانوني) طلبًا للعمل والعيش الكريم، ومن دون أن يعرفوا اللغة ولا أين سعملون، هذا إن كانوا سيجدون عمًلا أصلًا الخ… فهؤلاء وغيرهم من المهاجرين يعانون من مشاكل أوّلية وتحديات أساسية أصعب بكثير مما أتحدث عنه في هذا المقال.
ما أتحدث عنه هنا هي تجربة الاغتراب التي تنطبق عليها حالتي، والتي أتى فيها قرار الهجرة من اعتبارات مهنية صرفة، فأنا لم أُجبر على الهجرة نتيجة ملاحقة سياسية، أو لأني شعرت بخطر يهدد حياتي، أو لأني لم أستطع أن أجد عملًا، أو لم أجد مكاني في مجتمعي إلى ما ذلك. بل لقد رحلت إلى أمريكا لوحدي، من دون عائلة أقلق عليها، بعد أن أنهيت رسالة الدكتوراه وبشكلٍ قانوني للعمل في مكان عمل ممتاز ومرتّب مسبقًا. حيث ساعدتني الجامعة التي وظّفَتْني على ترتيب مكان سكني وتأمين صحي إلى آخره من احتياجات الحياة. كما أني لم أكن أحتاج تعلم اللغة الانجليزية التي كنت أعرفها بشكل ممتاز. بمعنى أنّ الكثير من الأمور المعيشية والإدارية كانت مهيأة لي مسبقًا، لهذا ما أتحدث عنه هنا هو لربما أسهل أنواع الهجرة. لكن على الرغم من السهولة النسبية لحالتي فهي تمكننا من تفحّص شعور الاغتراب من غير التعقيدات والصعوبات الجمّة التي يضيفها حاجز اللغة أو عدم توفر العمل، أو القلق من السجن (والطرد) في أية لحظة لعدم توفر وثائق الهجرة القانونية، أو المبيت على “بطن جائع”، أو القلق على عائلة، وما إلى ذلك من الصعاب التي تجعل حياة المرء قاسيةً جدًا حتى وإن لم يكن مهاجرًا، فكم بالحري إذا كان كذلك. أي أنني أتحدث هنا عن الاغتراب كحالة نفسية صرفة مجرّدة عن التعقيدات الأخرى التي تزيد من وطأتها قسوة.
إذن الدرس الأول ولربما المفروغ منه هو أنّ تجربة الاغتراب هي تجربة قاسية حتى في أفضل الظروف. فكما ذكرت سابقًا الصعوبة في الأساس تكمن في الشرخ الذي يحدث بين الذات والسياق الذي من خلاله تطورت. لهذا فالعملية الأساسية التي يمر بها المغترب بالذات في سنواته الأولى هي محاولة إيجاد سياق جديد، والتوفيق ولو جزئيّا بين ذاته وبين بيئته ومجتمعه الجديدَيْن؛ أي الوصول إلى السياق الملائم والواضح في علاقته مع هذا المجتمع.
خلال السنوات التي عشتها في الخارج كنت دائمًا أقسّم المهاجرين مثلي إلى ثلاث مجموعات كبيرة، وهو تقسيم مبني على ما لاحظته في تجربة اغترابي كشخصٍ عادي، غير خبير بهذه الأمور، أي أنّ هذا التقسيم على الأرجح غير دقيق أو كامل.
المجموعة الأولى: وهي مجموعة صغيرة نسبيًا، هم المهاجرين الذين نجحوا في التأقلم بشكلٍ تام مع مجتمعاتهم الجديدة، ويعبرون تغييرًا واضحًا في ذاتهم الشخصية، بحيث يعيدون تعريفها من منطلق السياق الجديد الذي يعيشونه، بحيث لا يبقى من سياقها الأصلي سوى الذكرى. وغالبًا ما يكون هؤلاء قد هاجروا في مرحلة مبكرة من حياتهم، وهذا عامل حاسم في نجاح التأقلم أو عدمه، أو تزوجوا من شريك/ة من أبناء وبنات المجتمع الجديد.
المجموعة الثانية: وهي كبيرة، تتكوّن من المغتربين الذين يجدون حلًّا وسطًا؛ بحيث ينسجون شبكة علاقات اجتماعية جديدة، لكنها مكّونة من مهاجرين مثلهم أتوا من نفس الخلفية الحضارية والثقافية وحتى في كثير من الأحيان من نفس المجتمع العيني والمدينة التي تركوها؛ لهذا نجدهم يعيشون في جاليات كبيرة ولأجيال عدة تحافظ إلى درجة كبيرة على السياق الذين أتوا منه، بحيث يتأقلمون رويدًا رويدًا مع مجتمعهم الجديد.
أمّا المجموعة الثالثة من المغتربين، وهي أيضًا كبيرة نسبيًا، فهم أولئك الذين لم ينجحوا في التغيّر وخلق سياق جديد يرضون عنه، ويجدون صعوبة شديدة في التأقلم أو حتى قبولهم لبيئتهم الجديدة. لهذا يبقى هؤلاء على الرغم من محاولاتهم الكثيرة من دون سياقٍ جديد، فيعيشون أغرابًا لا يشعرون بأيّ نوعٍ من الانتماء إلى البلاد التي هاجروا إليها.
قد يأخذ هذا الاغتراب شكلًا متطرفًا عند البعض وهم قلة، حيث يتحوّل شعور الاغتراب رويدًا رويدًا إلى غضب على واقعهم، يلومون فيه عادةً المجتمع الجديد الذي يعيشونه، بل ويتحوّل هذا الغضب أحيانًا إلى عِداء للمجتمع الجديد والدولة التي هاجروا إليها.
إضافةً إلى هذا أن بعض الدول الغربية خاصةً دول أوروبا، التي يهاجر إليها معظم المغتربين لا تعرف كيف تتعامل معهم. وتتوقع منهم أن يتبنوا أسلوب حياة مجتمعها بشكل شبه تلقائي، بغض النظر عن خلفياتهم الحضارية والثقافية والاجتماعية والدينية أو عن دوافعهم للهجرة. حتى أنه في كثير من الدول الأوروبية تحوّل موضوع المهاجرين والتعامل معهم إلى موضوع سياسي هام، تستعمله أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالذات لتجنيد الأصوات؛ إذ تحوّل الخوف من المهاجرين، وحتى كرههم في بعض الأوساط وتحميلهم مسؤولية مشاكل هذه المجتمعات، الذين هم براءةٌ منها، إلى سلاح سياسي فعّال يغذّي الحركات الفاشية الصاعدة في هذه الدول.
عناصر هويّتي:
يحتج الكاتب اللبناني أمين معلوف في رائعته “الهويات القاتلة” على أولئك الذين يسألونه عن هويته، قائلًا: “إذن أنا نصفي لبناني ونصفي فرنسي؟ أبدًا! فالهوية لا تتجزأ أبدًا، ولا تتوزع أنصافًا أو أثلاثًا أو مناطق منفصلة. أنا لا أمتلك هويات عدة، بل هوية واحدة مكونة من كل العناصر التي شكّلّتْها وفق “معايرة” خاصة تختلف تمامًا بين شخصٍ وآخر.” من الصعب ألا نتفق مع هذا التحليل المقنع الذي يرفض تجزئة ما لا يتجزأ.
لكي أوضح هذه النقطة، تحضرني قصة حدثت معي ومع عائلتي عندما انتقلنا من مدينة ميونيخ التي تقع في جنوب ألمانيا، بعد أن عشنا بها أكثر من خمس سنوات إلى مدينة خروننجن التي تقع في شمال هولندا. توقفنا على الطريق في مدينة كاسل، والتي تقع في وسط ألمانيا، لنقضي ليلتنا في فندق صغير كنت قد حجزت به غرفة عبر الإنترنت. عند وصولنا استقبلتنا موظفة الفندق والتي تحدثنا معها بطبيعة الحال بالإنجليزية، وهي لغة مهنتي، أستعملها بطلاقة أكثر حتى من اللغة العربية، لهذا لا بد أنها اعتقدت أننا إنجليز. لكن خلال التسجيل سمعتنا نتحدث أنا وزوجتي باللغة العربية التي كان من الواضح أنها تستطيع تمييزها. طلبت منا بعد ذلك جوازات سفرنا فأعطيناها، لدهشتها، جوازاتنا الإسرائيلية، فنحن أبناء من بقي من الفلسطينيين في أرضه بعد النكبة. وإن لم يكن هذا كافٍ لبلبلتها، فقد طلبت مني أن أكتب عنواني، فأعطيتها عنوان بيتنا الذي كنا قد استأجرناه قبل بضعة أسابيع في هولندا، فازدادت حيرة. وفي النهاية طلبت منها فتح باب موقف السيارات التابع للفندق لأضع سيارتي فيه، فرأيت فمها يفتح من الدهشة عندما رأت سيارتي التي تحمل لوحة ترخيص ألمانية تبدأ بالحرف M أي من مدينة ميونيخ. لربما كان من حسن حظ هذه المرأة أنها لم تسأل أيضًا عن خلفيتنا الدينية أو السياسية أو المهنية وما إلى ذلك، فأنا وزوجتي لا نلائم أي تصنيف مسبق في أي من هذه الأمور.
ما بلبل هذه المرأة هو أنّها لم تجد فينا أناسًا يتلاءمون مع تصنيفها المسبق للهويات، فهي لم تعرف هل نحن عرب أم إسرائيليون أم إنجليز والخ، وهذا ما لم تكن مستعدةً له، فنحن عادةً نأخذ عنصرًا معينا من هوية الفرد و “نجعله” كل هويته.
الأسوأ من ذلك هو أننا نقوم بمثل هذه التصنيفات بأنفسنا، بحيث نتجاهل العناصر المختلفة التي تجمعت لتكوّن شخصيتنا وهويتنا، ونختزلها إلى عنصر أو عنصرين منها.
لكن ما علاقة هذا بموضوع الغربة؟ الكثير. وذلك أنّه على الرغم من أنني أتفق مع الكاتب أمين معلوف أن الهوية لا تتجزأ، ألا أنّه يمكن أن نفحص ما هي العناصر التي ساهمت في تكوين هذه الهوية، وما هو المهم والجوهري منها وما هو الجانبي. في الحقيقة، إحدى التجارب الأكثر عمقًا التي مررت بها خلال اغترابي، وبالذات في السنوات الأولى منه، هو هذا التفحّص غير الواعي في معظمه لعناصر هويتي. فعندما تكون غريبًا تكون حرًا من التقييدات التي تفرضها توقعات عائلتك، أصدقائك، أبناء مدينتك، مجموعتك الدينية، مجتمعك، أو دولتك وما إلى ذلك. لهذا تستطيع أن تتفحّص ما هي العناصر الأوليّة التي ساهمت في تكوّن جوهر ذاتك، وما هي العناصر غير الجوهريّة والتي كثيرًا ما تفرض علينا من قبل بيئتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أي أن الاغتراب يتحدّى فكرتك عن هويتك ويضطرك أن تتفحّص مُركباتِها الأساسيّة والضروريّة.
أودّ التشديد هنا على أن أغلب هذا التفحص يحدث من خلال سيرورة الحياة اليومية ومن غير أن نكون واعين له. على سبيل المثال، كنت أعتقد دائمًا أنني أعامل البشر كبشر بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والجندرية. كان هذا وما زال من أهم مناحي إدراكي لذاتي. لكن لم يكن من الواضح مسبقًا كيف سأتصرف في مجتمع مثل مجتمع سان فرانسيسكو (المدينة الكبيرة القريبة من بيركلي) المليء بالسود والصينيين واليابانيين والمثليين وما إلى ذلك من نسيج بشري غني ومتنوع. لحسن حظي وجدت أن هذا الجانب من قناعتي الذاتية ومن رؤيتي لنفسي هو جانب عميق وحقيقي. بل وقد عمقت هذه التجربة من هذا الجانب في شخصيتي. كل هذا من غير أن أكون واعيًا لذلك حين حدوثه، بل فهمته بعد سنوات من حياة الاغتراب.
الجانب الديني:
مثالٌ آخر هو الجانب الديني من هوية المغترب. ففي كثيرٍ من الأحيان يصبح الجانب الدينيّ هو الجانب الهام الذي يحافظ على اتصالٍ معيّن ما بين السياق الذي عاشه المهاجر قبل هجرته وواقعه الحالي في الغربة. لهذا نجد أنّ الكثير من المغتربين يتمسكون بدينهم أكثر في دول الغربة، نسبةً لما كان عليه قبل الاغتراب، فيصبح الجامع أو الكنيسة (بالنسبة لمهاجري الشرق الأوسط) هو المكان الرئيسي لنشاطهم الاجتماعي ويمنحهم السياق الذي افتقدوه نتيجة هجرتهم. أحد أقاربي على سبيل المثال، كان ماركسيًّا وفعّالًا جدًّا في الحزب الشيوعي، لكنّه هاجر إلى كندا واتضح له سريعًا أن الجانب الديني مُهِمًّا له فأصبح فعّالًا جدًّا في خدمة الكنيسة الأرثوذكسية في بلدته، والتي كوّنت بؤرة الفعالية الاجتماعية للجالية العربية المسيحية الشرق أوسطية هناك. أي أن هذا الرجل تحوّل دون وعيه لذلك من ماركسي إلى متدين.
كان هذا امتحانًا آخر لما كنت أظنه أساسيًّا عندي. فقد أدركت منذ طفولتي التناقضات العميقة التي تحملها الأديان، كلٌّ على حدة ومقارنةً مع بعضها البعض. لهذا لا يلعب الدين دورًا في حياتي وتفكيري، باستثناء الجانب الاحتفالي منه الذي نستعمله حجة لكي نجتمع مع أبناء عائلتنا وأحبتنا. هنا أيضًا لم توضِّح لي تجربة الغربة شيئِا جديدًا عن نفسي سوى أنها أكدت لي وعمّقت عندي إدراكي وقناعتي أنّ الدين هو شيءٌ جانبي بالنسبة لي، فهو لا يعرّفني بل ولا أريد أن يعرفّني.
ما يميز مجتمعات دول الهجرة مثل الولايات المتحدة هو تعددية المشهد البشري فيها، إضافةً إلى هذا فقد كانت جامعة بيركلي تعجّ بالباحثين الذين أتوا من شتّى أنحاء العالم. لهذا فقد كان تفاعلي اليومي مع خليط غنيّ من شتّى الأعراق والأديان والثقافات والتقاليد والعادات، والظروف السياسية، الخ.. كان من الواضح أنّ كلًّا منّا يحمل جعبة ثقافيّة واجتماعيّة ودينيّة وسياسيّة خاصّة به، ولكن في نفس الوقت لا يوجد فرق بين فرد وآخر، إلّا فيما يتعلق بإنجازاتنا المهنية والشخصية. وهنا تأتي إحدى إشكاليات الدين، إذ أنّه الوحيد من بين حمولتنا الشخصية الذي يحمل قيمة مطلقة، بمعنى أن أغلب الأديان تدّعي بشكل واضح أنّها الطريق الوحيد الصحيح، مثلها مثل كل المعتقدات التي تدّعي أنها تحمل الحقيقة المطلقة الوحيدة. وهذه إشكالية عميقة، إذ كيف لي أن أدّعي أني مساوٍ لأبناء الشعوب والثقافات الأخرى من زملائي وأصدقائي حين أؤمن أن ديني هو الدين الأحقّ والأصحّ، وأن أديانهم تأخذهم إلى ضلال ليس منه رجعه. في الحقيقة كانت إشكالية الأديان هذه واضحة لي منذ صغري، لكنّها اكتسبت بُعدًا حادًّا عندما اختلطت بأناس لا ينتمون تقليديًّا إلى الديانات السماوية الثلاثة، المتشابهة إلى حدٍ بعيد، وهذا عمّق عندي القناعة، أن الأديان ما هي إلا عادات وقصص اخترعها البشر لكي يفسّروا واقعهم، لكن لا يحمل أيٌّ منها في الواقع أية قيمة خاصة، أو يملك أية حقيقة مطلقة، تميزه عن باقي أديان البشر الأخرى. ففي اللحظة التي يؤمن بها المرء أن دينه هو الدين الأحقّ والأصحّ –الذي اعتنقه لا لرؤية مميزة بل لمجرد أنه ولد لعائلة تؤمن بنفس الدين– فهو في الواقع يؤمن أنه أفضل ممن لا يؤمن بنفس هذا الدين. وهذا ما لا أستطيع قبوله وأرفضه بكل جوارحي. لاحظ\ي هنا أنني أتطرق لمن يؤمن بما تقوله الأديان بشكلٍ حرفي، ولا أتطرق لمن يؤمن إيمانًا شخصيًّا بالله ولا يعتقد أنّ إيمانه يعطيه الحق بأن يدعي أن هذا الإيمان هو الإيمان الوحيد الممكن. لكن هذا كما ذكرت ليس ما تدعيه الغالبية الساحقة من الأديان المنظمة.
ربما كانت إحدى أجمل تجاربي في السنوات الأولى من اغترابي هي زيارتي الأولى لليابان، والتي تركت فيّ أثرًا كبيرًا. فقد سافرت لأشارك في مؤتمر علميّ في طوكيو دعاني إليه صديقي الياباني “ناوشي سوجياما” الذي تعرفت عليه خلال السنة الأولى في بيركلي وأصبح من أعز الأصدقاء. بعد انتهاء المؤتمر بقيت لعدة أيام في بيت والِدَيّ ناوشي، والذي يقع في ضواحي مدينة طوكيو. كان والد ناوشي أستاذًا جامعيًّا متخصصًا في الأدب الألماني، وقد اعتنق الديانة المسيحية، لهذا لم تكن تسعه الفرحة عندما استقبلني في بيته، ليس فقط لأني صديق ابنه، بل أيضا لأني ولدت وتربيت في مدينة الناصرة. أما والدة ناوشي والتي لم تكن تقِلّ لطفا عن زوجها، فكانت تدين بديانة آبائها، الشينتو (وهي ديانة تجمع بين الديانة اليابانية القديمة، التي تعرف باسم عبادة كامي، والبوذية)، أما ابنهما ناوشي فقد كان ملحدًا، وأخته تميل إلى البوذية العادية، أما زوجته فكانت تصلي مع الجميع من غير اتخاذ موقف إلى هنا أو هناك. المثير في الأمر أنهم كانوا جميعًا يعيشون تحت سقفٍ واحد ومن غير أن يحكم أحدهم على الآخر أو أن يطالبه بتغيير دينه، فقد كان واضحًا أنّه بيتًا يملأه الفرح والتناغم.
الفلسطينيّ مقابل الإسرائيليّ:
عندما عشت في ميونيخ كان هناك عددًا من الزملاء الإيطاليين الذين أتوا ليعملوا في مراكز علم الفلك المتعددة في ميونيخ، فكنت دائمًا أتعجّب لِمَ يقضون جلّ وقتهم مع بعضهم البعض، ويتصرفون كأنهم أعز الأصدقاء، وهم بالكاد يعرفون أحدهم الآخر؟ عليّ أن أوضّح أنّ هذا لم يكن عاديًّا، إذ كان الباحثون الأجانب يقضون أوقات فراغهم مع بعضهم البعض بغض النظر عن خلفياتهم القومية. أذكر أنّني في مرة سألت صديقًا من أصدقائي الطليان عن هذا، متوقعًا أن يجيبني بأنهم يرتاحون مع بعضهم مثل باقي الأجانب، إلا أنه أجابني إجابة فاجأتني، فقال لي أنّه قبل أن يترك إيطاليا كان يرى الفروق بين أبناء المنطقة التي رَبَى فيها منطقة ميلانو وأبناء المناطق الأخرى من إيطاليا، لكنّه أدرك فقط عندما عاش خارج بلاده، حقيقة أنّهم جميعًا أبناء الشعب ذاته وأنّ الشبه بين أبناء المناطق المختلفة في إيطاليا أكبر بكثير من الفروق بينهم.
هذه الملاحظة نبهتني إلى ظاهرة مشابهة بين أبناء مجتمعاتنا الذين هاجروا إلى الغرب؛ فعلى سبيل المثال، يعاني مجتمعنا الفلسطيني في وقتنا الحاضر من التشديد على التصنيف الطائفي حيث إنّ كثيرًا منّا يرون في أنفسهم أنّهم في الأصل مسلمين أو مسيحيين أو دروزًا. لكن عندما يعيش هؤلاء حالة اغتراب، نراهم يدركون أن أقرب الناس إليهم في الخارج هم أبناء شعبهم، وبالذات أبناء نفس المدينة أو القرية التي خرجوا منها، بغض النظر عن دين كلّ منهم، إذ يكتشفون أنه باستثناء الدين ليس لهم أي شيء مشترك تقريبًا مع المسلم الذي أتى من الباكستان أو المسيحي الهولندي، أي أننا ولسخريّة القدر نكتشف عمق هويتنا الثقافية والقومية فقط عندما نترك المكان الذي زوّدنا بهذه الخلفية.
لعلّ أبرز مظاهر التفحص اللاواعي لعناصر شخصيتيّ هو تعاملي مع العنصر الإسرائيليّ من هويتي. وهنا عليّ أن أتوقف لأشرح قليلًا تعقيدات واقع فلسطينيي الداخل لمن لا يعرف هذا الواقع. لعلّه من الصعب على من لم يعِش تجربة فلسطينيي الداخل أن يفهم عمق المأساة التي حلّت بهم منذ قيام اسرائيل؛ فقد دَمّرت النكبة أغلب المجتمع الفلسطيني وجَرّدته من الوطن والأرض والمدينة والقرية، وبالتالي من السياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي لوجوده، فكان على من بقي من هذا الشعب أن ينهض بمجتمعه ويلملم ما تبقى منه من أشلاء ليكوّنه من جديد. كل ذلك في ظل دولة غريبة عنهم تمامًا ومعادية لهم حتى الصميم، قامت على أرضهم المسلوبة وعلى أشلاء شعبهم. هذا ما يسميه فلسطينيو الداخل بمعركة البقاء، وهي معركة مع الدولة تهدف للحفاظ على وجودنا كفلسطينيين على الرغم من جهود الدولة لمحو هويتنا، ولكنّها أيضًا معركة داخلية تهدف إلى المحافظة على هويتنا الفلسطينية وسياقها التاريخي والثقافي الذي يميزنا من جيلٍ إلى جيل.
نتيجةً لهذا الواقع، يعيش الفلسطيني في الداخل في تناقضاتٍ كبيرة تتمحور حول إشكاليّة التوفيق بين انتمائه القوميّ والتاريخيّ والدينيّ والاثني من جهة، وكونه مواطنًا في دولة تزوّده بإطارٍ سياسيّ واقتصاديّ ومدنيّ. تتراوح طرق التعامل مع هذا الواقع بين من يتمسك بالهوية الفلسطينية ويرفض الجانب السياسي والمدني لواقعه، وبين من يعطي الجانب المدني والاقتصادي، وحتى السياسي الذي توفره إسرائيل أهميةً أكبر بكثير من الجانب القومي والتاريخي. يحاول أغلبية الناس في الحقيقة التوفيق بين النقيضين عن طريق فصل الهوية المدنيّة عن الهوية القوميّة، خاصةً أن الحل المطروح دوليًّا لعقود طويلة هو حل الدولتين، الذي يُبقي فلسطينيي الداخل في إطار دولة إسرائيل. وكما ذكرت توظّف إسرائيل جهودًا كبيرة على جميع الأصعدة لمحو الهوية الفلسطينيّة لأبناء هذه الأقلية وجعلهم يتقبلون وجودهم كسكان عديمي التاريخ والقومية المحددة، وأنّ موقعهم كـ “عرب إسرائيل” أدنى من موقع اليهودي في هذه الدولة وأنّ هذا هو الترتيب الطبيعي للأمور.
هناك جانب آخر من هذه الوضعية العبثية، يتجلّى بشكلٍ واضح في تجربتي الشخصية وفي تجربة الكثيرين من أصحاب المهن الأكاديمية (مثل العاملين في المهن الطبية أو علوم الحاسوب أو الجامعات، وما إلى ذلك)، ألا وهو التعامل اليوميّ مع زملاء يهود يربطك بهم العمل المشترك اليومي، والذي من خلاله تتطور علاقات زمالة واحترام، كما هو الحال في كل مكان في العالم. ففي حالتي مثلًا، على الرغم من انتمائي القومي الواضح ونشاطي الطلابي السياسي في الحركة الطلابية الفلسطينية في الداخل في حينه ألا أنني في مرحلة اللقب الأول طوّرت علاقات معينة مع زملاء الدراسة من الطلاب اليهود وتتلمذت كباقي الطلاب على يد محاضرين يهود. وازداد هذا النوع من العلاقات زخمًا خلال مرحلة الدكتوراه، حيث أصبحت مجموعة الأشخاص التي أراها يوميًا وأتفاعل معها هي مجموعة أعضاء فريق البحث الذي كنت أعمل معهم، والأغلبية منهم يهود. وهنا يجب أن أوضح أنّ هذه العلاقات تنشأ على أسس مهنية، لهذا هي في جوهرها علاقات بين أنداد متساوين. حتى في كثير من الأحيان كانوا يعاملوني على أنّي متقدم أكثر منهم نتيجة نجاحاتي البحثية. بالطبع هذه العلاقات ليست علاقات صداقة عميقة، وذلك لأنّنا كنا نتجنب الحديث في السياسة قدر الإمكان؛ لأن لكلا الطرفين بالعموم آراء شبه متناقضة عن الواقع السياسي الذي نعيشه.
إذن وباختصار عندما أنهيت رسالة الدكتوراه ووصلت إلى كاليفورنيا كنت على قناعةٍ تامة أن أحد عناصر هويتي هو الجانب الإسرائيلي منها.
أتت تجربة الاغتراب لتعاين أيضًا هذا الجانب من ذاتي وتضعني أمام مرآة الحقيقة، كما فعلت في كل الجوانب الأخرى من شخصيتي. وهنا فاجأتني هذه التجربة بشكلٍ كبير، إذ إنني اكتشفت، وخلال فترة قصيرة أنّ هذا الجانب هو في الحقيقة جانب ثانويّ جدًا، كان هذا الاكتشاف من أهم ما تعلمته عن نفسي وكامتدادٍ له عن مجتمعي. فلم تأخذ الغربة إلا وقتًا قصيرًا لتمحو ثمار المجهود الهائل الذي تبذله إسرائيل في طمس فلسطينيتنا. ليس هذا فقط، بل هي أيضًا تمحو آثار المجهود الكبير الذي نوظّفه أنفسنا في التعامل مع التناقض الصارخ بين فلسطينيتنا وإسرائيليتنا، أو على الأقل التخفيف من حدته. بكلمات أخرى سرعان ما اكتشفت خلال الغربة أن محاولتي التوفيق ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي من هويتي التي يمر بها عمومًا فلسطينيو الداخل كأفراد ومجتمع هي أشبه بمحاولة تربيع الدائرة.
كما ذكرت عدة مرات حتى الآن، أتت معاينة عناصر ذاتي وشخصيتي بشكل لا واعٍ وغير مقصود؛ فهي وليدة ظروف الاغتراب التي جعلتني أسأل مثل هذه الأسئلة من حيث لا أدري. وقد غيّرت هذه التجربة من فهمي لنفسي، وجعلتني أعيد تقييمي للكثير من الأمور، عليّ أن أشدد هنا. إنّ ما أتحدث عنه هو ليس أنني اكتشفت خلال هذه التجربة الجانب الفلسطيني مني، فقد كان هذا دائمًا جزءًا من كياني وإدراكي السياسي، والتاريخي لمجتمعي وما حلّ به، بل ما تعلمته هو أنّه يجب عليّ أن أتوقف عن اعتبار الجانب الإسرائيلي جانبًا مهمًا مني، وعن محاولة توفيقه مع العناصر الأخرى من فهمي لذاتي. هذا التغير الذي يبدو بسيطًا هو في الحقيقة جوهريُ جدًا وبعيد المدى، غيّر قراءتي لواقعنا السياسيّ والاجتماعي والثقافي.
بعد هذه التجربة، بدأتُ أتنبّه إلى أنني لست الوحيد الذي وصل إلى هذا الادراك، بل أنّ هذا ما وصل اليه الكثير من المهاجرين من أبناء الأقلية الفلسطينية في الداخل، حتى أولئك منهم الذين كانوا يعتبرون إسرائيليّتهم أهم بكثير من فلسطينيّتهم، سواء كانوا مدركين لذلك أم لا فتراهم كما ذكرت ينسجون علاقات مع مهاجرين فلسطينيين وعرب إجمالًا خاصةً مع مهاجرين من نفس المدينة أو القرية التي تركوها وراءهم. ويختفي الجانب الإسرائيلي من هويتهم بسرعة نسبية، وهذا ينطبق حتى على المهاجرين الذين يعملون مع إسرائيليين في الخارج بكثرة، مثل مهندسي الكهرباء والحاسوب الذين يعملون في شركات الـ Hi-Tech في وادي السيليكون في كاليفورنيا والذين كنت أعرف الكثيرين منهم. بالطبع هناك الكثيرين ممن وصلوا إلى هذا الاستنتاج من غير أن يتركوا البلاد، بل حسموا هذا الصراع من غير الخوض في تجربة الاغتراب الفعلي، لكنهم على الأغلب مرّوا بتجربة اغتراب مجازي.
من الطريف في الأمر أنّه حين كنت أكتب هذا النص في آب 2021، وقع حريقٌ في جبال القدس دمّر جزءًا من غابات السرو (ذو الجذور غير العميقة) التي زرعتها الحركة الصهيونية في أواسط القرن الماضي، وعرّت النار المستعرة الجبال في جنوبي وغربي القدس من هذه الأشجار. كشفت هذه الحرائق أنّ غابات السرو خبأت من تحتها عددًا من آثار القرى الفلسطينية التي هُدِّمَت وقت النكبة، لتكشف من تحتها الرباعات الزراعية الجبلية التي بناها الفلاحون الفلسطينيون خلال مئات السنين. هكذا كانت الغربة بالنسبة لهذا الجانب من ذاتي؛ فقد عرّتها من قشورها السطحية وكشفت حقيقتها العميقة أمام عينيّ، فأنا فلسطينيّ عربيّ بكل جوارحي وما إسرائيليّتي إلا قشرةً رقيقةً لا تصمد أمام تجارب الحياة وعواصفها.
إعلان
