أزمة تعلم الفلسفة
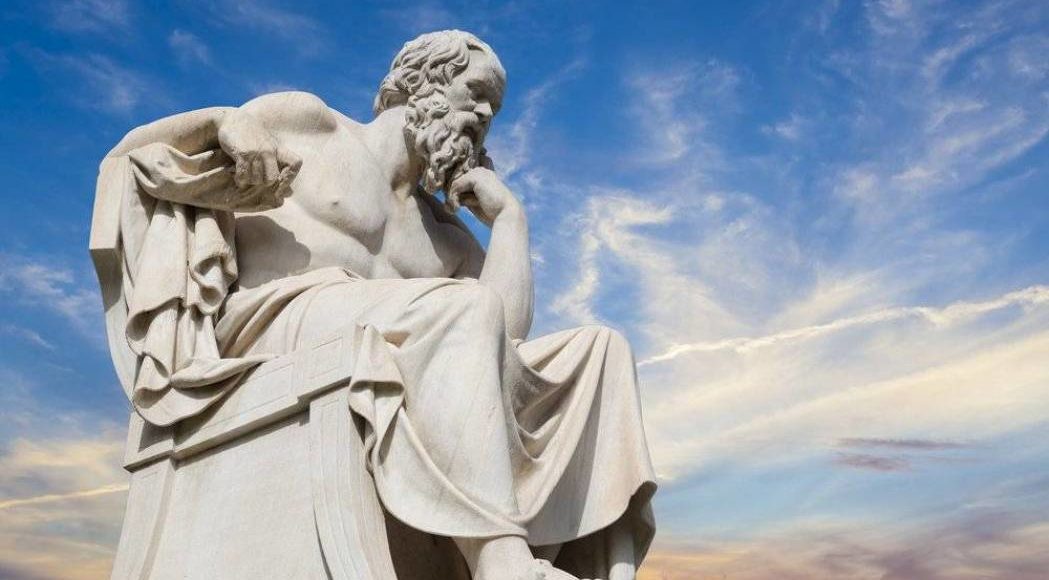
التعليم النظامي في مصر يتم عبر مرحلتين متتاليتين، تختلف كل مرحلة في هيكلها وأهدافها عن الأخرى. المرحلة الأولى: وهي مرحلة التعليم قبل الجامعي، وينقسم إلى أساسي (ابتدائي وإعدادي)، وثانوي. والتعليم في هذه المرحلة إجباري له مجموعة أهداف، منها: إكساب الطالب المهارات الأساسية اللازمة لبناء معارفه القادمة، والقدرة على مواجهة أو التعامل مع مشكلات العصر الحديث.
والمدرس هو من يقوم بهذه المهام لكنه يعاني من تدهورات كثيرة تتمثل في:
–طرق التدريس؛ حيث تقوم على مبدأي الحفظ والتلقين، وإهمال تام للعقل النقدي والإبداعي.
–المناهج؛ فالمواضيع الدراسية قديمة ولا تواكب تطورات العصر الحديث ولا التطورات العلمية.
–المعايير التي على أساسها يتم اختيار المدرس، فلا يوجد معيار لاختياره سوى الدرجة الدراسية الحاصل عليها في نظام قاتل لكل حس إبداعي وقائم على التلقين -كما سبق وأوضحنا-.
وإهمال معايير مهمة كالاختبارات النفسية التي تؤهله لممارسة تلك المهنة.
وغيرها وغيرها من الأسباب التي لا يتسع المقام للحديث عنها بالتفصيل ومحاولة لإيجاد الحلول. والتي جعلت من ترتيبه الأخير في التصنيف العالمي لمستوى التعليم.
والمرحلة الثانية من مراحل التعليم النظامي هي المرحلة الجامعية “الأكاديمية”، ويلتحق بها الطالب بعد أن يكون قد اكتسب المهارات الاساسية في التعامل مع المجتمع والحياة، وتعلَّم أساسيات التربية وقواعدها وفق مناهج ترسمها وتضعها الدولة.
والنظام الأكاديمي هو تعليم اختياري بعد اكتمال المعارف الأساسية لدى الطالب، وسمته الرئيسية هي “البحث” القائم على النقد والموضوعية. ومن شروط تلك المرحلة أيضًا: الشكوكية، والمراجعة الدائمة، والالتزام بمعايير اصطلاحية في الوسط العلمي المتخصص؛ حيث تمثل تلك المعايير شكلًا من أشكال الضبط المنطقي في كل وسط، ففي كل الميادين العلمية والثقافية مجموعة من الألفاظ بدلالات خاصة تكسبه الدقة في النتائج.
هل يتم الالتزام بتلك المعايير (البحث، الشكوكية،… إلخ)؟ أم أنها لوائح يواريها التراب، كما حال كثير من اللوائح والقواعد التي تنظم حركة السير داخل المجتمع من مؤسسات مجتمعية وعلمية؟
الإجابة تكاد تكون معروفة للجميع -رغم كونها صادمة-. وهي أن التعليم الأكاديمي في مصر أبعد ما يكون عن الروح الأكاديمية، فهو نظام قديم للغاية، توقف العالم الحديث عن استخدامه منذ القرن التاسع عشر، لا يواكب تطورات القرن الواحد والعشرين، بل ويعاني من ذات المشكلات في المرحلة الأولى “قبل الجامعية” وأكثر. زد عليهم إعطاء سلطة مطلقة لأساتذة الجامعات للتحكم بشكل مباشر وسلطوي في الطلبة، ووضع مستقبلهم في قبضة يديهم.
إعلان
وهناك وسائل ساعدتهم في تسلطهم، ومنها:
غياب اللوائح والقوانين التي تحكم وتنظم العلاقة بين الطالب والأستاذ، والتي تتسم هي الأخرى بالنظام الأبوي البحت المكتسب من هيكل الدولة وسياستها. فتقوم الدولة بتنفيذ سلطتها من خلال المدرسة والجامعة، فتعمل على زرع أيديولوجيتها “الدينية والسياسية”، وذلك من أجل إحكام سيطرتها على الكتل البشرية، وزرع فيهم ما تشاء من أفكارها الخاصة المشوّهة إلى أن يصبحوا مسوخًا معدومي الهوية، لا تتسم بحس نقدي أو إبداعي. فالإبداع لا ينمو سوى داخل مجتمع حر، وبيئة صالحة لممارسة التفكير.
أيضًا غياب اللوائح التي تنظم سير العمل بين الأكاديميين أنفسهم، وغياب مبدأ الديمقراطية الأكاديمية (ونعني بها أن كلهم يمثلون سلطة متساوية في المجتمع العلمي، ذلك بالنسبة إلى الإنتاج العلمي والغلبة لصاحب الإنتاج الأفضل والأكثر).
أما بالنسبة للشكل الإداري فهو خاضع للبلد الحاضنة للجامعة. وللحد من فرض الدولة سيطرتها على المجتمع الأكاديمي، فمن الطبيعي أن يكون هناك قانون واضح ومحدد المهام ولوائح من وضع الأكاديميين، بناءً على المصلحة العامة ولتحقيق العدل بينهم بعيدًا عن تدخل الدولة بأيديولوجيتها الدينية والسياسية، وفرض سيطرتها في محاولة لقمع كل مخالف لها في الرأي، كالإجراءات التعسفية التي تتم ضد بعض الأساتذة حين تبنوا منهجًا مغايرًا لسياسية الدولة أو أفكارًا مغايرة للعقل الشعبوي حتى وإن كانت في حياتهم الخاصة بعيدًا عن الحياة الأكاديمية
ونموذج الإجراء الذي تم اتخاذه ضد الأستاذة منى البرنس من إيقاف عن العمل وتحويل للتحقيق، لكونها فقط مارست جزءًا من حريتها! وفي المقابل عشرات الآلاف من التكفيريين يحتفظون بوظائفهم رغم إصدار فتاوى ضد كل مخالف لهم في الرأي يتم تكفيرهم بها ولا يتعرض لهم أحد! ولا يعلن أحد رفضه لما يحدث، بل يتم تكريمهم ويعتلون المناصب الأكاديمية طالما ينفذون سياسات الدولة.
فكما ذكرت الدولة تمارس سلطويتها من خلال إحكام يدها على المجتمع الأكاديمي، حيث يضم الفئة الأكبر من المجتمع وهي فئة الشباب فتعمل على تدجينهم بأفكارها، فذلك إن دل يدل على وجود خلل في المعايير واللوائح في محاولة من الدولة لقتل كل صوت مختلف.
وللخروج من قبضة الدولة علينا الاهتمام بالتوعية الفكرية، وذلك من خلال الاهتمام بالدراسات الإنسانية -المهملة تمامًا- فليس بالعلم وحده تبنى الأمم. فمقدار ما تخصصه الدولة سنويًا للبحث العلمي مليارات ونصيب العلوم الإنسانيّة من تلك الميزانية ضئيل للغاية، فلا تقدم بلا فكر ولا فكر بدون فلسفة. ولما كان الفكر غير إلزامي كان من المتوقع أن تخرج الفلسفة عن تلك القبضة المحكمة على النظام التعليمي.
قبل دراسة أي شيء أولًا لا بد من معرفة نبذة مختصرة عنه. فتعريف أي شيء معناه تحديد العلاقة بين بعض الرموز، وهي عادة ألفاظ مكتوبة أو متلفظ بها وبين مدلولها، أو شرح معنى لفظ من الألفاظ.
لذلك يجب ان نبدأ بالبحث في تعريف الفلسفة بالإجابة عن سؤال: ما هو معنى كلمة فلسفة؟
الفلسفة لون أصيل من الفكر، والعمل وفق التعاليم الفلسفية قائم على البحث وتنمية الحس النقدي، فمن العسير حصر تعريف واحد للفلسفة يمكننا استخدامه عبر العصور! ولكن هناك بعض التعريفات التي سلم بصحتها الجمهور الأعظم، ومنها:
بشكل مبدئي إذا قلنا إن الفلسفة بحث عقلي حر غايته في ذاته لا يهدف في أي غاية أخرى سوى اللذة العقلية، فهنا يكون اليونانيون أول المتفلسفين. أمّا إذا نظرنا إليها على أنها بحث عقلي يهدف إلى فهم ومعرفة كلية فنحن بذلك نعني أن الإنسان تفلسف منذ أن وعى وجوده.
1) يقول سقراط إن الفلسفة هي محبة الحكمة؛ أي السعي وراء المعرفة رغبة منه في الوصول لها رغم معرفته من صعوبة وجود معرفة يقينيه. ولكن البعض يرفض هذا التعريف بوصفه مبهمًا ومضللًا لمعنى الفلسفة؛ لأن الحكمة تصبح مصطلحًا مبهمًا كما الفلسفة فينتج سؤال آخره: ما هي الحكمة؟ يمكن أن تكمن الحكمة في ثلاثة جوانب:
-الحكمة في السلوك بمعنى التدبر والتعقل.
-الحكمة في مواجهة تصاريف القدر.
-الحكمة في السلوك وفق المعرفة.
2) أما أفلاطون وهو تلميذ سقراط النجيب حيث وصلتنا أفكار سقراط من خلال محاورات أفلاطون، كان ينظر للفلسفة من جهة أخرى ألا وهو موضوعها، والعناصر الذي تتألف منها هي كسب وتحصيل للمعرفة. الكاتب الروماني شيشرون المولد عام 106 ق.م يخاطب الفلسفة قائلًا:
أيتها الفلسفة، أنت المديرة لحياتنا، أنت صديق الفضيلة، عدو الرذيلة، ماذا نكون وماذا تكون حياة الناس لولاك؟.
3) أما أبو الفلسفة الحديثة ديكارت فالفلسفة عنده مراد بها العلم حين قال إن هناك أنواع من العلم لا يتم معرفتها إلا من خلال الفلسفة ولا تقوم إلا على أساس فلسفي. فالفلسفة هي العلم بأفضل الأشياء والقدرة على الاستمتاع بها بكل وسيلة ممكنة.
اقرأ أيضًا: رعاية الذات.. الفلسفة: خطابٌ أم نمطٌ للعيش؟
تلك الاستعمالات لكلمة فلسفة تشير إلى وجود نوع من المعرفة يدفعنا غير المعرفة العملية، وهي الرغبة الملحة في المعرفة لذاتها. وعلى الرغم من عدم محدودية التعريفات الفلسفية، إلا أنها مرتبطة في أذهان العامة بمفاهيم خاطئة، تلك المفاهيم تعمل على عرقلة حركة سيرها وتطورها في المجتمع. ومن الملحّ أن نقوم بدحض هذه المفاهيم لإزالة اللبس والغموض. فالفلسفة في العقل الشعبوي ترتبط لديهم بالكفر والزندقة (الزندقة هي إبطان الكفر وإظهار الإيمان) مما يتسبب في نفور الطلاب منها وعدم إقبالهم على دراستها.
تواجه الفلسفة أزمتين:
أزمة التعلم داخل الأكاديمية، وأزمة مع المجتمع وذلك بسبب الأفكار والمفاهيم المغلوطة التي يتم تداولها.
ومن خلال تجربتي مع الفلسفة كطالبة أولًا، ومن بعد ذلك كمعلمة للفلسفة، فإن أول ما يؤرق ويرعب المقبلين على دراستها هو خوفهم الشديد من المساس بعقائدهم أو قيمهم، فهو يرفض إعمال عقله متوهمًا بذلك أن كل إعمالٍ للعقل ما هو إلا فتح باب للشيطان، رغم وجود آيات كثيرة في الكتب المقدسة تحث الإنسان على التعقل والتدبر والتفكر!
بينما يتعامل مع المفكر أو الباحث فى الفكر الفلسفي على أنه يعانى من امراض عقلية وأحيانًا يُتهم بالجنون، ومن يستطع التغلب على تلك المخاوف ويقدم على دراسة الفلسفة يصطدم بواقع أليم؛ ألا وهو أن الفلسفة تعاني من تلك المشكلات التي تعاني منها باقي العلوم الإنسانية؛ فهناك فجوة بين ما كان يعتقده دارس الفلسفة في أول الأمر وبين الواقع بالفعل. تعاني الفلسفة من ذات المشكلات العامة التي يعاني منها النظام التعليمي كله، تعاني مشكلات ذاتية بالميدان الفلسفي وحده مما قد يودي بمستقبل الفلسفة في مصر؛ حيث تواجه أزمات مع العقل الجمعي من مفاهيمه الخاطئة، وأزمات مع نظام التعليم بشكل عام، وأزمتها بشكل خاص مع طرق تدريسها.
أما بخصوص أغلب الأدمغة الفلسفية فهي تعاني من جمود وأصولية وانغلاق فكري! فعند عرضه لإشكالية “ما الحرية؟” فكل ما يقوم به هو عرضه لآراء الفلاسفة السابقين والالتزام بوجهة نظر واحدة سابقة دون إعمال عقله، ودون إفساح المجال أمام الطلاب لإقامة مناظرات ثقافية -تلك المناظرات التي تُتيح لعقله النقدي أن يؤتي ثماره، الحفظ دون الفهم؛ وهو السمة الأساسية للتعليم هنا، فكل ما عليك فعله هو حفظ ما يُتلى عليك دون إمعان النظر، دون التفكر، دون الابتكار؛ لأنك مقيد بنموذج اختبار معين يلزمك أن تتبع تلك الوسيلة في التعليم.
الانغلاق؛ ومن علاماته أيضًا تنفيذه لأيديولوجيا الدولة بكل مساوئها، فالفلسفة عنده مجرد وظيفة والموظف يؤدي عمله وكل ما يعنيه هو المقابل المادي الذي يتحصل عليه في النهاية؛ فلا يهتم بالموروث الثقافي أو العلمي.
الفراغ في المناهج وبُعدها كل البعد عن روح الفلسفة (البحث، النقد، وتطوير أساليب التفكير)، فلم يجد سوى السطحية والفراغ. وتعد من المشكلات المعقدة أيضًا التي يواجهها الدارس أنه لا اختلاف بين ميدان الفلسفة وبين أي علم آخر، حيث فقدت الفلسفة هويتها وسمتها الرئيسية، مشكلة أخرى، البعد عن تنظيم الأفكار الفلسفية أو التمهيد لها. فقد أخبرنا الأستاذ محمد ثابت الفندي بأهمية التمهيد لأي فكر ومنه التمهيد للفلسفة؛ “لأنها ليست علمًا يمكن تعلمه كالجبر أو الطبيعة وغيرها، فتلك العلوم متفق على قواعدها وقوانينها، أما الفلسفة فلا يوجد فيها اتفاق على شيء شأنها في ذلك شأن الإنتاج الفني يحمل طابع الفردية والأصالة. إذًا ما هي الحاجة المُلحة للتمهيد للفلسفة ووضع مقدمة تاريخية لها؟” لإزالة الضبابية عن عين الطالب في أولى مراحل اكتشافاته المعرفية.
فالمقدمات والتمهيدات لها فعل تأسيسي وبنائي عند التعرض لأي مجال معرفي بغرض الدراسة، فعندما لا تكون المقدمة جيدة وواضحة أو مكتملة بما يكفي فإنها تجعل عملية البناء متعثرة بشكل واضح؛ لعدم توافر القدرة لدى القارئ أو الطالب على تصنيف وترتيب المعارف الجديدة في المجال ودمجها بشكل متسق لسوء الأساس المراد البناء عليه. فالتقديمات تمثل شكلًا من أشكال العلامات الإرشادية على طريق المعرفة بغرض تسهيل رحلة المعرفة على الطالب واختصار وقت التيه والتخبط اللازم للوصول لبناء معرفي واضح المعالم.
أما عن مشكلة دراسة الفلسفة خصوصًا فإنها تعامل بشكل انقطاعي أو يتم التعامل معها بالقطعة وكأن الافكار تظهر من الفراغ، وذلك لغياب فكرة التطور عن العقل العربي عمومًا فلا يتم ترتيب الأفكار في سياقها التاريخي ولا البحث في جذورها مما يسهل على الطالب القدرة على تصنيف الأفكار والتفريق بين التوجهات المتعددة، والتمييز بين ما هو جذري وما هو فرعي، وإعطاءه صورة كلية واضحة عن الفلسفة كمعرفة إنسانية تلازم وجود البشر.
فمع الحاجة إلى التمهيد للفلسفة وخواء الساحة الأكاديمية من وجود مقدمة، يأخذنا إلى طرح إشكالية أخرى قد تكون الأخيرة هنا ولكنها ليست آخر المشكلات الدراسية، وهي:
ما المعيار الذي على أساسه يتم إصدار كتاب معرفي؟
يتكون الكتاب الأكاديمي من:
1-بعض أفكار مُدرس المادة، وعصارة خبراته الحياتية ووجهات نظره هو الذاتية، مع انفصال تام وبعد عن الواقع الثقافي المحيط، الفقر المعرفي والخواء حتى وإن تمت مقارنة الكتاب الأكاديمي بغيره من الكتب خارج سور الجامعة فالغلبة للكتاب الآخر.
2-معايير مُعينة -ملتَزَم بها- توافق المعايير التي تحددها الدولة.
وباختصار شديد فإن المجتمع المصري غير مؤهل لاستقبال عقول مفكرة، فعند ظهور أي فكر جديد يتم محاربته بكل قوة ممكنة من مؤسسات الدولة، مما قد يؤدي إلى إنهاء مستقبل الفلسفة. وسوف يرتاد الميدان الفلسفي أناس يحولونه إلى ساحة عرض لكل ما هو أصولي ومنغلق ورفض للتعددية وبعدهم عن الروح النقدية والموضوعية.
نرشح لك: العلم والفلسفة.. أيهما أهم؟
إعلان
