العرب في متاهة التدمير الذاتي الممنهج
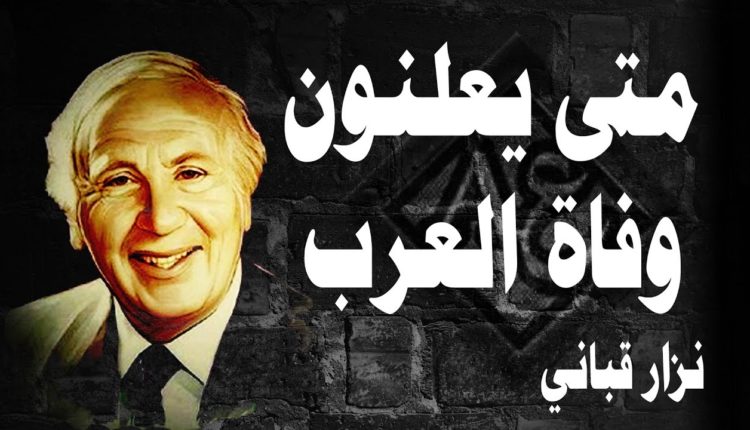
بدا جليًّا وواضحًا أنّ أصل الأزمة الخانقة التي تعيش البلدان العربية على إيقاعها المرير، هي انعدام الكفاءة والتجربة الضروريّتين لدى أغلب المسؤولين، سواء على رأس الوزارات أو في بقية مراكز القرار العليا. فليس من الممكن أن تقوم بالتغييرات والإصلاحات اللازمة في ظلّ غياب الكفاءات القادرة على إنجازها.
وبالرغم من أنّ الأزمة في الأقطار العربية دون استثناء، ولو بدرجات متفاوتة، قد بلغت ذروتها المأساويّة فإنّ العديد من المُمسكين بزمام الأمور ما زالوا مصرّين على إقصاء الكفاءات وأصحاب المعرفة والتجربة لأسباب يطول شرحها، وقد نأتي على تبيانها تباعًا في تحاليل قادمة.
فلو تمّ الاستنجاد بـ الكفاءات لما سقطت الحكومات العربية في تلك الأخطاء السياسية والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية الفادحة، كالرّضوخ المُهين لإملاءات الخصوم والأعداء والمعالجة الخاطئة للأزمات المستفحلة، ومهادنة المنحرفين والإرهابيين بذريعة صيانة حقوق الإنسان، والفشل في مكافحة التحايل والتهريب وغيرها من المسائل التي تقُضّ مضاجع الشعوب في الوطن الكبير.
كان الرئيس الفرنسي الراحل، الجنرال ديغول، يقول لوزراء حكوماته المتعاقبة طيلة ولايته الرئاسية:
“إنّ قيمتكم تتجلّى في قيمة المستشارين المحيطين بكم!”
وتفيد سجلّات التاريخ أنّ السلطان العثمانيّ محمد الفاتح، الذي اقتحم القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، إسطنبول اليوم، وضمّها إلى بلاد الإسلام، كان حريصًا شديد الحرص على عرض كلّ القرارات التي يعتزم اتخاذها على مستشاريه، ويناقشها معهم فردًا فردًا ، ثمّ جماعيًّا ، حتى قيل أنّه “كان ينفّذ ولا يقرّر.”
إعلان
بهذا الأسلوب المرتكز على مبدإ الاستشارة في الحكم هَزَم الإمبراطورية البيزنطية واستولى على عاصمتها القسطنطينية، وأسر إمبراطورها عماناويل الثاني صاحب المقولة الحاقدة، التي ما زال الصليبيون يردّدونها: “الإسلام دين عنف.” وعندما اغترّ السلطان العثماني الآخَر سليمان القانوني بنجاحاته الباهرة، تخلص من مستشاريه الأكفاء واحدًا تلو الآخر، ثم انفرد باتّخاذ القرارات الحاسمة في السّلم والحرب، فتحطّمت جيوشه الجرّارة على أسوار مدينة فيينا النمساوية، وكان عجزه عن اقتحامها بداية نهايته.
وفي تاريخنا العربيّ المعاصر أكّد العديد من وزراء الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة أنّ هذا الأخير كان رجل حوار ويحسن جيّدًا الاستماع إلى وزرائه ومستشاريه في الفترة التي كان متمكّنًا خلالها من زمام الأمور، وتحديدًا منذ تولّيه الحكم وحتى سنة 1970، تاريخ بداية تدهور صحّته. هذا السلوك الاستشاري كان سرّ نجاحه في اتّخاذ القرارات الصائبة، خلال مرحلة تأسيس الدولة المدنية الحديثة.
أردتُ الاستئناس بهذين المثالين للتأكيد على أهمية الاستنجاد بأصحاب التجربة والكفاءة والاختصاص في تسيير شؤون البلاد ، ولا أحد مهما علا شأنه قادر على الإلمام بكل المشاكل وحلّها بمفرده.
على مستوى آخر بدا وكأن كل قضايانا وأزماتنا ومشاكلنا الأمنية والاقتصادية والاجتماعيّة قد اندثرت واضمحلّت، ولم نعد نهتمّ بأثقالها وأوزارها وتداعياتها ومخاطرها، لتنصبّ كلّ اهتماماتنا على المسألة السياسية بكلّ ما فيها من مقايضات ومزايدات ومناورات ولعب بأعصاب الناس وضحك على ذقونهم. لقد أمعن السياسيون في الكثير من البلدان العربية، وخاصة تلك التي جعلت من الممارسة ” الديمقراطية ” الوهميّة واجهة دعائية ساذجة؛ في النزول بخطابهم إلى حضيض الإسفاف والوضاعة وقلّة الحياء وسوء الأدب، أجل لقد انحدر أغلبهم إلى خنادق الرغبات الانتهازية والمقاصد الدنيئة، وكشفوا عن قواميسهم السياسية الغارقة في مستنقعات الشعبوية المقرفة.
إنّ ما سمعناه وشاهدناه في المنابر الإعلامية، السمعية -البصريّة بالخصوص، يدعو إلى الحيرة البالغة والشكّ والقلق الكبيرين، فمثل هذه التصرّفات تصعّد إيقاع الاحتقان والمشاحنات وتزرع بذور الشّقاق بين أبناء الأمة الواحدة، وتدنّس، تبعًا لذلك، كلّ الأهداف التي طالبت الشعوب بتحقيقها ولم يتحقّق منها إلا النزر القليل.
نحن الآن بحاجة أكيدة وماسّة إلى تصحيح مناهج الفكر السياسي السائد، وتجذير قيم ومبادئ السّلوك القويم في تسيير شؤون الشعوب، وبالتالي تشريك كلّ الطاقات والكفاءات القادرة على الإفادة وانتشال أقطارنا العربية من المأزق التي تردّت فيه. لا شكّ أنّ المهمّة أصبحت عسيرة، بعد تفاقم الأزمات، ولكن لا بدّ من هَبّة وعيٍ حقيقيّة ومباشرة عملية الإنقاذ.
إنّ إقصاء الكفاءات من المساهِمة في تسيير دواليب الدولة وهياكلها لأسباب اجتثاثية لم يعُد يقنع أحدًا حتى الذين دأبوا على اعتمادها والترويج لها، من جهة، والسّقوط في متاهات المزايدات السياسويّة المبتذلة من جهة أخرى؛ هذين من أهمّ أسباب فشل الدّول وانهيار المجتمعات.
لقد ساهم هذا الوضع المتردّي في إيجاد بيئة ملائمة للغضب والاحتجاج والتمرّد وانتهاج مسالك العنف والإرهاب، ومنح أصحاب المخطّطات التخريبية هامشًا كبيرًا للتحرّك على جميع الأصعدة واختراق القطاعات الحساسّة لبثّ سمومهم، كالتربية والثقافة والإعلام وكلّ ما يتّصل بالتنشئة والتكوين في أوساط اليافعين والشبان، لاستقطاب الغاضبين والمحبطين والمهمّشين منهم، ومصادرة عقولهم وجرّهم إلى بؤر الإرهاب.
إنّ الصراعات المضطرمة في السّاحات السياسية العربية، الموبوءة بالعنتريّات والحسابات المصلحيّة والأجندات الداخلية والخارجية المشبوهة، كافية وزيادة لتعطيل مؤسسات الدولة وإغراق الأقطار في أزمات استغلّها الإرهابيون لتصعيد مخاطرهم والضّرب في صميم الرموز والقطاعات الحيوية، كان من المفروض أن تكون المخاطر المحدقة بالأمّة العربية مبعث روح للتضامن بين كل شعوبها، ومنطلق مصالحة شاملة تدعم الأمن القوميّ العربي، وتفتح أبواب المساهمة الفاعلة في الإصلاح والإنقاذ أمام كلّ القوى الحية والكفاءات العربية بالداخل والخارج.
لكنّ الكثير من الأنظمة ترفض ذلك وتدفع إلى مزيد من تأزيم الأوضاع لأنها لا تستطيع تأمين بقائها إلا في ظل العمالة للعدو والتفريط في سيادة أوطانها.
إعلان
