كيف تتحول الفكرة إلى فيروس؟
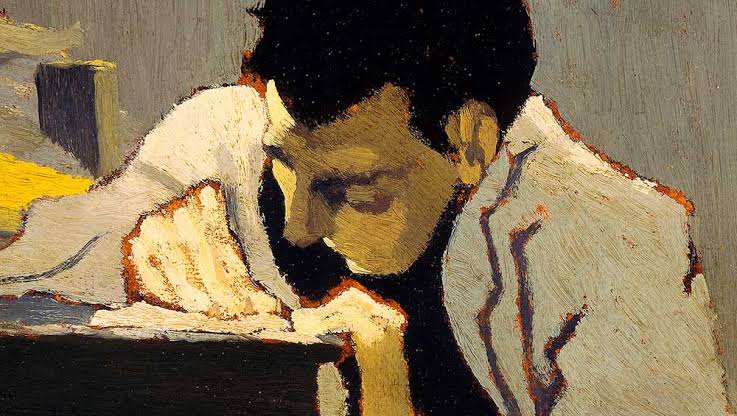
حاملو المسك والسجائر!
لعلَّك أنتَ أيضًا تعرَّضتَ لهذا الموقف المقزز، الذي يترك آثارَه على جلدِك، وفي أنفِك، وطيَّ وجدانِك، ساعاتٍ طوالًا. يقترب منك شخصٌ مبتسمٌ، ويصرُّ على أن تبتاعَ منه زجاجةَ عطرٍ رخيصٍ، رائحته خانقة؛ فإن رفضتَ، أصرَّ على أن تجرِّبه، فيمسُّ ظهرَ يدك، أو رسغَك، أو أيَّ موضعٍ تبلغه أصابعُه منك، بالمِروَدِ المبلَّلِ بالزيت الخانق، فيتعكَّر يومك بهذه الرائحة البشعة!
ولعلَّك أيضًا أُصِبتَ ذاتَ يومٍ بالغثيان، داخل أحد الميكروباصات، لحرص أحد الركاب على أن يغمس نفسه في أكبرِ كميةٍ من مزيل العرق، قبل أن يفارق منزله، ظنًّا منه أنه بذلك يُجنِّب إخوانه في الوطن رائحة عرقه المُنتِنة، التي يخال أن مزيل العرق (الخانق) أفضلُ منها. وليس من فرقٍ كبيرٍ بين هذا، وآخر لا يكف عن تعطير أنفه بسائلٍ عطريٍّ نفاذٍ، كالمسك مثلًا، طوال الطريق، الذي يقود الميكروباصَ فيه سائقٌ، لا بد وأن يكون مدخِّنًا؛ ولا أبشعَ في رأيي من رائحة السجائر، ولا أدعَى إلى النفور!
هذا جانبٌ من معاناةِ قطاعٍ كبيرٍ من الناس، الذين تصيبهم بالغثيان (وربما بما هو أخطر) الروائحُ العطريةُ، ودخانُ السجائر، وهؤلاء لا يستطيعون لِمَا ابتُلوا به دفعًا، وخصوصًا مع مجتمع، بدأت تنتأ فيه قيمة (فيسبوكيَّة) تروِّجها صفحات (الألش) الساخرة، مفادها أن الشخص الذي لا يضع مزيل عرق في قيظ الصيف، يستحق الاستهزاء والسخرية، لأن رائحة عرقه تزعج ركاب المترو والأوتوبيس! ولأن الاستهزاء – كحيلةٍ تطوُّريةٍ – يؤدِّي دائمًا دوره في تنحية الصفات التي لا يرغب فيها المجتمع، وتعزيز الصفات المستحبَّة (ولنا في استهزاء الناس بالقبيحات والأقزام ومنكري الألوهية وذوي البَشَرة السمراء والسِّمَان والعاجزين جنسيًّا حُجَّة على هذه الخصيصة التي لا تؤدِّي – بالمناسبة – إلى نتائجَ جيدةٍ في كل الأحوال، ولا مجال لها في أي مجتمعٍ متطوِّرٍ، ترقَّى على آلياتِ النَّبذِ البدائية). لأنهم لجؤوا إلى هذه الحيلة التطورية، راج رأيُهم، حتى تكاد اليوم تنفجر تقززًا من مستنقع الروائح العطرية الممتزجة بالعرق داخل المواصلات العامة. ولو كانت هذه الصفحات الساخرة استهزأتْ بمَن لا يستحم في الصيف يوميًّا، لكان خيرًا لنا؛ فرائحة العرق الصادرة عن جسمٍ نظيفٍ، أهون ألف مرة من مزيج العطر والعرق!
الدعاية بالرائحة!
الأزمة الكبرى تتجلَّى في الصورة الذاتية التي يُكنُّها هؤلاء المتعطِّرون اللزجون عن أنفسهم. إنهم يرون أن التعطرَ شيءٌ عظيمٌ، ويخيِّل إليهم إعجابُهم برائحةِ العطر أن بقية البشر سوف يُعجَبون بها. ويعميهم عشقُهم للعطر عن حقيقة أنَّ مِن الناس مَن يتقززون من الروائح النفاذة، وأن منهم من يصيبهم ضيق في التنفس، أو غثيان. هم لا يضعون هذا في اعتبارهم، ويحمِلونَ إلى الجميعِ تصوُّرَهم الشائهَ عن النظافة والجمال، ويفرضونه عليهم؛ فما أجدَى ملصقًا دعائيًّا يفوح من ثيابِ معتوهٍ داخل زحام المترو، يبشر بعقيدة العطر الرخيص!
ولا أعجبَ ممَّن يغلفون هذا بوشاحٍ من الدين، فيستدعون أحاديث الرسول التي نصَّ فيها على عشقه للطِّيب، وعلى حرصه على التعطر بالمسك، ضاربين بعرض الحائط، بل بعرض الجبال الرواسي وناطحات السحاب، كل الاختلافات الثقافية، وأعوام الترقي الحضاري، وحقيقة أن ثمة بونًا شاسعًا بين من يتعطر في (البادية) بمسَّةٍ من زيتٍ، ومَن يزاحم الناس في (المواصلات الضيِّقة) بالعطور النفاذة التي تضيِّق أمام المرء أيَّ مسلكٍ للهواء!
إعلان
وليس المدخنون عن أولئك ببعيدين؛ فهم أناسٌ استطابوا الدخان، وعوَّدوا على النيكوتين أعصابهم، واستلذُّوا بملمس السيجارة إذ يلثمونها، وإذ يرضعون منها وهم شَبِقون! ولم ألتقِ طوال حياتي بأحدٍ منهم – إلا قليلًا – يرى في عَلاقته الحميمة بالسيجارة ما يقتضي انعزاله عن الآخرين، حَذَرَ أن يؤذيَهم. أغلبهم يتفاخرون بتضيُّق أعينهم حين يمتصُّون الدخان، ولا فرق في هذا بين بلطجي وأستاذ جامعي، فما أكثر من رأوا ذلك الكاتبَ المنتفخَ بالخُيَلاء، جالسًا وسط محبيه ومبغضيه، ناصبًا سيجارته الملتهبة حيالَ وجوههم، متوهِّمًا أنها جزءٌ من جسده، فمَنْ رفضها رفضه، ومن رفضه حقَّ عليه العذاب الأليم! وهو ومن هم مثله، لا تختلف رائحةُ عقولِهم عمَّا ينفثونه!
الأفكار الفيروسية!
وما سبق يدعونا إلى التساؤل عن ردِّ الفعل العقلاني تجاه إنسانٍ جاهلٍ، سيطرتْ عليه فكرةٌ ضارَّة، وحسبها رائعةً، وبدأ يتحرَّك في هَدْيِها، فأزعج بها الآخرين. كيف نتعامل مع شخصٍ رأى أن أيًّا من (العطر الرخيص الخانق – التدخين – رفع صوت الأغاني الصاخبة بقربك – إلقاء القمامة من النافذة – مساعدة الآخرين على إتمام أعمالهم مقابل مبلغٍ ضئيلٍ يُعرف بالرشوة أو الإكرامية أو الشاي – تركيز خيوط الحكم في يد شخص واحد وقمع المعارضين لكي يتوحَّد الوطن – دعوة الآخرين إلى منظومة أخلاقية قديمة بدافع ميثولوجي عن طريق العنف – لمس أثداء الفتيات المتبرجات لتبيين خطورة عدم احتشامهن، والانسياق الآلي في الوقت ذاته للرغبة الجنسية الغريزية التي يهيجها عدمُ الاحتشام – التحكم في مصير الابن لأنه (سواء كبر أو صغر) مجرَّد إفراز منوي، خرج من مجرَّد عضوٍ، استثير في مجرَّد نَكْحة) شيءٌ عظيمٌ؟! كيف نتعامل مع من سيطرت عليه فكرةٌ ضارةٌ وسعى إلى تطبيقها؟!
وقبل أن أجيب عن هذا السؤال، لا بد لي من أعرف ردَّ فعلك تجاهَ شخصٍ عطس بقربك في محل عملك، فأعداك بڤيرَس الإنفلونزا، أو الكورونا وأقعدك في الفراش… أو حيالَ شخصٍ آخر، نُقل إليك بعضُ دمه أثناء إجرائك عملية جراحية في أحد المستشفيات، ثم اكتشفت أن ذلك الدم كان ملوَّثًا، وأن كبدك أصبحت موطنًا لڨيرَس (C)؟
ما ردُّ فعلك؟
ستتضايق بالتأكيد من الأول، وسيكون ضيقُك بلا شك أشدَّ في الحالة الثانية. لكنك في كلتا الحالتين، لا يمكنك أن تجزم بأن هذين الشخصين أرادا أن ينقلا إليك المرض!
إن الإنسانَ أداةٌ في يد الفكرة المدمرة، مثلما أن الجسدَ أداةٌ في يد الڨيرس.
الفكرة المدمِّرة تريد أن تبطُش. تبعثِر. تبدِّل. تهيمِن. تضُرّ. تتكاثَر. وكذلك الڨيرس. وإذا تحول الإنسان إلى أداةٍ، فلا سبيل أمامنا غير أن نتعاطف معه، وأن نتجنَّب أذاه، وأن نحارب (الفكرة\الڨيرس) بكلِّ وسيلةٍ، تمكننا من تحجيم الضرر قدر المستطاع. وإلى أن يهتديَ الناسُ إلى هذه الروشتة، سوف أظل على حالي البائسة، وأسأل كل سائق ميكروباص إن كان يدخن أم لا قبل أن أركب معه، ولا بأس في أن أنتظر نصف ساعة أو ساعة قبل الركوب. أهم شيء ألا يُضاف إلى بلاياي اليومية راكبٌ سَمِجٌ ينشر أفكاره الفيروسية عن طريق رائحة مزيل العرق!
نرشح لك: فيروس كورونا.. القاتل النبيل!
إعلان
