مراجعة لرواية (قصة حب إيرانية تحت مقص الرقيب)
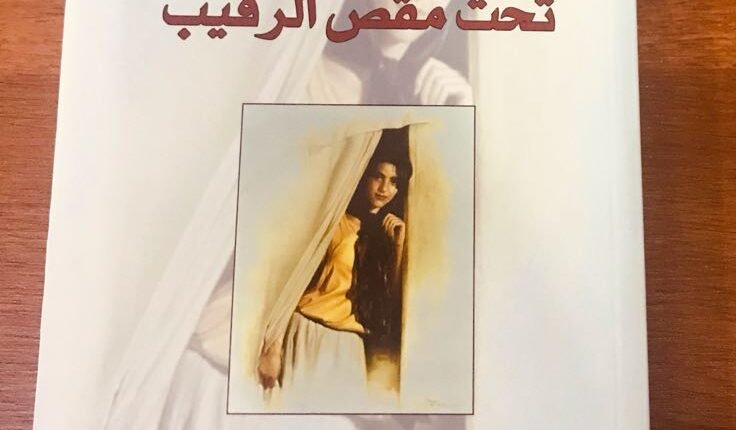
قبل أيام نشر موقع الإذاعة البريطانية BBC خبرا عن إلقاء قوات الأمن الإيرانية القبض على شاب وفتاة، بعد أن عرض الشاب الزواج على الفتاة أمام العشرات في المركز التجاري، فما كان منها بعد الموافقة إلا أن عانقته. ليطالهم مقص الرقيب الأمني، بِحجة مُخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية.
تساءلت إن كان الكاتب الإيراني (شهريار مندبي بور سيمانع.) إضافة هذا الخبر الصحفي إلى فصول روايته (قصة حب إيرانية تحت مقص الرقيب.) دون أن تنتظر روايته من جديد موافقة لإعادة نشرها قد تمتد أسبوعًا، أو شهرًا، أو سنة، أو بضع عقود.
تتنازعني المخاوف حين أقرا عبارة (قصة حب) أخشى أن أسقط فريسة بين دفتي كتاب يُكرر سرد قصة حُب مُستهلكة لمئات المرات. ويصف أحداثًا مُهترئة، ومشاعر مُعَلبة بالية مختومة بعبارات عِشق قد مَلِلنا سماعها. قد أقاطع كاتبها: دع عنك الأمر، يُمكنني إكمال المشهد لكثرة تكرره.
إن كانت رائعة ماركيز قد تناولت (الحُب في زمن الكوليرا.) حين تشتد كثافته كُلما اقترب من الموت، فإن الرواية التي بين أيدينا تُسلط الضوء على عهد الرقابة الشمولية، مُتخذة من قصة حُب جمعت ما بين سارة ودارا خلفية أدبية للأحداث. فإن كان القارئ من مُحبي الروايات الرومانسية، فلن يجد ضالته في هذه الرواية. فقصة الحُب هي العصا التي اتكأ عليها الكاتب لينتقد مجتمعه.
تصمت شهرزاد ألف ليلة وليلة، ويأتي دور المؤلف (شهريار مندني بور) ليقص علينا أحداث روايته بتهكم ساخر، بعيدًا عن اللغة البكائية المسربلة بالحزن. ويكشف لنا عن هويته قائلا: “أنا كاتب غير أني مَلِلت من كتابة القصص الكئيبة والمريرة، المسكونة بالأشباح والرواة والموت ذات النهايات المتوقعة والمليئة بالدمار.”
إعلان
يحيلنا عنوان الرواية (قصة حُب إيرانية تحت مقص الرقيب.) إلى خصوصية حالة الحُب هذه، وتقتضي عبارة (مقص الرقيب) وجود نموذج أعلى مسبق تُقاس به صِحة الأعمال، ومدى شرعيتها، مع وجود سُلطة عُليا، تمتلك حق مُراقبة ومُحاسبة الآخرين، وترض وصايتها المُطلقة.
بَيْدَ أن شهريار مُنذ الصفحات الأولى يشاركنا مخاوفه قائلا: “إن معضلتي هي أنني أريد أن انشر قصة الحُب التي سأكتبها في وطني، إن كتابة قصة حُب ونشرها في إيران ليس بالأمر الهين، ففي أعقاب انتصار إحدى ثوراتنا الأخيرة.. كُتب دستور إسلامي، ويسمح هذا الدستور الجديد بطباعة ونشر جميع الكُتب والمجلات، ويمنع مُمارسة الرقابة عليها بشدة وتدقيقها. لكن لسوء الحظ، لا يَذكر دستورنا ما هي الكتب والمنشورات التي يُسمح لها بمغادرة أبواب المطبعة بحرية.”
العيش في قفص من زجاج.
في ظِل مُجتمع يعيش تحت ظلال حُكم شمولي، يحيا أفراده في (قفص من زجاج.) تحت أعُين الأخ الأكبر والأصغر للسلطة، وحين تعُد عليهم أنفاسهم وهمساتهم، بل ويُحاسب المرؤ فيه على أفكاره التي ما زالت عالقة في ذهنه، فوحدهم لواقط السُلطة الاستخباراتية من تحسن الترصد للأفكار وهي في أدمغة أصحابها، فمجرد التفكير بالإثم إثم كما ورد في الرواية. تتسع دائرة المحظورات، وتغدو الكتابة تحت مقص الرقيب عملاً مضنيًا. فالعمل الإبداعي ابن الحرية.
عندما تتزوج السلطة السياسية مع الدين.
لطالما اقترن السلك الكهنوتي والديني بالسلطة السياسية، وهذا ما جرى في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران، إذ تلبست القوانين لبوس الدين، وأصبح الخروج عليها خروجًا عن الدين نفسه! وفُرضت رؤية أحادية للحياة. لا تعترف بحق الآخر في التعبير عن فلسفة تخالف فلسفتها، وتعلو اتهامات التكفير لكل من تحدثه نفسه بمساءلة القادة السياسيين والدينين فهم وفق هذه النظرة ظل الله في أرضه.
تكمن خطورة هذه الديكتاتوريات بأنها تتلاعب بالعاطفة الدينية لجمهورها، فتهدد بالحرمان الأخروي تارة، وبالنعيم المقيم تارة أخرى، لتمتد سلطتها إلى ما وراء الموت.
يقول إريك هوفر في كتابه (المؤمن الصادق/ أفكار حول الحركات الجماهيرية):
” الجماهير التي تطيح بالنظام لا تود إقامة مجتمع من أفراد مستقلين، بل بناء مجتمع يتميز بالتماثل ويجسّد الوحدة التامة، ويلغي الهويات الفردية”.
لماذا تخاف الأنظمة الشمولية من الأدب؟
تتساءل بطلة الرواية سارة، لماذا لا ندرس الأدب الإيراني المعاصر؟ لماذا مازلنا عالقين في دراسة نصوص كتبت قبل أكثر من ستمائة عام؟ لماذا عليهم أن يدرسوا نصوصًا لا تنتمي إلى همومهم الحياتية اليومية؟
يعكس الأدب نظرة تأملية للحياة، نظرة نقديّة تنمي الحس الفردي لدى المتلقي. وتحفزه للخروج عن القطيع والتمرد.
بينما تعمل الأنظمة الشمولية على خلق نُسخ كربونية من المواطنين، فكما في روايتنا يفرض زي خاص للنساء، بألوان محددة وتمنع الملابس قصيرة الأكمام على الرجال، يمسي الجميع متماثلين يرددون الشعارات ذاتها بشكل ببغائي، ولا يجرؤون بأي حال من الأحوال على معارضتها.
لكن كاتبنا يصرّ على كتابة قصته متيقظًا لعيني الرقيب السيد بورتفيري بيتروفيتش، لا تخفى النزعة التهكمية في اختيار اسم الرقيب الذي يذكرنا بشخصية المحقق في رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي، الذي مارس كل الحيل النفسية والقانونية في أثناء التحقيق مع راسكولينكوف. وكأن الأدب أصبح عملاً إجراميًا، يستوجب الملاحقة والترصد له.
إن كانت رائعة براي برادبوري (فهرنهايت 451) تتحدث وفق رؤية ديستوبية عن مجتمع يحرق الكُتب ويلاحق من يقتنيها، في احتجاج واضح على التضيقات التي مورست على حرية الكتابة والنشر في أثناء ما عُرف بالحقبة المكارثية.
فإن روايتنا هذه تتحدث عن عملية إبادة حقيقية للنشر والكتابة. إذ يشبه صوت تقليب بيتروفيتش للصفحات وهو يقرأها، صوت نصل المقصلة وهي تهوي”.
كيف استطاع الكاتب أن يحمي رقبة روايته من مقص الرقيب؟
لجأ الكاتب إلى حيلة مطبعية، إذ وضع خطوطًا تدل على شطب الجُمل التي يتوقع أن تعترض عليها الرقابة، وكتب نسخة أُخرى تُرضي ذائقته الأدبيّة.
وفي أحيان أُخرى كان يضع ثلاث نقاط دلالة على وجود نص محذوف (…)، ليترك للقارئ حُرية اكمال الفراغ وفق خيالاته. مما يُزيد احتمالات تأويل النص.
من خِلال هذه المناورات التي تعرف بالتشكيل المطبعي ينتقد الكاتب الرقابة التي تحد من حرية الكاتب في رسم شخصياته ووصف انفعالاتها. فلا يحق للشخصية الروائية الإيرانية أن تفقد أعصابها، أو أن تتلفظ بالشتائم، فقد “أصبح بعض الروائيين الإيرانيين يُقوّلون حفار القبور كلمات أدبية وفلسفية.” يتقهقر الجانب الحسي والعاطفي في وصف العلاقة بين الجنسين، فالويل لمن تسول له نفسه أن يذكر كلمة شبقية تؤجج نار الشهوات، فكلمات مثل الرقص أو القبلة اأو الخمر، على الكاتب اجتنابها حتى تحظى بموافقة الرقابة.
في عصر الرقابة يكثر توظيف التورية والاستعارات والرموز في الأدب للتعبير عن الأفكار. لقد مارس الكاتب رقابة ذاتية بشكل ساخر لاذع منتقدًا تلك الرقابة التي ترى في الكتّاب خونة وعملاء وفسقة يسعون لخراب أخلاق الشعب.
الموت للعبودية.. الموت للحرية
يفتتح الكاتب الرواية بمشهد يمتزج فيه الواقع مع الخيال، في مظاهرة طلابية على اعتاب جامعة طهران، يتردد هتاف الإسلامين بشعارات الموت لأمريكا، بينما يردد طلبة آخرون شعارات مطالبة بالحرية، وحدها سارا ترفع شعارا غرائبيا: الموت للحرية.. الموت للعبودية!
يحتار كلا الفريقين في تحديد انتماء سارة، ففي بلد يستوجب منك أن تكون محسوبًا على جماعة ما، كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة؟
كما جرت العادة، إن لم تكن معي، فأنت ضدي، تصف سارة الأمر: “يريد كل واحد منهم أن يلغي الآخر أقصد أن كل واحد منهم يريد أن يقص الآخر بمقص الرقيب.”
يبدو أن سارة قد كانت ناقمة على كل الأيديولوجيات الشمولية وأرادت من خلال شعارها الغريب ذاك أن تلفت الانتباه إلى فرديته. إلى حقها في التعبير عن صوتها الخاص.
تنتقد سارة الوضع السياسي قائلة: “لعن الله شعاراتكم السياسية، عندما أردتم أن تكونوا عصرين ضربتمونا على رؤوسنا لنخلع عباءاتنا، وعندما أصبحتم متدينين ضربتمونا على رؤوسنا لنضع غطاء الرأس ونرتدي العباءة”.
تنتفض سارة على عقلية الوصاية التي تمارسها الأحزاب، والتي تنظر للشعب كأنه قاصر لا يدرك ماهي مصلحته، وتفرض عليه بالقوة آراءها.
اخلق عدوا ولو كان رجل قش
يقول هتلر:”إن عبقرية الزعيم تتجلى في التركيز على عدو واحد على نحو يجعل حتى الخصوم المتنافرين داخل هذا العدو يظهرون كما لو كانوا كتلة واحدة.”
الكراهية هي السلاح الذي ترفعه الأنظمة الشمولية حتى يتشاغل الشعب عن محاسبتها، وتشعرهم دوما بالحاجة إلى وجودها، وإلى بسط نفوذها، واحكام قبضتها مهما كانت قاسية، لإن هناك عدوا يهدد الأمن المجتمعي والسياسي للبلاد، وتعلن حالة الطوارئ، ويخضع الجميع للمراقبة، فأي تهاون في هذا الأمر قد يحرم المواطنين الوادعين راحة بالهم
ويتعالى الهتاف: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لبريطانيا، الموت للشيوعين الموت للإمبريالية.
لا ضير في سبيل ذلك من أن تتجسس على هواتفهم، أو كتاباتهم، أو حتى أن تتهم من تحدثه نفسه الآثمة بالحديث عن الحقوق المدنية والإنسانية بالعمالة والخيانة أو قد يتأرجح فوق أعمدة المشانق في إعدامات سرية، كما أشار إليها الكاتب في سجن إيفين بعد الثورة الإسلامية.
في خضم هذه المسيرة، يطل علينا قزم أحدب من روايات ألف ليلة وليلة، في مشهد سريالية يتكرر في فصول الرواية، ويحذر سارة من الموت الذي ينتظرها قريبا. تسقط سارا على رصيف الجامعة وتغمض عينيها للأبد، ويحدثنا الكاتب عن قصة حبها مع دارا المعارض السياسي.
الستار الحديدي
تبدأ الحكاية حين تشتري سارة من بائع متجول للكتب نسخة من رواية (البومة العمياء) المحظورة في إيران، بعد أن أعياها البحث عنها في مكتبة الجامعة، لتجد عدة نقاط بنفسجية تحت أحرف معينة، تشكل مجتمعة رسالة من معجب سمعها وهي تبحث في المكتبة عنها، وقرر أن يبيع نسخته لها، ويخبرها أن رسالته التالية ستكون في رواية (دراكولا) بنفس أسلوب النقاط البنفسجية.
فلم يكن ذاك المعجب سوى دارا، بائع الكتب المتجول. وتتالى الرسائل بينهما في عدة كتب: كائن لا تحتمل خفته، الأمير الصغير، خسرو وشيرين، والحرب والسلام، ومسرحية عدو الشعب لإبسن. وتحمل هذه الروايات التي اختيرت دلالة سياسية واضحة. فعلى سبيل المثال، يمثل دراكولا استنزاف الدماء وامتصاصها، كما تمتص الأنظمة الشمولية دماء شعبها، في كائن لا تحتمل خفته نجد أنفسنا أمام حكم شيوعي شمولي صارم، لا يختلف في رقابته عما تعاني منه إيران.
العالم يتحول إلى معسكر اعتقال
يعكس أسلوب المراسلة بين العاشقين، المخاوف من الوقوع تحت أعين جماعة الإرشاد الإسلامي. في بلد يفرض الفصل بين الجنسين، وتتجلى هموم العاشقين في ابتكار وسيلة للتواصل أو اختيار مكان للقاء، في مشهد لا يخلو من التهكم مما وصل به الحال في إيران، يختار العاشقان أن يلتقيا في غرفة الطوارئ في إحدى المستشفيات! عسى ألا تحوم الشكوك حولهما. ماذا عن المكالمات الهاتفية؟
لا يختلف الأمر من حيث الرقابة التي تمتد إلى الأحاديث الخاصة بين الأصدقاء والمكالمات الهاتفية في إيران، عما وصفه ميلان كونديرا في روايته (كائن لا يحتمل خفته) في ظل الحكم الشيوعي حين قال: “حين يُذاع حديث بين الأصحاب أمام كأس نبيذ على الملأ، فهذا لا يعني إلا شيئا واحدا: العالم يتحول إلى معسكر اعتقال”.
الخوف من التشهير من قبل حرّاس الفضيلة كان يؤرق كلا الحبيبين، فاختارا أن يتراسلا بعبارات مشفرة في البريد الإلكتروني. يتوقف الكاتب هنا ليتحدث عن الرقابة على الإنترنت في إيران، التي لا تتوانى حسب قوله، عن شراء برامج أمريكية أخلاقية باهظة الثمن، لمراقبة المواقع الإلكترونية. ولأن الرقابة تفرض ستارا حديدا، فهي تمتد إلى مراقبة البيوت التي تضع صحونا لاقطة للأقمار الصناعية، فكيف يمكن للدول ذات الرأي الأوحد أن يستمع أو أن يشاهد مواطنيها شيئا لم يخضع لمقص رقيبها؟
ماذا عن اللقاء مساء؟
يبدو أن هذا الاقتراح لن يجدي العاشقين، ففي إيران يفرض إغلاق المحلات التجارية عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، وتنتشر دوريات الإرشاد الإسلامي التي توقف السائقين والمشاة، وتتحقق من هوياتهم، فماذا سنقول لهم حين يسألون عن صلة القربى بين سارة ودارا؟
إذا، لم يبق أمامهما سوى المنزل، لكن في الدول الديكتاتورية يتحول الجميع إلى مخبرين ووشاة، يقدمون آيات الولاء بالوشاية عن الاخرين. يتبرع جار دارا عطا الله، وهو عضو في جماعة الباسيج (وهي مليشيات من المتطوعين الاجتماعين المتحمسين للثورة لمراقبة المواطنين.) بإفساد مخطط لقاء العاشقين، فهو لا يغادر نافذة بيته، متسائلا عن سبب خروج دارا ليلا، فكيف بربكم لو رأى امرأة تدخل منزله
أعمى يقود مبصرين

خلافا للوحة بروغل الأكبر (أعمى يقود أعمى) المستوحاة من مقولة السيد المسيح: “اتركوهم. هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة”.
فإن الرقيب السينمائي الأعمى في روايتنا هو من يقود جموع المبصرين، الذين يصفون له مشاهد الفيلم، ويصدر أوامره بحذف بعض اللقطات، إذ أحس بأن بعض ما ينقل إليه يهدد الأمن الأخلاقي أو القيم الدينية. وتمارس رقابة صارمة تكاد تصل إلى درجة تجعل من الفيلم الذي أعادت الرقابة إنتاجه مسخًا فنيًا، لا يمت لصلة بالنسخة الأصلية منه.
يبدو أن المراقب الأعمى يحظى بحضور بارز في الروايات الإيرانية فقد سبق وأن ظهر المراقب العمى في رواية آذر نفيسي (أن تقرا لوليتا في طهران) مما يعكس مدى المفارقة الساخرة التي وصلت إليها البلاد.
أنف كونديرا
يقول الكاتب (شهريار مندني بور) في حوار صحفي معه: “الشكل هو كل شيء عند كتابة القصة. فكل القصص قد حكيت من قبل، والكاتب الشجاع ليس من يجد قصة جديدة بل من يجد طريقة جديدة في سرد قصة قديمة. أحب القصص المابعد حداثية ولكني لا أرغب أن أدفن تحت ركام أي مصطلح أو مدرسة أدبية.”
حسنا، قد تحدثنا عن فكرة الرواية، ولا تبدو حتى هذه اللحظة مختلفة لمن لم يقرأها عن عشرات الروايات التي تنتقد الأنظمة الشمولية، فمن أين اكتسبت الرواية تميزها؟
إنه أنف كونديرا، تماما. كونديرا الذي كان يحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة في رواياته، وبنبرته التهكمية الفلسفية، نجده يتوقف للحظات مخاطبًا القارئ أو شارحا بعض التفاصيل. هذه التقنية التي اشتهر بها كونديرا، هي سنجدها حاضرة في هذه الرواية المابعد حداثية التي بين أيدينا، ففي هذه الرواية يمتلك النص وعيا ذاتيا يكسر الحاجز بين الواقع والخيال. إذ يطل علينا المؤلف (شهريار مندني بور)، ليقطع حبكة الأحداث ليشرح شيئا معينا، أو يطلق أحكاما على النص، كما في حديث الكاتب عن روايته التي تلقت تحذيرا كما يقول : “لإنها أساءت إلى أرض جامعة طهران، وأساءت إلى الإخوة في حزب الله، أهانت شعار الحرية المقدس..”
نجد المؤلف في موضع آخر يشرح لنا التقنيات السردية التي سيستخدمها في روايته، كما في قوله:” وبغية نقل أفكاره المحرمة إلى قارئي، فإني أفضل خدعة يمكن اتباعها هي استخدام تيار الوعي. لكنني هذه المرة، لم أختر هذه الحيلة في السرد لأفي بمتطلبات شكل القصة، بل أريد أن أكتب سطورا تبدو مشوشة في الظاهر، جملاً لا تظهر فيها أفعال..”
وفي موضع آخر يقول: “في جميع الأحوال احتاج إلى شيء من التوتر القصصي في هذا الجزء. قولوا لي: ألا يحتمل أن ينشب شجار بين الحبيبين في قصة حب؟ أو هل رأيتم في حياتكم حبا لا تشوبه مشاعر الغيرة وسوء الفهم؟ إن كنتم سمعتم بذلك فأرجو أن تعلموني لكي أذهب وأقع في غرام ذلك الحب وأكتب عنه.”
يمسي الكاتب أحد شخصيات روايته، ويحدثنا عن حياته، وقصته حين حرم من تسمية ابنته بالاسم الذي يحب.
قد لا يروق هذا الأسلوب السردي لمن اعتاد تسلسل السرد في الروايات الكلاسيكية، لكن هذه التقنية السردية تضفي حيوية على النص، وتضع القارئ في قلب الحدث الروائي، بل مشاركًا فيه أحيانًا.
تبدو ملامح الميتاقاص أو القص الماورائي (Metaficion) في الحكايات عن الحكايات التي نجدها حافلة في الرواية كما في توظيف قصة القزم الحدب من قصص ألف ليلة وليلة، الذي نجد جثته تحدق بشخصيات الرواية التي تحاول التخلص من جثته، خوفًا من اتهامها بقتله، قد ترمز تلك الحكاية عن الخوف الكامن في النفوس، التي تعيش في خوف من ذنب لم تقترفه، ويمنعها جبنها عن المواجهة. في إشارة إلى نقد صمت المجتمع على جريمة الرقابة التي ترتكب بحقه. تظهر القصص الشعبية والخرافات في الرواية كما في قصة دافاليا العجوز الذي يركب على ظهر أحدهم ويلف ساقيه على رقبته وجذعه، ويرغم الناس على حمله طوال حياته أينما شاء. في إشارة لاذعة للديكتاتورية التي تحكم الخناق على الإيرانيين.
تتداخل الفنون في روايتنا التي نجدها حافلة بالنقد السينمائي للأفلام، والحديث عن الموسيقى. تمتزج تلك العوالم الفنية في أسلوب سريالي أحيانا يذكرنا بأسلوب (ميخائيل بولغاكوف) في رائعته (المعلم ومرغريتا) وبأسلوب هاروكي موراكامي في روايته الشهيرة (كافكا على الشاطئ). ففي روايتنا نجد حوتا في طهران، وطيور نقار الخشب تغزو المدينة. ففي بلد يحكم باللامنطق كل شيء محتمل، ولا يقل غرابة عن الواقع المعاش، عندها تتلاشى الحدود بين الواقع والخيال في بلد التناقضات. على حد وصف الكاتب.
تبلغ ذروة الغرائبية في روايتنا، حين تتمرد الشخصيات على الكاتب، وتحاسبه، بل تتحدث بعض الشخصيات عن مخيلتها، وتتمنى لو كتبها المؤلف كما تحب، ومثال على ذلك ما ورد على لسان دارا مخاطبا الكاتب: ” في مخيلتي جلدت ذلك المحقق، لم تكن لديك الشجاعة لكي تكتب ذلك”.
تخرج بعض الشخصيات عن سيطرة المؤلف، بل إن الكاتب يتوسل إلى دارا، بعد أن تملكه الغضب وقرر أن يرتكب جريمة قتل. يقول المؤلف: ” دارا عد إلى البيت! إنك تدمر كل شيء، فأنا كاتب معرض لمقص الرقيب، يمكنني أن أزيلك من روايتي بسهولة إن أردت ذلك.. دارا لا يسمعني، ويواصل سيره، أندم على الكلمات التي قلتها”.
هل رأيت اللص الذي سرق معطفي؟
لعل أشهر معطف في الأدب هو معطف أكاكي أكاكيفيتش الذي ورد ذكره في قصة المعطف للروائي الروسي غوغول. والذي يرمز إلى سرقة الأمل. يتساءل الكاتب من سرق مِعطفه؟ من سرق الأمل بالثورة التي كان يفترض فيها أن تحرر الشعب من الطغاة؟ فإذا بها تخنق أحلامهم بالحرية.
تتعالى صرخة سارة: لماذا؟ لماذا انتهى بلدها إلى هذا الحال؟
لماذا تنتظر الجموع في طوابير بطاقات الدعم للأرز، فيما بلدها يطفو على بحر من النفط؟
قد تكون الإجابة ممثلة بشخصية السندباد، الذي يمثل الانتهازيين سارقي الثورات، من بنى مجده الشخصي من التعاون المشبوه مع السلطة الرقابية، فهو لم يستورد أقلاما مكسورة، بل استورد وأغرق الأسواق بأقلام لا تكتب! في إشارة إلى دوره في القمع، بعد أن زود دائرة الأحوال المدنية بقوائم للأسماء الإسلامية وأخرى بالتي تخالف الدين.
فبسبب هؤلاء هاجرت خير العقول من إيران كما يقول الكاتب، فيما اغتيل آخرون أو انتحروا، أو طردوا من أعمالهم، بعد أن طالهم مقص الرقيب بمساعدة هؤلاء الانتهازيين.
يبقى السؤال معلقًا، ماذا سيحدث لو اختفى مقص الرقيب كليا، هل تكفي الرقابة الذاتية لتنظيم شؤون الحياة، أم أننا سنغرق في الفوضى؟؟
لكن مهلاً، أليس في كلا الخيارين تطرفا؟، ألا توجد منطقة وسطية بين مقص الرقيب المطلق التحكم، وبين انعدام أي شكل مُقنن من الرقابة؟
لكن من يحدد معالمها؟ سنبقى إلى ذلك الحين ننتظر الإجابة، فيما يُعمل مقص الرقيب في الكثير من بلدننا نصله.
إعلان
