الذات التي تُكتَب: كيف نعيد أنفسنا على الورق؟

ثمّة كتبٌ نقرؤها لنقفل بها فكرةً شاردة، وأخرى نطارد بها سؤالًا لا يكفّ عن الانفلات. أمّا هذا الكتاب، فشدّني إليه دافعٌ مختلف: حبّي للدفاتر، وللكتابة بخط اليد. لا أتعامل مع دفتر الملاحظات كأداة، بل ككائنٍ ينمو معي، ويختزن شذرات ذهني، ويدرّبني على البطء، وعلى الصمت، وعلى الانتباه. احتجتُ إلى كتابٍ يفسّر سرّ هذه العلاقة التي لا أذكر متى بدأت، لكنّها مع الوقت غدت وجهًا آخر لتفكيري: وجهه المكتوب.
وجدتُ ذلك في كتاب «الدفتر: تاريخ التفكير على الورق» للكاتب البريطاني رولاند ألن، الذي يشتغل في تقاطعات الثقافة والتكنولوجيا، ويهتمّ بسيرة الأدوات المكتوبة وكيف تصنع وعينا بطرقٍ خفيّة. وما يفعله في هذا العمل لا يندرج في باب الحنين، بل في حقل أكثر توتّرًا: مساءلة العلاقة بين الإدراك وتجسّده على الورق، بين المادة والفكرة، بين الكلمة حين تُقال، والكلمة حين تُدوَّن.
التفكير يحدث حين نكتب
يقدّم ألن في هذا الكتاب ما يتجاوز تأريخ الوسيط المادي إلى ما يشبه «أنثروبولوجيا الإدراك المكتوب». فلا يسأل «متى دوّن الإنسان؟» فحسب، بل «كيف بدَّلَ التدوين نسيج تفكيره؟». تنبني أطروحته على فرضية «العقل الممتد»؛ إذ يعاد تشكيل الوعي خارج الجمجمة لا داخلها وحدها. فإذا قطعت الصفحة، انقطع معها شريان فكرةٍ بكاملها. وهكذا لا يكتمل الوعي إلّا حين يمتدّ إلى الورق: يتحقّق، ويتعثّر، ويراجع نفسه، كأنه يجرّب ذاته في العلن.
ليست هذه إعادةً لتاريخ الكتابة، بل لإعادة صياغة علاقتنا بها. فالإنسان — كما يلمح الكتاب ضمنًا — لم يكتب لأنه فكّر، بل تعلّم كيف يفكّر لأنّه كتب. والدفتر -في نظر ألن- ليس وعاءً جامدًا، بل رئة إضافية ننفّس بها المعنى حين يضيق صدرنا، ونستدرك بها ما يتبخّر في العتمة. حتى في سرده، لا يتبع ألن خطًّا زمنيًا مستقيمًا، بل يفتح دفاتر كأنها شظايا لذاكرة إنسانية، تطفو على الورق لا على السرد.
سلطة الصفحة الخفية
واحدةٌ من أكثر أفكار الكتاب إثارةً تتلخَّص في أنّ الدفتر لم يكن يومًا وسيطًا محايدًا؛ بل منتجًا ثقافيًا يعيد تشكيل من يستخدمه. المحاسبة لم تنشأ من فراغ السوق؛ بل من طريقة التدوين المزدوج التي فرضها شكل الدفتر. الرسم الواقعيّ لم يتفتّق عن ذائقةٍ جديدةٍ فحسب؛ بل عن فضاءٍ تجريبيٍ أتاحه دفتر الرسم. حتى الدولة الحديثة، لم تشكّلها أيدي الملوك، بل قامت على دفاتر بيروقراطية كتلك التي خطّها كولبير بخطوط مشفّرة.
كل صفحةٍ إذًا سلطةٌ أو مقاومة. قد يمسك الدفتر بمسوّدة قانونٍ صارمٍ، أو يهرّب هجاءً سرّيًا ضد قائدٍ متسلّط. وقد يحتضن قائمةَ تسوّقٍ دوّنتها أمّ، لكنها عند المؤرّخ وثيقة حياة. وهنا يتجلى انحياز ألن للمهمَل والمهمَّش، إلى المذكرات التي لم تكتب لتنشر، لكنها حفظت للعالم وثائق لا تقل بلاغةً عن الكتب الرسمية. هكذا يغدو دفتر القابلة أو البحّار أو الطالب مصدرًا حيًّا لمعرفةٍ تشكّلت فعلًا، لا كما صيغت بعد الانتصار.
حين يربك الورق اللغة والدماغ
يربك ألن تعريفاتنا المطمئنّة للدفتر؛ فما هو دومًا مساحةٌ للتأمّل، بل قد يغدو أداة هيمنةٍ، كما في دفاتر الشرطة التي رصدت المجرمين وضبطت من يلاحقهم. بل وقد يتحوّل إلى اجترارٍ نفسي حين تنفلت الكتابة من تأملها البنائي. غير أن ما يبقي للدفتر سحره، هو كونه يسمح للذات أن تتشكّل خارج أعين الآخرين. لا شاشة ترصد، ولا نظام يقيس، بل صفحة تخطئ وتُصحّح، تشطب وتتردّد، وتكتب كي تفهم نفسها لا لتُفهم.
ينزلق الكتاب بسلاسة من التاريخ إلى البيولوجيا؛ من سرد الثقافات إلى تركيب الدماغ. يبيّن كيف تحفّز الكتابة بخطّ اليد مناطق عصبية لا تلامسها الكتابة الرقمية. اليد تفكّر، والعين تفكّر، والورق يردّ الصدى. ليست استعارة حين نقول إن الورقة تفكّر معنا، بل حقيقة تثبتها صور الدماغ. فالكتابة لا تفرغ فكرة جاهزة، بل تولّد فكرة ما كانت لتوجَد لولا احتكاك القلم بالصفحة.
الدفتر المشترك: ذاكرةٌ منفلتة
في هذا السياق، أجدني أستعيد علاقتي بـ«الدفتر المشترك» أو الـCommonplace Book، الذي أجمع فيه اقتباسات، وأربط به شتات الأفكار، وأرجع إليه حين تفيض النصوص التي أترجمها، أو تتداخل قراءاتي. عبر هذا الكتاب، أدركت أن ما أفعله له جذور تعود إلى إيرازموس ومونتين، وأن تلك الدفاتر التي تبدو عشوائية إنما تمارس فنًّا خفيًّا في اقتناص الفكرة قبل أن تُقنّن. هي كتابة الفهم لا لتثبيته، بل لإعادة توليده.
اللافت أن فكرة «الدفتر المشترك» لم تنقرض، بل بعثت نفسها رقميًا في تطبيقات مثل Notion وObsidian، التي تحاكي الشبكات المعرفية للدماغ عبر الربط والتنظيم. كأن الوعي صار خريطة لا خطًا. هذا التوازي بين الورق والرقمنة لا ينفي الأول، بل يذكّرنا بأن أقدم أدواتنا المعرفية ما زالت تملي شروطها على الأحدث. وأن التفكير الحي لا يُستعجل.
إعلان
في وداع الصفحة… هل نفقد ذواتنا؟
قرأتُ في الكتاب أسطرًا شعرتُ أنها كتبت عني، أو عن كل من استأمن دفتره على روحه. تقول جوان ديديون: «دفترك لن يفيدني، ولا دفتري سيفيدك». عبارة أفهمها بكليتي؛ لأن ما يكتب في الدفتر لا يقصد به أحد. هو تمرين في تذكّر الذات، لا في إقناع الآخرين. وهنا ينهينا الكتاب على سؤال مفتوح: ماذا يحدث لو اختفى الدفتر؟ لو استُبدلت صفحاته بتطبيقاتٍ لا تترك أثراً مادياً ولا زلّةً للعين؟
لا يدّعي ألن أن الورق سينقذنا، لكنه يلمّح إلى أن غيابه قد يسلبنا الطريقة التي نعيد بها صياغة أنفسنا. لأننا حين نكتب بخط اليد، لا نحفظ، بل نكوَّن. وإذا تخلّينا عن تلك الصفحة، لا نخسر أداة فحسب، بل نخسر المسافة التي تسمح للفكرة بأن تتنفس، وللذات بأن تهمس لنفسها من دون أن تفضحها شاشة. الكتابة اليدوية ليست نوستالجيا؛ بل وعيٌ يتشكّل، في صمت الحبر.
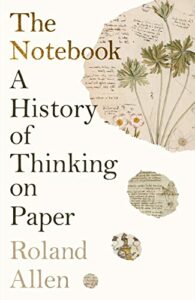
مرجع:
https://www.goodreads.com/book/show/148014534-the-notebook
إعلان
