تاركوفيسكي الشِّعر والحقيقة
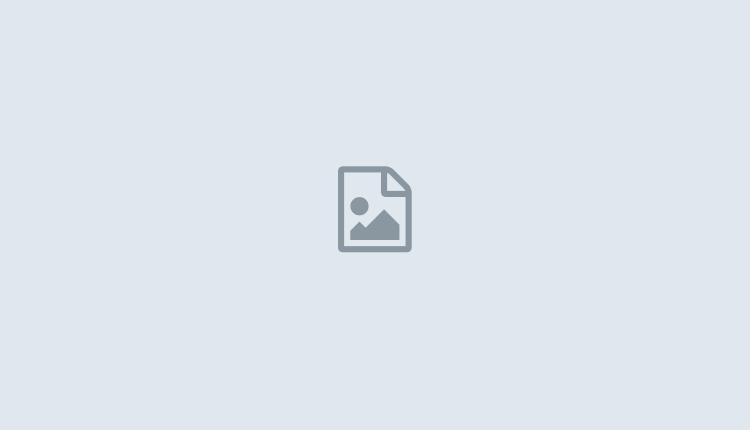
السينما تبحثُ عن التأثير ذو القَصد
والنهائيّ بالإيماء، والحَركات، والنَبرات.
الصوت: هذا النِظام الذي يستَثني حتمًا
تعابيرَ التواصل وتبادُل الصور،
والأصوات التي قَد يُنتَج من رحمها تحوُّلات.
بريسون / حولَ السينماتوغراف
في كتابه “التفكيرُ المرئيّ Visual Thinking, Rudolf Amheim – رودولف أمهايم”، أشارَ إلى مبدأ الاهتمام الذي يمثِّلهُ الارتباط الأساسي بين الفيلم والحُلم والذي يُصبح واضحًا بمجرد رؤيتهِ، أما فيما يتعلق بآلية عمَلِ الحلم، من ناحية عِلم النفس، فرويد على سبيل المثال، ولسبب أنه ناقشَ أغلب أطوار الأحلام: يطرح فرويد السؤال الأشهَر حولَ “كيف يُمكن أن تكونَ الروابط المنطقية المهمة للتفكير، مُمَثّلة بالصور”، ويضيف قائلاً، في أغلب كتبه التي تتناولُ مسألة القضية الحُلمية، أنَّ هناك مُشكلة مماثِلة في الفنون البصريّة، هناكَ بالفعل أوجه تشابُه بين صور الأحلام وتلكَ التي تم إنشاؤها في الفن السينمائيّ أو الرسم من ناحيةٍ أُولى، والصور الذهنية التي تعملُ كوسيلة للفكر من ناحيةٍ أخرى، ولكن من خلال ملاحظة التشابه، يصبح المرء أيضًا مدرِكاً للاختلافات، ويُمكن أن تساعد هذهِ الاختلافات في وصف الصور الفكرية بشكلٍ أكثر دقة.
مسألة ظَرفية “تَخيل لو سمَحت”، أنا وأنتَ، كِلانا يُدرك المِنضَدة، سواءَ تلكَ التي نسجها الصنايعيُ الشعبي أو تلكَ التي بناها المَصنع، كُلها، الزهريّة المنقوشة والبرونزية المُخَرمة والبيضاء الناعمة، لكنَ إدراكي لها ليسَ بالضرورة مُترجَمًا إلى عقليٍّ مثلما ترجمت حواسُك وجودها، لأنكَ رُبما لم تحمِل جميع صفاتها، كالأذرُع الطوالية، والقاعدة السُفلى والظهر الخَفي الذي عادةً ما أحَبَّ طفل فيلم “آلكساندر لبيرغمان” أن يختبئ تحتهُ، ثمَ يُشاهد، لماذا المنضدة إذن؟، ما هي المِنضدة؟، أو الصخرة؟، كذلكَ البيت؟، مجموعةٌ مُعينة من محتويات الشعور المُحاطينَ بها، “كانَ يلتهمها بنظراته”، هذهِ العبارة تُمثل، عندَ سارتر، الوهمَ المُشتركَ بين الواقعية و المثالية والمعرفة حسبَ هذهِ الأشياء يقتدرُ الالتهام، لقد اعتقدنا أنَّ شبكة الفكر العنكبوتية تجتذبُ إليها الأشياء نحو نسيجها، تُعطيها بريقها الأبيضَ الناصِع، معَ ذلك فلا شيء يبدو واضحًا، هناكَ إبهامات كثيرة، أليسَت المنضدة محتوى يُفَعِّلهُ إدراكي؟، أليسَ إذن إدراكي هو حالةٌ يرهنها شعوري نحوهُ؟، إذن هناكَ اعتداءٌ على الأشياء وهناكَ تمثُّل، عبثاً هناكَ أشخاص، و أكثرهم يبحثونَ عن أشياء ليس لهل عقل، نحنُ نُعَقِل و نُدَرِك و نلتهم، يبحثون داخلَ أشياءٍ جامدةٍ صرفةٍ، “يقصد الفيلسوف لالاند”،
الفيلسوف برغسون، كانَ يرى أنَنا ذو تجاربَ باطنية مُتعدّدة، لشيء واحدٍ لا يُمكن أن يُطور ذاته من تلقاء ذاته، أما الذِهن البشري يَعمد بنفسه لإيقاف الزَمن، لأنهُ لا يُسيطر على الديمومة، لذلك قال عبارته المَعروفة: “إنَ الفكر هو جزء من الحياة، إذن لا يمكن للفِكر أن يُسيطر عليها”، ثمةَ أوجه تشابُه من ناحية “الرؤية فقط”، بينَ باشلار الفيلسوف الفرنسي والمخرج الروسي آندريه تاركوفيسكي، لأنَ الأوّل أرادَ منا أن نبتعد عن العالَم الأليف أي تلكَ الصور الذاتية المُشبَعة بالسلام الراسخ والعاجز عن لمس آفاق جماليات الوجود، فهوَ أرادَ أولاً أن نُكاشِف العالَم بالجمالية الحقيقية، كذلك نُعامِل العالم وفقَ ثنائيةٍ سنجدها تطغى في تعريفاته بشكل متزايد وهي “الذاتية والموضوعية”، هذهِ النُقطة التي ينطلق منها باشلار هي عملية “إحياء” الأشياء التي لم تُدرَك بعد، لربما علميًا قد قيلَ عنها “أنها من خشب، من أواصر كيميائية، من معدن”، وهذا لا يكفي لأن مشاعرنا وقَفت ضمن حدود تلكَ الأقاويل العلمية، فعليهِ، أن يصبح العلِم فاتحَ الذراعين، ومُحتضِنًا للشعرية، يقول “ثمة تقارُب بينَ العقل الفيزيائي وبين العقل الميتافيزيقي، ألا وهو اللا واعي”.
تفحُصاً لتاركوفيسكي: سنَجِد بشكل واضح عندَ مشاهدة أفلامه، أنّهُ طور الظاهرة الجمالية لـ “الحلم” في هيئةٍ أكثر اتّساقًا من مفهوم “معاداة الواقعية، أي أنَ حسب رؤية الفلسفة التحليلة، هناكَ آليات حدسية، وثَمة مُميزات أبعد من الواقعية العامة ومُستَقِلة عن مُعتقدات المرء ومفاهيمه”، أما فيما يتعلق بالحلم تُصبح هناكَ اعتبارات مهمة للحالة التي تعيشها المادة “فصوت الخرير حيٌّ أكثر من اللازم، وصوت العُشب مُحرِّك للقشعريرة، وصوت حذوة الفرس تُطرِق في الأذُن”، لكن هناكَ شيء، إنَ تاركوفيسكي لا يطلُب من المُشاهد أن يكونَ متعاطفًا، أو يريده أن يكونَ مشاهدًا متأثّرًا على الدوام، بَل ستكون الفكرة الأساسية للسينما خاصّتهُ والتي طوّرَها عبر تسلسُل أفلامه، كانَت في اتجاه “منطق الحلم”، إنَ مبدأ تاركوفيسكي التصويري عادةً يطغى عليهِ مفهومٌ أساسيٌّ وهوَ “جعل الأشياء كُلها غريبة”، وهو الجانب الأكثر راديكالية وبالتالي الأعمق في أعماله.
إذا كانَ نيتشه يتطرَبُ بتدفُق الوقت، فإنَ باشلار يُحرِك السكون، خاصةً ذلكَ الساكن داخلَ النفس، فهو نفسيّة مُحرّكة للخيال و يُعطي الحُلمَ كُلَّ قوى العُزلة، بينما عندَ نيتشه مُصَعِّدة تُريد من عُزلتها تقدير ماهية الحقيقة، بينما كانَ دانتي ألغييري نائمًا بعد تعبٍ شديد، رقدَ مُتِمًّا من الأنشودة الثالثة، إلى الرابعة التي التقى فيها ابنَ رُشد وابن سينا، يقول :”حطَّم النومُ العميق في رأسيّ رعدٌ ثقيل، حتى هاجني الفَزع”، نتريّثُ هنا قليلاً ونرى ذلكَ الجزءَ الذي أحسّهُ دانتي حينما دعتهُ تلكَ الأصوات العالية، لقد سلبتهُ النوم أليسَ كذلك؟، النومُ هذهِ الحركة الخيميائية التي بعدَ الصحوَ منها، نتدرعُ من المادة الداخلية المُضطربة، إلى المادة الأكثَر اضطرابًا وتلغيزاً، الطبيعة الصاحية، إنَ الطيران واحدُ أشكال ذلكَ الصحو الألغييري الذي تأخذهُ الشياطيين والملائكة في كتاب الجحيم كسبيلٍ وحيد تتشبثُ بهِ هروباً من قاعية الأرض وسخط الأحجار الصخرية، حتى في رحلته الخيالية هذهِ، يُقدّم الشاعر لنا، ذلكَ الكائن اللا كائن، المجهري الذي يرى ذاتهُ محلّقًا صوبَ الأُفق، بشكلٍ تصاعديٍّ صوبَ فيزياءٍ خيميائيةٍ حالِمة.
إعلان
وفقاً لفلسفة باشلار، فإن الخيال يتم إنشاؤهُ بواسطة أي حركة، الإرادة البشريّة هي الاندماج مع تلك الحركة، الفكر هو البحث عن طريقة لكيفية القيام بذلك عملياً، يجب على الفيلسوف الذي يرغب في فهم البشرية أن يُركّز على تعلّم الشعراء من الطبيعة، إذن التحليق هو ذلكَ المَدُّ الهادئ الذي يُريد أن يرينا إياه باشلار، يقول عن نصٍ ترجمته، واصفاً المفهوم النفسي لـ “تدفُّق التحليق” في كتابه “الهواء والأحلام”، الذي نُشر عام 1942.
“أي عُنصرٍ تكون ممارسة التخيُّل فيهِ قادرةً على إنتاج تسامٍ خاص وتنقية وتوضيح، التسامي الجوي من أنقى أنواعه، يتم استكمالهُ بتوضيحٍ ديالكتيكي خفيف، يبدو أن الكائنَ الطائر يتحرّكُ خارجَ الغلاف الجوي الفعلي الذي يطيرُ فيهِ، هناك دائمًا يتفتّحُ ذلكَ المجال للارتقاء أكثر والمطلق هو المرحلة الأخيرة من وعي الحُرية الذي تم إنشاؤهُ بهذه الطريقة، الصفة الأكثر ارتباطاً بالاسم “Air” هي “Free”، الهواء الطبيعي هو الهواء الحر، إنَ الظواهر الجوية هي الأكثرَ وضوحًا وانتظامًا، إنها تُعطينا إرشادات لمشاعرَ نفسية مهمة جدًا، بَل تستلهمُ الريَّثَ فينا، مثلَ الوقوف، والنمو، والتسلّق، والطيران، والتطهير، هذه المشاعر هي المبادئ الأساسية لعلم النفس التنموي والتي يمكن تسميتها “علم نفس الطيران”.
يوجدُ في قلب كل ظاهرةٍ نفسانيةٍ شعورٌ حقيقيُّ بالعمودية، هذه العموديّة ليست بلاغيّة فارغةً أو مُجَوّفة بلا فائدة، إنهُ مبدأ من مبادئ النظام، وهو مقياس يمكن من خلالهُ أن يختبر الشخص درجات مُتفاوتة من الأحاسيس في الحياة العقلية، كل المشاعر الدقيقة والرائعة، الآمال والمخاوف، القوى الأخلاقية المُشاركة في مستقبلنا، لها تفاضلٌ عمودي، بالمعنى الهندسي الكامل للكلمة، وتجدر الإشارة بشكلٍ خاص إلى الصور والأفكار المرتبطة بالقيم الأساسية للنفسانية الجُوانية: الحرية، الفرح، الخفة، التسامي، الارتفاع والعُمق والانحدار والسقوط وما إلى ذلك، هي استعارات بديهية بامتياز، لا شيء يفسرهم ويشرحون كل شيءٍ، بلغة بسيطة، إذا أراد الشخص أن يعيشها، ويشعر بها، وقبلَ كُل شيء دمجها مع الحياة الواقعية، فإنهُ يدرك جودتها الأساسية وطبيعتها، من المستحيل التعبير عن القيم الأخلاقية دون الرجوع إلى المحور الرأسي، كُل عصب في الجسم هو جهاز إرسال عمودي، الهواء الوهمي هو هرمون النمو العقلي للبشرية”.
إذن باشلار، يرى في الطيران ذلَكَ النهج الذي يُشبه علم يستخدمهُ القارئين في الأساطير المُصورة، بل يراهُ تأرخةً عالية تُسجل فيها تمظهرات المكان بسُرعةٍ نامية، علينا تجربة الطيران الشراعي مثلاً، حتى نتفحص التفاصيل بمذاقٍ بهلوانيٍ تصاعُدي، حتى لا نضطر يومًا أن نكتب في مذكراتنا الشخصية، ما كتبهُ ميشيل ليريس: “خطوةً بعد خطوة، نزلتُ درجات السُلَم کنت شیخًا هرمًا وكل الأحداث التي أتذكرها تجتاز أعماق عضلاتي من الأسفل إلى الأعلى كبراغيٍ تتسكّعُ في جَنَبات قطعةَ أثاث”.
لَقد صَمَّم تاركوفسكي مفهومًا جديدًا للزَمن يتغلب على الأشكال “المباشرة” للتمثيل، على سبيل المثال تلكَ الواقعية والانطباعية وحتى الرَمزية، ويتغلّب أيضًا على “منطق الدراما التقليدية، التي تكون محشوة بالأحاديث الواقعية الاعتباطية”، لكن ثمةَ أمر لافت للنَظر هو أن تأسيسهُ لخواصه تلكَ لا يُمكِن في الوقت الحالي إعادة تصنيعها ذهنيًا، أن تكون ملائمة لليوم دون الشعور بأنك تائه، أعتقد بسبب طُغيان السينما اليومية التجارية.
إنَ تاركوفيسكي يُشير لـ”الغريب بشكلٍ مُطلق”، وهذهِ صفة جمالية جديدة لم تُغير ببساطة منطق الحياة اليومية “الواقعية” بتحويلها إلى عالم “غير واقعي”، لا تمثل تعابير تاركوفسكي “الحقيقي” ولا ترمز إلى “غير الواقعي”، يظلون في مجال بندولي يتحركُ في “غير المُحتمل”، بين الترميز والتمثيل والتعبيرات المُطلقة وهذا ما تُمنَح إليهِ طابعها “الغريب”، من خلال هذا “الجهاز الغرائبي” يتغلّب تاركوفسكي على الاستعارة والرمزية السينمائية، كذلك يجب النظر إلى مشكلة “الرمزية” و”المجاز” في سياق هذه الإستراتيجية، يقول: لا ترمز “المَناطِق أو المكانات” في فيلم المُطارَد إلى أي شيء، أكثر من أي شيء آخر في أفلامي، المنطقة هي منطقة، إنها الحياة، وبينما يشق طريقهُ عبرها قد ينهار الإنسان أو قد يعبُر”،
مع ذلك، تظلُ “المنطقة أو يظل الحيِّز هذا” غريبًا لمجرد أنه يدعي، بطريقة تعبئةٍ كهذه، حالة الاكتفاء الذاتي المطلق لكونها تلكَ المنطقة كافية لإشهار معالم العالَم، يستخدم تاركوفسكي أيضًا الميل المجازي لعرض التفاصيل فقط من أجل التفاصيل التي كثيرًا ما يتم الإشادة بها كأداة فعّالة للتغلّب على الرمزية السينمائية، ومع ذلكَ، يُمكن أن نقول أنهُ معه قد تغلغل في مستويات أعمق من الفلسفة السينمائية، لا يستطيع المرء الإصرار بما فيهِ الكفاية على أنَّ “منطق الأحلام”، مثل أوسترانيي في نظرية الفيلم الشكلية، مسألة وقت، هذا يعني أنَ الحُلم ليسَ مجرد مسألة “شكل” بالمعنى الخطابي، كما ادّعى رولان بارت ذات مرة من خلال كتابته أنهُ “من المحتمل حتى وجود شكل بلاغي واحد، شائع، على سبيل المثال، في الحلم”، لقد وجدتُ في أفلام تاركوفسكي هناكَ ثمة “توليفات غير متوقعة” تتشكل من العناصر الحقيقية، لها تأثير يُشبه الحلم ليس لأنها تتبع سمة معينّة تشبه عملية النوم وعلاقتها بالحالِم، بَل هي رسميّة، جادة، بلاغية، مثلَ لحظة نُطق الحُكم على سجين، ولكن في ذات الزمن، في ذات النَسق لها طعمُ الحُلم.
ثمة مُصطلح روسي يُسمى “ostranenie”، يُترجم عادةً إلى أنه “تعجيب”، أي إعجاب المؤثَر، استخدمهُ تولستوي كذلكَ حتى يأخذ بيد القارئ خارجَ السياق اللُغوي، إلى خشبة المسرح أو الشعور بقوة بالأثَر، وهو الإصرار على الصوفية اللُّغوية، أي مُخاطبة مَدافن اللا واعي أكثر مما تُخاطب الإدراكات الحسية.
في 15 فبراير 1971، دَلَّ صانع الأفلام الروسي أندريه تاركوفسكي في مذكراته: “لقد شعرتُ بالعَذاب لسنواتٍ عديدة من الخِبرات بأنَ أكثر الاكتشافات غير العادية تنتظرنا في مجال الزمن، نحنُ نعرف القليل عن الزَمن أكثر من أي شيء آخر”.
لَم أجِد خلال سلسلة مُشاهداتي للسينما الروسية، وهي أكثر ما أُشاهده، تعاملهُ معَ ظاهرة”الزَمن”، وليس مُجرد”الزمن” بوصفهِ حالة وقتية مُكوناتها الماضي والحاضر والمُستقبل، بَل الزمن الذي يُعِذب الضمير ولا يتسارع، هو وعيّ الفِعلة الأجَم، هوَ التعبير الكانطي للنَدم، أي أن تكونَ وحيدًا وسطَ تأريخٍ تائه وسط منطقة الكون الفسيح، إنَه الشُغل الشاغل للمخرج طوال حياته المهنية، تم الاستدلال بمفهوم الزمن كثيرًا خصوصًا أنَ كتابيهِ المُتَرجمان “النحت في الزَمن، ويوماته التي حمَلت اسم الزَمن يُحاط بالزَمن” تُرجمت هذهِ الكُتب من الروسية إلى الإنجليزية على يد “Kitty Hunter Blair”، وجدت هناكَ الكثير من الملاحظات والتدوينات الغامضة والمُفكّكة أحياناً بإشارات متكررة إلى أفكار حول الزَمن من هيراكليتس ومونتين وشوبنهاور ودوستويفسكي،
أرسلَ لكَ بعض الشباب مجموعة من الأسئلة، هذهِ أحدها:”إذا كانَ عليك الرد على المُخرجين العظماء اليوم والأمس، فما هي الأسباب التي ستشكر كُل منهم على ما قدموه لكَ من عَطاء؟”، يجيب تاركوفيسكي: بادئ ذي بدءٍ، سأتحدث عن العبقري دوفجينكو ، فيلم “الأرض” لدوفجينكو ، “رائد المونتاج السوفيتي”، ذلكَ الفيلم، حسبَ اعتقادي، صَنع المُعجزات من وجهة نظر التصوير السينمائي الشاعِري، وسأكتفي بذلكَ في وصفه، ثانياً، لقد أبهَرني “بريسون، روبرت بريسون” دائمًا، طوقَني بصوفيته، يبدو ليّ أنهُ المخرج الوحيد في العالم الذي حقق البساطة المُطلقة في السينما، مثلما حَققها باخ في تأليف الموسيقى، كما حَققها في الفن ليوناردو، كما حققها تولستوي ككاتب، نعم كما فهمتهُ، كانَ تولستوي، بالنسبة ليّ يُمثل المُبدِع الخَلّاق إنهُ من المتصوفين، مايكل أنجلو أنطونيوني أيضًا، لأن أنطونيوني ترك انطباعًا حاداً في داخلي من خلال أفلامه، خاصةً مع فيلم “لافينتورا – المُغامرة”، كذلك أودُ أن أتحَدث عن المَخرج الياباني كنجي ميزوغوشي، إنَ أفلامهُ تمتاز بالمَجهود المُطوَل، مُكثفة بالأناقة والحدث الصُوري، أستحضر أيضاً جان فيغو، بوداعته ورَهافته، إنهُ رأس هرم السينما الفرنسية الحالية، هو الذي بدأ الموجة الجديدة الموجودة اليوم ومَن بقيَّ على هذه الموجة لم يتفوق أحدٌ على فيغو، ثمَ، مع كُل توقيرٍ واحترام، أتذكّر دائمًا أفكار سيرغي باراجانوف، وطريقتهُ في التفكير شديدة التناقض والشاعرية، وقدرته على إنعاش الجَمال.
ومع ذلكَ، في حين أنَ المرء لا يجد معالجةً فلسفية شاملة وموحَدة لمفهوم الزَمن في نصوص وملاحظات المُخرج، فإن السينما الخاصة بهِ تكشفُ عن رؤية أصلية ومتّسقة للغاية تتأطر بالزَمن، تُجعَل الطبيعة غير المستعجلة والمطولة لأفلام تاركوفسكي الزَمن “كياناً” محسوساً تقريباً، ولكنهُ يُراوغ بهِ، ويتهرب منهُ في بعض المشاهد، ربما كانَ هذا النوع من الزمن، موجود عندَ الشاعر الروسي أوسيب ماندلستام والذي شَبههُ بـ “شرنقة خجولة، فراشة مُلتَحِفة، مرشوشٌ على جُنحيها طحين”، وهذا المَشهد سنُصادفه أثناء الثواني التي يركضُ عليها “إيفان” على الماء، إنَ استعارة الشاعِر ماندلستام تُقدِم لنا فكرةً مُغايرة لسببين: غير واضحة وأيضاً غريبة، إنها استعارة تستعمل الزَمن كشعور خام يتجانسُ معَ الحَركة المُتَمهِّلة المُنسابة في عروق المَكان، حيث يتلاشى مفهوم الديمومة ولا يخضع لبؤس طبيعة الزَمن، إنَ حالة الركض على الماء تُذكّرني بشيء قاله غوته: “في مُحيط الحياة، وفي عاصفة الفِعل، أصعدُ وأهبِط، أجيءُ وأذهَب، ولادةٌ وحِداد، في البحر الأزلي”، ثمة صفات طاغية بقوة في سينما تاركوفيسكي مرتبطةً بصورة الزمن وهيئته، وهي موجودة في كل فيلم من الأفلام الروائية السَبعة للأُستاذ المُخرج، ومع ذلكَ، فإن حيوية الاستعارات النَشطة والمعطاة تتحقق بحكم طبيعتها: الشرنقة المُهَذبة في أُبَهتها وأجنحة الفراشة المرشوشة بالطَحين، هي صور مكانية ملموسة ذات جمالٍ خلاب، إنَ طيّران الفراشة هو انبعاث الزَمن في الفضاء.
خطاب من فيلم الحنين: أي سلفٍ هذا المُتكلم داخلي، أنا لا أستطيع الرحيل والبَقاء في نفس الوقت، في عقلي وجسدي، منشطرٌ أنا، لستُ فرداً واحداً، اشعر كأنني عدة أمورٍ لا تنتهي، لم يعد هناكَ مرشدونَ عظماء، هذا هوَ الشَر بعينهِ في هذا العَصر، طريق القَلب مطموسٌ بالضياع، يجب علينا الإنصات، لتلكَ الأصوات التي تخلو من المعنى، عقولنا مرتبطة ببعضها كمياه صرف صحي، جُدران المُدن، الإسفلت، والأوراق السعيدة، طنين الحشرات عليهِ أن يدخُل، يجب أن تمتلئ حدقاتنا بالآخرين وكذلكَ آذاننا، مع الأشياء التي هي بداية حلمٍ مختلف تمامًا، أحدهم ليصرُخ هيا، هلموا لبناء الأهرام، ليس المهم أن نفعل أو لا، إننا بحاجة لضَخ الأماني، ونبثهُ في كل أرواحنا، ونُمدّد هذهِ الأرواح، مثلَ شراعٍ لا نهاية له، لو أردتَ للعالم أن يتقدم، علينا أن نتكاتف، علينا دمجُ الكَمال بالنواقص، فما تعنيهِ لكَ كلمة الكَمال؟، إنَ مُقَل البَشر تتنشدُ إلى السوء، حيث ننغمس جميعًا، الحُرية مقيدة، لو لم تكن لديكَ المقدرة على النظر، لتأكل وتنامَ معنا، هذا هوَ الكمال بعينهِ، الذي أتى بنا إلى حافة الانهيار.
يقول إيليا أبي ماضي “المَرءُ وحشٌ فإن تَرَقى”، إنَ الترَقي بالنسبة لإيفان هو الخروج من حالة التغييب، وهذا جُزء من رسالة ترجمتها سابقًا، كتبها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر مدافعاً بها عن فيلم طفولة إيفان الذي واجهَ انتقادات عديدة من قِبل الاشتراكيين العِلميين، يفتتحُ سارتر الرسالة بعزيزي “ماريو آليكتا” وهو عضو مجلس النواب وناقد أدبي وفني،
إيفان مَجنون، هذا الوَحش، هذا البَطل الصغير في الواقع، هو أكثر ضحايا الحرب براءةً وتأثيرًا: هذا الصبي، الذي لا يستطيع المرء التوقف عَن حبه، صنعتهُ الأسباب العَنيفة التي استوعبها كاملةً، قتلهُ النازيون عندما قتلوا والدتهُ وذبحوا سكان قريته، ومع ذلكَ، إلا أنهُ يُكمِل مسيرة العَيش، لكن في مكانٍ آخر، في تلكَ اللحظة التي لا يُمكن علاجها حيث رأى جارهُ يسقط، لقد رأيتُ بنفسي بعض الجزائريين المُصابينَ بالهلاوس، ثُلة كبيرة من الشباب الذين صاغَتهم المذابح، بالنسبة لهم، لم يكُن هناكَ فرق على الإطلاق بين كوابيس حالة اليقظة والكوابيس الليلية، لقد قُتلوا، وكانوا يريدونَ القتل والاعتيادَ على القتل، لقد كانَ تصميمهم البطولي، قبل كُل شيء، فيهِ أجمُ الشنآن والهروب في وجه كربٍ لا يطاق،
إذا قاتلوا، فروا من الرُعب في القتال، حتى جرَّدهم الليل من سلاحهم، وإذا عادوا، أثناء نومهم، إلى هدوءٍ عاصروهُ آنفاً، يأتي ويولدُ ذلكَ الرعب من جديدٍ يستعيدُ الذكرى التي يريدون نسيانها، هذا هو إيفان، وأعتقد أنهُ من الضروري الثناء على تاركوفسكي لأنهُ أظهر جيدًا كيفَ أن هذا الطفل، الذي يتجه سيراً تجاهَ الانتحار، لا فرق عندهُ بين الليل والنهار، على أي حال، فهو لا يعيشُ معنا، ألا أنَ الأفعال والهلاوس في تناسقٍ وثيق مع بعضها، علينا أن نُلاحظ العلاقات التي يُقيمها مع الكبار: إنهُ يعيش وسط العساكر، الضباط، الأشخاص الشجعان، أبطال لكن وفقاً للفيلم هُم “العاديون”، الذين لم يضطروا إلى المعاناة من طفولةٍ مأساوية، فقَد قاموا بإيوائه، والتعاطُف معهُ، وكانوا يريدون بأي ثمن “إرضاخَ سلوكه” ، وفي النهاية، إرساله إلى المدرسة، فيما يبدو، يُمكن للطفل أن يجد، كما في رواية تشيكوف، أبًا بينهم ليحل محل الأب الذي فقدهُ، لكن بعد فوات الأوان: لم يعُد بحاجة إلى الوالدين، ما زالَ الأمر الأكثر عمقًا من فقدان الوالدين هو ذلكَ الرُعب الذي لا يُمكن محوه من المذبحة التي شهدها والتي تجعلهُ يشعر بالوحدة.
ينتهي الأمر بالضُباط بالنَظر إلى الطفل بمزيجٍ من الحنان والذهول وانعدام الثقة المؤلم: فهُم يرون فيه وحشًا مثاليًا للمُستَقبل، جميلاً جدًا وبغيضًا على حدٍ سواء، لدرجة أن العدو قد تحول إلى التطرف، الذي يؤكد نفسه فقط بدوافع قاتلة “السكين ، على سبيل المثال”، أولئكَ الذين لا يستطيعون قطع العلاقات مع الحرب والموت، من يحتاج الآن إلى هذا الكون الشرير للعيش إذن، الذي تحرَّر من الخوف في خضَم المعركة والذي سينجرف في النهاية إلى عُتمةٍ ملؤها الأسى، إيفان يُمثِل الضحية اللَيّنة التي تعرفُ ما هو ضروري لها: الحرب التي خلقته، الدماء، الثأر، ومع ذلكَ، فإن الضُباط يحبونهُ، أما بالنسبة لهُ فكل ما يُمكن قوله هو أنه لا يمقتهم، الحُب بالنسبة له هو طريق مَحظور، مُستَتِر إلى الأبد، كوابيسه وهلاوسه ليسَ لها ما يبررها، لا يتعلق الأمر بالشَجاعة المُهمَلة ولا يتعلق بالمُعايَنات التي تنصبُ في “ذاتية” الطفل: فهي تظل موضوعية تمامًا، وما زلنا نرى إيفان من الخارج، كما هو الحال في المشاهد “الواقعية”، الحقيقة هي أن العالم بأسرهِ بالنسبة لهذا الصبي هو سَراب وأن هذا الفتى والوحش والشهيد في هذا الكون يُمثل هلاوسَ الآخرين.
ولهذا فإن التسلسُل الأول يُعرّفنا بمهارةٍ بليغة على العالَم الحقيقي البَعيد عن الصوابية، الذي هو عالم الصبي معَ الحرب، يصف لنا كُل شيء من المسار الحقيقي للصبي عبر الغابة إلى الموت الزائف لأمهُ “إنها ميتة حقاً، لكن هذا الحدث، مخفيًا بعمقٍ لدرجة أننا لن نعرفه أبدًا، كان مختلفًا: لم يظهر أبدًا بشكلٍ واضح إلا من خلال التدوينات التي تنقلهُ بعيدًا قليلاً عن حَسرته الرهيبة”، الجنون؟ الواقع؟ كلاهما: في الحرب موجودان، كُل الجنود مجانين، هذا الطفل الوحش هو شهادة موضوعية على جنونهم لأنهُ هو الذي ذهب أبعد من ذلك، إنها ليست مسألة تعبيرية ولا رمزية، بل تتعلق بطريقةٍ معينة من السرد تُطالب بها الذات ذاتها، وهو ما استخدمه الشاعر الشاب فوزنسينسكي ليطلق عليه “السريالية الاشتراكية”، كانَ من الضروري التعمق في نوايا المؤلف لفهم المعنى ذاته للموضوع: الحرب تقتل أولئك الذين يصنعونها حتى لو نجوا منها، وبمعنى أكثر عمقًا: التاريخ، في نفس الحركة، يطالب بهؤلاء الأبطال، ويخلقهم ويدمرهم من خلال جعلهم غير قادرين على العيش دون معاناة في المجتمع الذي ساهموا في تشكيله. “نهاية نقد سارتر”.
سَيبقى المُخرج آندريه تاركوفسكي أحَد أشكال السينما نبالةً، واحد من أروع صانعي الأفلام المليئة للغاية بالرومانطيقية، والخيبة الميتافيزيقية، كأنهُ أحد أولئكَ الذينَ استولى عليهم الشَغف، بصحبة ليوناردو دا فينشي، كارافاجيو، ألكسندر بوشكين، تولستوي، أو رسامي الأيقونات البيزنطينيينَ كآندريه روبليف، مثل يوهان فولفغانغ فون غوته، إنَ تاركوفسكي سَحرنا بفتنته، في أفلامه كُلها يتحدثُ إلى ما لا نهاية عن الحقيقة، مروراً بالروح، ذاهباً للإيمان، يتحدث في المسيحية، عن الأفلاطونية، والأفلاطونية الحديثة، تَتكرّر بعض المُنَمنمات المرئية في جميع أفلامه تقريباً: صوت ركض الخيول والكلاب ورشقات المطر والحليب المسكوب والمرايا ومظاهر الطيران أو الارتفاع والظواهر التخاطرية، هذهِ الصفة الباشلارية، كذلك تزخر أعمالهُ باستعارات السيرة الذاتية للمشاهد أو الذكريات من الطفولة: كوكبة ساحرة بالأسرة من الأم والابن والابنة والأب الغائب الذي يحدث في طفولة إيفان والمرآة، على سبيل المثال، أو مُلصقات المنزل والشَمعة في خَلد النهار في الحنين إلى الماضي، مع منازل برونزية الأخشاب، و الحقول المُصابة بالرَعشات الرياحية، والبُحيرات الدافئة، لَقد استخدمَ تاركوفسكي هذه المُنَمنمات السينمائية بطرق متنوعة لإنشاء شبكة من المعالم المألوفة والإحياء الشاعري بطريقةٍ مُريحة، ثمةَ تقارب في التجربة الشخصية مع الموضوعات التي كان يُعالجها، يستخدم الجرس كبشارة للإنتصار على العقبات الفنية أو الأخلاقية كما في روبلييف، وتتحدث بعض زخارفه بانتظام مهووس تقريباً، تصنعها الحَركات المُتأنية،
إعلان
