مراجعة لكتاب “نظرية المعرفة” للدكتور فؤاد زكريا
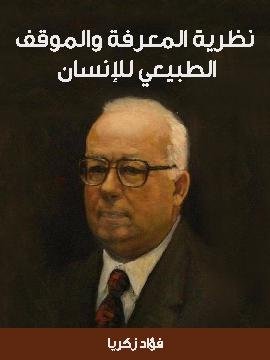
قبل أن أتطرق لأفكار كتابِ نظرية المعرفة أحب أن أضعَ يدَ القارئ على الموضع الذي نقف عليه في الفلسفة الآن؛ ولذلك أحب أن أوضح نقطتين:
أولًا: للفلسفة ثلاثة مباحثَ رئيسية:
1- الأنطولوجي أو الوجود.
2- الأبستمولوجي أو المعرفة.
3- الأكسولوجي أو القيم والأخلاق.
ثانيًا: يناقش كتاب نظرية المعرفة مبحث الأبستمولوجي، ولكي نفهم أكثر يجب أن نعرف أن داخل هذا المبحث مدرستَيْن أساسيتَيْن يتجادلان وهما المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية.
إذن يتبقى أن نذكرَ أن الكتاب هنا يحاولُ دحضَ النظريات المثالية وتأييدَ الموقف الطبيعيِّ أو الواقعية الساذجة للرجل العادي، ويؤيد موقفَه المعرفيَّ ضد المواقف المعرفية لفلاسفة المثالية البعيدة عن الواقع والمنطق.
مؤلف الكتاب غنيٌّ عن التعريف، فهو الدكتور فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس وجامعة الكويت وأحد مؤسسي سلسلة عالم المعرفة بالكويت.
يبدأ الكاتب بنقد الفلاسفة من ناحية ترحيبهم دائمًا بأي شيءٍ غريبٍ يخالف أفكارَ البشرِ التلقائية مما يدفعهم للتعالي على البشر والسخرية منهم. ويختص بالهجوم الفلاسفةَ المثاليِّين وخصوصًا آراءهم التي تتعلقُ بعدم وجودِ العالم الخارجيِّ وفيما يتعلق أيضًا بالميتافيزيقيا.
ويوضح تباينَ الموقف المعرفيِّ بين الفلاسفة وغير الفلاسفة؛ فيرى أنَّ الصنفَ الأولَ لهم مجالهم الخاص يترفعون فيه عن وجهة نظر العامة ويعُدُّون رفضَها أولَ شرطٍ للسلوك إلى ميدان الفلسفة، وأن الآخرين يدهشون للآراء النظرية الميتافيزيقية لدى الفلاسفة، ولا يأخذون بواحدٍ منها في حياتهم المألوفة، ويظل كلٌّ من الطرفين متمسكًا بموقفه دون أيِّ محاولةٍ للفهم.
بعد ذلك يتوجه بالهجوم على الفلاسفة ويلومهم لرفضهم موقفَ الذهن المعتاد من القضايا المسَلَّم بصحتها ولاستخدام مصطلحاتٍ خاصةٍ لا يعرفها غيرهم وكأنها من الأسرار، ويقارن بين الفيلسوف المثاليِّ وعالم الجيولوجيا في تعاملهما مع الواقع، فحين نجد أن المثاليين يهاجمون “الواقعية الساذجة” فإن الجيولوجيين يتعاملون معها وينتجون منها علما.
ويطلب من الفلاسفة المثاليين تفسيرَ عدم انتشارِ أفكارهم الغريبة، وحتى تفسير تعاملهم مع الحياة بنظرة الإنسان العاديِّ خارج ساعات تفلسفهم. ثم يوجه نصيحةً لهؤلاء الفلاسفة بالخروج من الموقف الاحترافيِّ للفلسفة الذي ضربتْهُ حول نفسها والتحلي بالشجاعة لربط آرائها مع “الإنسان”، وإلا فستظلُّ إلى الأبد “مهنة” ضيقة لا تلقى استجابةً إلا من ذلك النفر القليل الذي احترفها.
الموقف الطبيعي والعلم:
أوضح ما يميز الموقف الطبيعي هو أنه لا يضع مشكلةَ وجود العالم الخارجي موضع التساؤل، بل يطرح جانباً التفكير في احتمال عدم وجود العالم وما فيه من “أشياء”، ومن الخطأ وصف هذا الموقف بالسذاجة؛ لأن كل إنسان -حتى الفلاسفة والعلماء- يشارك في هذا الموقف في تصرفاته العملية، بل نضيف أن الموقف المضاد قد يكون هو المفرط في التحليل والنقد بلا جدوى.
وأغلب الظن أن الموقف الطبيعي قد وُصِف بالسذاجة نتيجةً لتلك الحالات التي يبدو فيها أن التقدمَ العلميَّ البشريَّ قد حتم الخروج عنه، مثل فكرة دوران الأرض حول الشمس لا العكس، ومثل اكتشاف الأجسام الميكروسكوبية.
إعلان
ولكن حتى لو وُجِدَت تجارب أو كشوفٌ علميةٌ تبدو مخالفةً للموقف الطبيعي فإن هذا يرجع إلى اختلاف الموقف الطبيعي والعلمي، واختلاف الغرض من تجربة الإنسان في كل منهما؛ فليس من مهمة هذا الموقف أن يتحدث عن الإلكترونيات والذرات، وليست هذه وظيفته، فالموقف الطبيعيُّ عمليٌّ في المحل الأول وليس موقفًا تحليليًّا أو نقديًّا، فمثلًا لا نجد أن أحدًا تعاملَ مع النار من الناحية العملية على أنها فكرةٌ ذاتيةٌ في رأسه. ولقد حلل “لوك” فكرة ارتباط الموقف الطبيعي بقدرة الإنسان على السلوك العملي تحليلًا رائعًا، وفي أحد هذه النصوص يقول: “إن حواسنا تُمكِّنُنا من معرفة الأشياء وتمييزها وفحصها بحيث يتسنى لنا تطبيقها في استعمالاتنا.. ولو تغيرت حواسنا وأصبحت أسرع وأَحدّ؛ لتغيرت مظاهرُ الأشياء ونظمُها الخارجية في نظرنا تغيرًا تامًّا، ولغدت -كما أظن- غيرَ متماشيةٍ مع وجودنا، فلو كانت حاسةُ سمعِنا أشدَّ ألف مرةٍ مما هي عليه لسمعنا ضجيجًا دائمًا يزعجنا، ولو كانت حاسةُ الإبصار أحدَّ ألف مرةٍ لما تحمَّلنا وهج الشمس، علاوةً على أن هذه التغيرات لن تعود بالنفع الكبير؛ فإن هذا الإبصارَ الحادَّ لن يفيده في الذهاب للسوق والتعامل فيه”.
إذن فللموقف الطبيعيِّ مجالُه الضروري وهو المجال العمليُّ الحيويُّ، وحواسنا -مهما كانت- تقدم إلينا صورةً للعالم لا نستطيع أن نرفضها في سلوكنا العملي، وإلا أدى ذلك إلى إلحاق أبلغِ الأضرار بحياتنا ذاتها.
حقًّا إن نصيب هذه الحواس يتفاوت نجاحًا أو فشلًا حين تقتحم ميادين العالم الأخرى، كميدان تفسير الظواهر أو فهمها، ولكنها في الميدان العضويِّ العمليِّ لا مفر منها، وتؤدي وظيفتها الكاملة فيه، ومن العبث الاعتراض على قدرتها في هذا الميدان، ولذلك من العبث أن ننقد الصورة التي نكوِّنها للعالم في موقفنا الطبيعي؛ لاختلافها عن الصورة العلمية للعالم (الميكروسكوبية – الماكروسكوبية)؛ إذ إنَّ كلًّا من الصورتين تؤدي وظيفةً مختلفةً تمامًا عن وظيفة الأخرى، وتسري على مجالٍ مخالفٍ تمامًا لمجالها، ولهذا لا يجب أن نخلط بين الموقف الطبيعي والموقف العلمي.
الفلسفة والموقف الطبيعي:
ناقشنا علاقة الموقف الطبيعي بالموقف العلمي، فأين تقع الفلسفة بين هذين الموقفين؟
بدايةً لا تتوافر لدى الفيلسوف معداتُ العالم ومنهجه، وإنما لا يملك الفيلسوف إلا “دقة التفكير” وهو لا يعدو أن يكون قدرةَ الفيلسوف على اتباع قواعد الاستدلال دون خطأ، وهذا ما يجعل منهج الفلسفة مخالفًا للمنهج العلمي؛ لأن الأخير ينمو بطريقةٍ تراكميةٍ بينما لا تزال أكثر الموضوعات الفلسفية الأولية موضوعًا للجدل حتى اليوم. إذن فليست لدى الفيلسوف “وسائل”؛ لذلك تبدأ الفلسفة بالفعل من موقفنا الطبيعي، والموضوعات التي يبحثها الفيلسوف هي موضوعات الموقف الطبيعي، وقد يقال إن العالَم أيضًا يبدأ من الموقف الطبيعي، ولكن الواقع أنه سرعان ما يتجاوزها بفضل منهجه ومعداته. أما الفيلسوف فيظل للنهاية في حدود هذه الموضوعات، وبالتالي لا يختلف الفيلسوف عن الموقف الطبيعي إلا بقوى قواعدِ الاستدلال فقط.
ولشرح الكلام السابق نضرب أمثلةً لطريقة تفكير بعض الفلاسفة: فحين يشرح باركلي فكرة “وجود الشيء هو كونه مُدرَكًا” يلجأ دائمًا لهذه الأمثلة: “إنني حين أقول عن المنضدة التي أكتب عليها أنها موجودةٌ أعني أنني أراها وأحسها، إذا غادرت غرفتي فسأقول إنها موجودة، بمعنى أنني لو وجدت في غرفتي فسأدركها، أو أن روحًا أخرى معينة تدركها بالفعل”.
وحين يناقش هيوم اعتقادنا بوجود فئةٍ معينةٍ من الانطباعات وجودًا مستمرًا يضرب أمثلة كهذه: “تلك الجبال والبيوت والأشجار التي تقع عليها الآن أنظاري قد بدت لي دائمًا في نفس النظام، وعندما لا أعاود رؤيتها بإغماض عيني أو إدارة رأسي فسرعان ما أجدها تعود إلي دون أدنى تغيير”، إذن مما سبق نجد أن موضوع تفكير الفيلسوف هو موضوعات إدراكنا المعتاد، وكل ما يفعله هو أن يقدمَ لنا تحليلًا يستخدم فيه براعته المنطقية.
الشك في الحواس:
يشك الفيلسوفُ المثاليُّ في قدرة الحواس على نقل موضوعاتٍ خارجيةٍ لنا، ونجد أن الشكَّ المثاليَّ هناك ظاهرةٌ واضحةٌ جدًّا، وهي أنه يعتمد في كل الأحوال تقريبًا على “حالات الشذوذ “، ومن خلال الشك في البعض يُبَرَّر الشكُّ في الكل، فمثلًا نجد في تفنيد أفلاطون للنظرية القائلة إن الإدراكَ الحسيَّ هو مصدرُ المعرفة أنه يستشهد بما يحدث في الأحلام والأمراض وحالات الجنون وفي مختلف أوهام السمع والإبصار أو غيرهما من الحواس، وعندما ننتقل لهيوم فإنه يضرب مثلًا بأنه عندما نضغط بأصبعنا إحدى عينينا نرى الأشياءَ مزدوجةً وبالتالي تتوقف إدراكاتنا على أعضائنا، ومن هذا يُستَنْتج أن إدراكاتِنا الحية ليس لها أيُّ وجودٍ متميز مستقل.
ويعرض شوبنهور براهينَ مشابهةً ليدلِّلَ على أن العقل لا الحس له الدور الأكبر في عملية الإدراك مثل الأشخاص الذين وُلِدوا ضريرين ثم أُجرِيَتْ لهم عملياتٌ جراحية، والرؤية المزدوجة، وآلة الصور المجسمة stereoscope، وطبعًا لا يستطيع أحدٌ أن يقول إن هذا النوع من الأمثلة هو النوع الوحيد الذي يضربه المثاليُّون للتشكيك في الحواس، ولكن لا جدال في أنه يمثل عنصرًا قويًّا من عناصر النقد المثالي للحواس.
للرد على حججهم نذكر ثلاثَ نقاط:
أولًا: نحن عندما نقول في موقفنا الطبيعي أن الحواس تنقل إلينا معرفةً بالعالم الخارجي فنحن نقصد بلا شكٍّ حواسَ الإنسانِ السويِّ السليم الذي اكتملت حواسه الخمسة ويدرك في حالةٍ طبيعيةٍ لا يشوبها مرضٌ ولا شذوذ؛ فلماذا يرهق الفلاسفة المثاليون أنفسهم بالبحث في الحالات الشاذة؟!
فيتحدث ديكارت عن حالات الهلوسة، وباركلي عن المولود الأعمى، وشبنهور عن ازدواج الرؤية، وهيوم عن الجنون حتى ليكاد ميدان نظرية المعرفة يتحول إلى “مصحة” كل نزلائها من الشواذ والمنحرفين والمجانين، ويظل أطباؤهم من الفلاسفة يرعونهم من كل حدب، لا لكي يعالجوهم بل لكي يخيفوا بهم الأصحاء. إن المبدأ الذي يعتمد عليه المثاليون في هذه الحالة -وهو مبدأ “ما يصح على الجزء يصح على الكل”- هو مبدأٌ لا يكون صحيحًا إلا إذا كان الجزء والكل مشتركين في الكيف.
ثانيًا: يوجد وجهٌ آخر من أخطاء الشك المثالي للحواس، فكما يعتمد هذا الشكُّ كثيرًا على حالات الشذوذ فإنه يعتمد أيضًا على حالات الفصل بين الحواس، مثال: العصا التي تبدو منكسرةً في الماء أو مثال السراب أو البرج الذي يبدو مستديرًا بينما هو في حقيقته مربع… إلخ.
هذه الأمثلة كلها تفترض نوعًا من الانفصال بين الحواس، وتعتمد على حاسةٍ واحدةٍ هي حاسة الإبصار وحدها -لبدت العصا منكسرة-، والرد البسيط على ذلك هو أننا لو استخدمنا بقية حواسنا -ولاسيما اللمس- في كل الحالات التي يتحدث عنها المثاليون لتمكنت الحواس “وحدها” من تصحيح أخطاء بعضها البعض.
ثالثًا: وأخيرًا فمن الواجب أن نشير إلى ذلك الرأي الذي توصل إليه كثيرٌ من الفلاسفة التقليديِّين، والقائل إن الحواس ذاتها لا تُخطِئ، إنما يكون الخطأ في حكمنا العقليِّ على ما تنقله إلينا النتائج التي نستدل عليها منه؛ فمن الصواب إذن أن نقول إن الحواس لا تخطئ، لا لأن حكمها دائمًا صحيح، بل لأنها لا تحكم على الإطلاق، وبالتالي يتداخل الحكم العقلي مع الحواس، وأي انتقادٍ للحواس يوازيه مماثلٌ ينبغي توجيهُه إلى الذهن نفسه.
صفات الأشياء موضوعية أم ذاتية:
بعد أن يُشَكِّك التفكيرُ المثاليُّ في الحواس، تكون الخطوةُ الطبيعيةُ التالية هي التشكيك فيما تنقله إلينا الحواس، وهنا يثار السؤال: هل الموضوعات المحسوسة موضوعية أم ذاتية؟
بالطبع يعتقد المثاليُّ أن كل ما نظنه موضوعيًّا هو في واقع الأمر “ذاتي” بمعنى ما، ولقد اتضحت معالمُ الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه المثالي منذ اللحظة التي أوضح فيها ديكارت فكرته عن التفرقة بين نوعين من الكيفيات في الأشياء: أحدهما صادر عن الذات، والآخر مستقل عنها، وبالتالي توجد صفاتٌ مثل اللون والنعومة والخشونة والطعم تنتمي للذات، ومن الطبيعي أن يكون التطورُ المنطقيُّ للمذهب بعد ذلك هو زيادة عدد تلك الصفات التي ترد إلى الذات بالتدريج، حتى تصبح كلها ذاتية في آخر الأمر.
وللرد على هذه الحجة يجب أن نوضحَ أن هناك خلطًا بين الموقف المعتاد والموقف العلمي التفسيري، (ويجب أن نشير إلى أن هذه الحجة التي تعتمد على ذاتية الكيفيات إلا بعد وصول العلم إلى مرحلة معينة من التقدم، وهي التي أمكن فيها تحليل الألوان والأصوات لموجات وذبذبات.) وبناءً على ذلك يعرض المثاليُّ فكرتَه بقوله: “إن هذا الحائط الذي يبدو لي أبيض ليس في “حقيقته” أبيض”، ويبرر ذلك بالتحليل العلمي للون الأبيض، سواء من ناحية طبيعة الموجات الضوئية أو كيفية التقاط حدقة العين لها، وهو يقصد أن يطلعنا على حقيقةٍ مختلفةٍ عما تطلعنا عليه الحواس في موقفنا المعتاد.
ولكن كما ذكرنا فهناك خلطٌ بين الموقف المعتاد والموقف العلمي؛ إذ إننا عندما نقول إن الحائطَ أبيض نقصد أنه في مستوى الإدراك المعتاد أبيض، وهو بالفعل لا يمكن إلا أن يكون كذلك في هذه الحدود.
ننتقل لنقطة أخرى ندافع فيها عن تصور الذهن المعتاد للعالم الخارجي، يقول الفيلسوف المثالي: إن “وجود الشيء هو كونه مُدرَكًا”، فنجد باركلي يؤكد أن المنضدة الموجودة في حجرةٍ مغلقةٍ لا وجود لها بالنسبة إليَّ إلا إذا أدركتُها، ولكن ينبغي تكملة هذا التدليل بالقول إنني لا أدركها إلا إذا انتقلت إلى الحجرة ذاتها، أي أن هناك شروطًا معينةً يخضع لها إمكان إدراك الشيء، وهي شروطٌ لا أستطيع التحكم فيها ذاتيًا، بل ينبغي أن أقبلَها كلَّها كما هي؛ لأنها غيرُ متوقفةٍ على إرادتي.
وهكذا يبدو أنه إذا كانت فكرة الوجود تحيلنا إلى فكرة الإدراك فإن فكرةَ الإدراك بما تفرضه من شروط “غير متوقفة على الذات” تحيلنا ثانيةً إلى فكرة الوجود، أما من الناحية العملية وهي أساسيةٌ في موقفنا الطبيعي، فإن فكرة “وجود الشيء هو كونه مُدركًا” تؤدي إلى العجز التام عن التصرف في هذا الميدان، فجميع مواقفنا العملية مبنيةٌ على عكسها، ومجرد استخدامنا لملكات التذكر والتوقع والتخيل يعني أننا نخالف هذه الفكرة ولا نقول بوجود هويةٍ بين وجود الشيء وكونه مُدركًا، فإذا لم يكن في إمكاننا القول بوجود الأشياء “دون” كونها مدركة لاستحال حديثُنا عما يجري في بلدٍ آخر، أو في الشارع المجاور، أو ما سيقع إذا حدث كذا…إلخ، ولما أمكننا أن نتقدم عمليًا خطوة واحدة.
ونستطيع أن نقول: إن التقدم الأكبر الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان يتمثل في تجاوز فكرة “وجود الشيء هو كونه مدركا”؛ فالحيوان -على الأرجح- هو الكائن الذي يؤمن بهذه الفكرة ويطبقها بحذافيرها؛ لأنه لا يعرف كيف يتذكر أو يتوقع بوضوح، وكيف يربط الماضي بالحاضر، ولأن كل ما يمر به جديد منفصل مفكك.
نجد مما سبق أن المثاليين في الوقت الذي يبذلون فيه جهودًا جمة من أجل “رد” العالم الخارجي إلى الذات على نحو ما، فإنهم يصمتون تمامًا فيما يتعلق بأصل هذه “الذات” نفسها، فهم يبدون روحًا نقديةً شكَّاكةً بالنسبة إلى طرفٍ واحدٍ هو الطرف الموضوعي، أما الطرف الثاني فيأخذونه على علَّاتِه، وينسبون إليه ما شاؤوا من القدرات دون أي محاولةٍ لتعليل أصل هذه القدرات.
كما يجب أن نشير أننا لم نجد مثاليًّا واحدًا يعامل الأشياء كما لو كانت ذاتيةً أو ذهنيةً بالفعل، أي: يستخرج النتائج العملية المتوقعة من التفكير النظري، ويتصرف على أساسها، ونجدهم أنهم على عكس ذلك يتعاملون مع العالم من وجهة نظر “الواقعية الساذجة” التي يعدون الخروج عنها أول شرط التفلسف.
إعلان
