الكفاءة الوهمية: كيف يتحور فيروس الاستبداد؟ | عنان نوارة
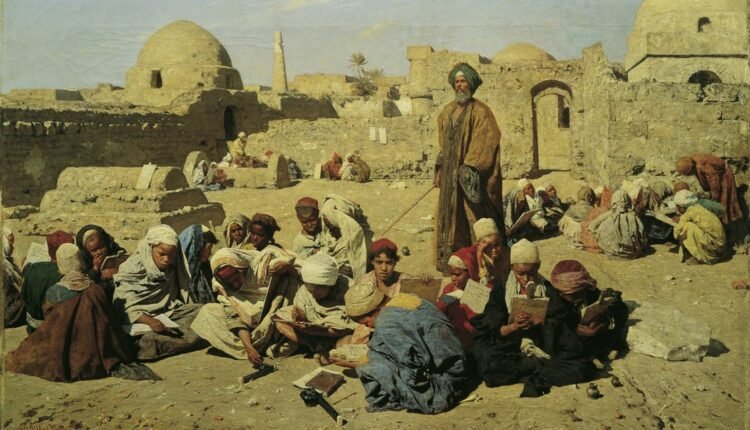
ظهرت أولى ثمرات النضال الديمقراطي في أوروبا في عصر النهضة في الحصول على حقّ الاقتراع، والذي مثل الخطوة الأولى في التخلّص من الوصاية السياسية الأبوية -بصرف النظر عن الجهة الواصية- وانتزاع الكفاءة الذاتية للأفراد (human agency). وقد وصف عالم الاجتماع السويدي برجون فيتروك انتزاع الكفاءة الذاتية للأفراد بأنه إحدى العلامات المُمَيِّزَة للحداثة.
تشير الكفاءة الذاتية إلى القدرة الواعية للأفراد على تحديد المعاني وصناعتها في بيئتهم المحيطة، وعكس ذلك على واقعهم. والبيئة في هذا السياق تأتي بالمعنى الواسع المتجاوز للبيئة في بعدها المادي ليشمل الأبعاد السياسية، والاجتماعية، والثقافية، إلخ… ومن ثم يتضح أن جوهر النضال الديمقراطي تمثل في الخروج من قيد فرض المعنى إلى سعة خلق المعنى؛ انطلاقًا من سيادة الفرد لذاته، ومن ثم عكس صدى ذلك في مأسسة واقعٍ من هذا المعنى.
وقد بدأت عملية تحقيق الكفاءة الذاتية في السياق الأوروبي بالإصلاح البروتستانتي الذي قاده مارتن لوثر. وتُشتَق لفظة البروتستانت من لفظة «protest» أي احتجاج؛ لتمثل احتجاجًا على السلطة الأبوية الكاثوليكية التي توسطت العلاقة بين الرب والعامة واحتكرت حقّ تفسير الكتاب المقدّس. ومن ثم عنى ذلك ضمنيًا الاعتراف بالكفاءة الذاتية للعامة بما يمكنهم من الاتصال المباشر بالإله وقراءة كتابه. فأصبح العقل أساسًا لهذا الاعتراف. وامتد ذلك الاعتراف فيما بعد للمجال السياسي.
وبالمقارنة مع السياق الإسلامي، يمكن أن نجد مرادفًا لمفهوم الكفاءة الذاتية في مفهومي «الاستخلاف والاستعمار»، ومنه ما نجده في القرآن «وهو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها». ودلالة الشبه هي أنّ الإنسان المُستَخلَف في الأرض، المُستَعمَر فيها، إنما هو بالضرورة صاحب قدرةٍ على تحديد المعنى وصناعته فيما هو مُستَخلَفٌ فيه. ولكن هذا الاستخلاف مُقَيَّدٌ بحدود الشرع -أي الله- الذي سخّر له الأرض ومكّْن له فيها. وعلى الرغم من ذلك، يُلاحَظ أنّ انتقال هذه الكفاءة الذاتية للمجال السياسي جاء متعثّرًا؛ إذ يمتلئ الفكر السياسي الإسلامي بجدلٍ حول طبيعة نظام الحكم جوهره اختلاف النظرة إلى الطبيعة الإنسانية وقدرة الأفراد على القيام بأمورهم. بعبارةٍ أخرى، بوسعنا القول أنّ الخلاف حول طبيعة نظام الحكم في التاريخ الإسلامي إنما مثّل خلافًا حول انتقال الكفاءة الذاتية -أو الاستخلاف والاستعمار- من مجال الإعمار المادي/الاقتصادي إلى المجال السياسي.
وفي العصر الحديث، تكثر الخطابات الناقمة على الاستبداد النازع للكفاءة الذاتية. وكثيرًا ما يتم توصيف ذلك بأنه محاربةٌ «للآلهة الأرضية»؛ أولئك الأفراد الذين ينصبون أنفسهم آلهةً محتكرةً للمعنى. ولكن، هل توجد آلهةٌ أرضيةٌ غير السلطات السياسية الاستبدادية؟ إنّ الإجابة على هذا السؤال إنما تستلزم تعريف الاستبداد ابتداءً.
إعلان
لا أجد تعريفًا للاستبداد أدقّ من تعريف علي شريعتي الذي شرح الاستبداد في ديناميته لا في توصيفه كظاهرة. ويظهر ذلك ابتداءً من خلال صكّه لمصطلح «الاستحمار» ليكون هو المرادف للاستبداد، وفي ذلك دلالةٌ عميقةٌ على التبعية العمياء؛ إذ لو امتلك التابع درايةً بموقعة من الواقع لما كان تابعًا. بعبارةٍ أخرى؛ فإنّ المستبِد لا يمتلك سلطته إلا من قابلية المُستَبَد به على أن يكون تابعًا. ولا يتباين في ذلك الأفراد على أساس كفاءتهم العلمية؛ إذ أنّ “الكفاءة العلمية… كفاءةٌ كاذبةٌ وشبعٌ كاذبٌ ونوعٌ من الغش الكبير”، وذلك إن لم تقترن بـ «الدراية الشخصية» ومعرفة المجتمع والزمان. وفي توصيف عملية الاستبداد تمثيلٌ عميقٌ على ذلك من تشبيهها بالاستحمار؛ إذ على الرغم من أنّ الحمار يُعَدّ من أذكى الحيوانات، إلّا أنه معدوم الإرادة الذاتية.
ويقوم شريعتي بتعريف الاستحمار من خلال تعريف الأضداد، أي بتعريف النباهة. والنباهة نباهتان: نباهةٌ فردية، ونباهةٌ جماعية. والنباهة الفردية هي أن يكون الفرد «عارفًا، ذا إرادة، مختارًا، خالقًا، مغيرًا»، أي أنّ سعيه وسلوكه مقترنٌ بوعيٍ بغايته الذاتية وخلقة -أو مشاركته في تحقيق- المعنى الذي يؤمن به. ومن ثم فإنّ شريعتي يجد أن شعارًا كشعار «العلم من أجل العلم» إنما هو شعارٌ مُستَحمِر يعمل على استنفاد قدرات الأفراد ضمن تحقيق المكاسب الرأسمالية، وذلك مع تحويل الغرب العلم إلى سلعة. فعدو الإنسان هو كل مستلبٍ لنباهته وإن أبدلها علمًا. وكذلك الدين ما دام يؤخذ «وراثةً وسنةً واعتيادًا من غير علمٍ وبصيرة». أي أنّ أخذ الدين في صورة ممارساتٍ دينيةٍ مع قطع الصلة بين تلك الممارسات والغايات التي وضعها الله لها يحول الدين إلى دينٍ استبدادي. وفي تلك الحالة، يتحوّر الدين عن أصله، فيصبح ما يُطلق عليه «دينًا أخرويًا»، فيسلب الأفراد نبهاتهم ويعدم مسئولياتهم وفاعليتهم الفردية والاجتماعية.
أما عن النباهة الجماعية، والتي سماها بنباهة الأنبياء، فهي الوعي بالزمان والمكان الذي يُمكِّن الفرد من الشعور بـ «مرحلة المصير التاريخي والاجتماعي للمجتمع، وعلاقته بالمجتمع والمقدرات الراهنة بالنسبة إليه وإلى مجتمعه… وشعوره بمسئوليته كرائدٍ وقائدٍ في الطليعة». ويمكن القول أنّ النباهة الجماعية هي الحضور الواعي للفرد في المجتمع الذي ينتمي إليه، مع حمله لخبرات هذا المجتمع التاريخية مما يمكنه أن يكون فاعلًا. ويظهر في ذلك الحريات الفردية كأداةٍ للاستحمار؛ إذ تُقصِر انشغال الأفراد على منظوراتٍ ذاتيةٍ ضيقةٍ تؤطرها حدود شهواتهم، مع فك ارتباطاتهم الاجتماعية.
ومن ثم جاء تعريف شريعتي للاستحمار بأنه: «تزييف ذهن الإنسان، ونباهته، وشعوره، وحَرْف مساره عن النباهة الإنسانية والنباهة الاجتماعية». وأشار شريعتي لتعدّد وتنوّع أدوات الاستحمار؛ أن تُنتخب كل أداةٍ على حسب طبيعة الفرد المُراد استحماره. ومن ثم، يحرّك المستَحمِرون -المستبدون الراكبون- الفرد مُعدِمين مقاصده وميوله الذاتية. وفي ذلك يصبح أي شيءٍ قابلاً للتسخير والتكييف ليصبح أداةً للممارسة الاستبدادية؛ إذ أنّ «كل أداةٍ أعددتها كي أنفذ إرادتي دون أن أشعر بقصدي هي [أداة] استحمار».
في هذا الصدد، فإنّ الاكتفاء بتوصيف ظاهرةٍ ما بأنها استحمارٌ هو قصورٌ يجدر تجاوزه بفهم ديناميات عمل الاستحمار. ويرتكز الاستحمار على ركيزتين: الأولى هي التجهيل، أي سلب الذات إدراكها ووعيها الذاتي والاجتماعي. والأخرى هي الإلهاء، والذي هو مضمونه تجزئةٌ وتذريةٌ للمجتمع من خلال تقديم الحقوق الجزئية على نظيرتها الكلية.
إنّ مدّ الخط الزمني من وقت شريعتي إلى الآن يُظهِر تحوّراتٍ عدةٍ في صور الاستحمار. ونضرب في ذلك مثالًا بالممارسات التي استحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي التي خلقت عدة ظواهرٍ سلبيةٍ أبرزها الفردية الرقمية أو السعي لجذب الانتباه، والتي يسميها هابرماس «attention slavery – الركض خلف التقدير». وفي سبيل الحصول على هذا الانتباه فإنّ الأفراد قد يقومون بأي شيء، ولا أدلّ على ذلك من انتشار فيديوهات عن العلاقات العائلية/ علاقات الصداقة/ علاقات الجيرة السيئة، والرقصات المخلة، والأزياء الشاذة، والترندات، إلخ… في سبيل جذب الانتباه. فأصبح الإعجاب والتعليق مستحمران للأفراد، إذ أنهما الحاكمان لسلوكهم معدوم الغاية.
إنّ سعي الفرد لانتزاع كفاءته الذاتية ينطلق من هذا الفهم، أي فهم ديناميات عمل الاستبداد؛ ليكوِّن مناعةً ضد الصور المختلفة التي يتحور الاستبداد على شاكلتها.
إعلان
