أكان لا بد يا ليلي أن تضيئي النور؟
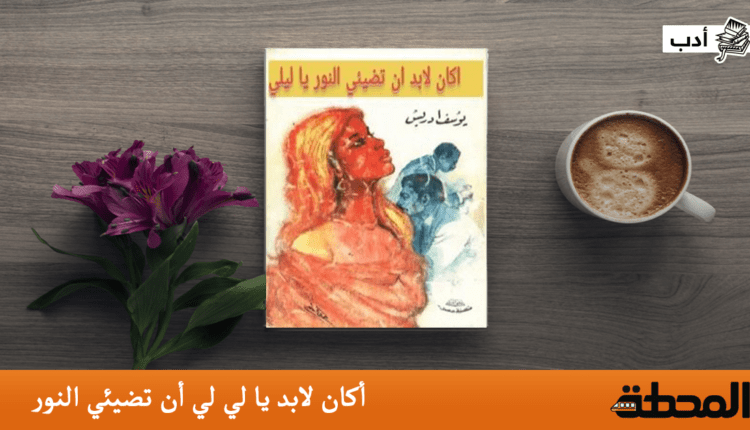
قيل قديمًا أن الأفكار العظيمة حتى تستطيع الظهور بين الناس، لا بد لها أن تتخفى في أقنعة هزليّة مضحكة، وهنا تأتي خطورة سقطات اللسان في شكل نكات بهدف الإضحاك، حيث يتهاوى تحت أقدام الضحك، كل وقارٍ مصطنع وكل هيبة كاذبة، ولعل قصة يوسف إدريس: “أكان لا بد يا ليلي أن تضيئي النور” النكتة الطرفة الهازلة هذه، استطاعت القبض على الحقيقة في أكثر تجلياتها وقارًا ومهابة. حيث يتمثل في الطرفة/ النكتة، وتحت قناعها اللاهي الفاني الوقتي الخفيف الزائل، صراع الأرض والسماء والفانون والخالدون.
إن ليلي تمثل الإنسان في أحسن صورة، ولا شك فهي الجمال في شموخه وقوته، وغرفتها العالية منارة موازية لمنارة الجامع، تصعد العيون إليها، ولا تهبط هي إلى أحد، تضيء ليل الباطنيّة وبيوتها الهالكة وبشرها الغائبون في مخدر الحشيش.
وإلى جحيم الباطنية أتى من الريف الشيخ الشاب عبد العال -جميل الصوت- لمناداة الجمال في القلوب، لكن تنهال عليه صور الحياة الهازلة، بكل ما فيها من إخفاق وحرمان وانهيار وانحطاط، ويتكشف له الجحيم المستعر، فيقاوم ويجاهد ويتعلم الكف عن الخجل، وأن ينظر إلى الجحيم وصوره القبيحة حتى يراه جيدًا: هكذا راح، يقرأ القرآن في المقاهي وسط الحشاشين، وينظر إلى النساء في شوارع الباطنية اللاتي يحدثنه عن مشاكلهن المحرجة المكشوفة العارية، وينظر أيضا إلي ليلي التي قابلته مرة في الشارع، وطلبت أن يعطيها دروسًا في القرآن بغرفتها لكنه رفض بحسم، مقاومًا صعقة جمالها، ذلك أن ليلي تجمع ما بين الله والشيطان في جسدها الشاهق الهائل الوافر، من أب إنجليزي وأم مصرية جامعةً الشرق والغرب معًا، وراح الشيخ الشاب كل فجر على مئذنته، وأمام نافذة ليلي المضاءة المفتوحة، يستنجد بالله ويناديه في الليل: يارب. بكل تلويناتها وبجمال وعذوبة صوته وألمه. وكأنه في ذات الوقت ينادي ليلي، التي يراها تتقلب شبه عارية، وعارية في سريرها كآلهة تلعب فوق السحب.
ربما من الضروري لفت النظر إلى أهمية الراوي بضمير المتكلم في القصة، يرويها لنا بوصفها نكتة هو بطلها، إذ يقول: في البدء كانت النكتة. ساخرًا بذلك من نفسه، ولأنه رجل دين، وأمام مسجد، فهو إذن بقصد أو بدون، أراد لجملته تلك أن تكون محاكاة ساخرة، لجملة قصة الخلق في التوراة: في البدء كانت الكلمة.. ولأن رجل الدين هو ممثل الله على الأرض، والمتحدث باسمه كما هو الظن الشائع، وناقل رسالته بعد الأنبياء، لذا حينما يحاكي الراوي الشيخ، الجملة الإلهية محاكاة ساخرة، فهو إذن يعلن فشله منذ البداية في حمل الرسالة الإلهية، بل يمكن القول أيضًا، أن القصة النكتة هذه التي يرويها الشيخ عبد العال، هي أيضا محاكاة ساخرة لقصة الخلق الإبراهيمية. فكأن البدء لم يكن الكلمة، وإنما النكتة، أو أن النكتة هي الكلمة التي بدأ بها الخلق. ومن ثم يصير الهروب من المسجد، معادلًا لكسر آدم حدود العهد الإلهي، والأكل من الشجرة المحرمة، ومن ثم سقوطه على الأرض المظلمة الفانية، وراء باب ليلي المغلق في وجهه.. سقط من الكلمة إلى النكتة.
وعنوان القصة أيضًا، ينطوي على مفارقة، بين الأمر، والأمنية، إذ تظهر فيه نبرة لوم غير حاسمة، وإنما نبرة أمنية مترددة، ترجو وتستعطف: أكان لا بد يا ليلي أن تضيئي النور.
إعلان
كأن إضاءة ليلي نور شقتها، لا تفهم للراوي الشيخ إلا دعوة صريحة للنظر والكشف والإبانة عن نفسها وجمالها، ومن ثم إغوائها لكل ناظر محروم مختبىء في ظلام نفسه. أو هي صورة أخرى للباطنية التي كانت قديمًا زاهدة وَرِعة، هي باطنية الإنسان مالك نفسه، المتسامي عن الصغائر، وصارت الآن باطنية الشر والإجرام والمعاصي وبيع وإدمان الحشيش والفحش الصريح.
تكاد تكون لكل مفردة في هذا النص الرمزي الجميل، وجهان ظاهر وباطن، قديم وجديد، تمامًا مثل النكتة التي سطحها هزلي لاهي، وباطنها الحقيقة، فالنكتة في النكتة ليست نكتة، ولكنها واقعة حدثت لأهل النكتة، صنعها المهرة، ورواها الطغاة.. الشيخ عبد العال هو أمام مسجد الشبوكشي في الباطنية، والمسجد وقف قديم وصاحبه الشبكشي تركي بالسياط سلب وضرب واعتقد أنه بالجامع وبضريحه المقام بجوار القبلة، يجني ثمار الدعوات، ستحمله صلوات الناس جيلًا بعد جيل لتقربه من الجنة.. حتى رحلة الجنة، تقطعها على أكتاف الآخرين يا تُركي..
ظاهر مسجد الشوبكشي إذن: التقوى، وباطنه استغلال واستعمار الباشا التركي للناس في دنيا وآخرة.. وفي الفجر من فوق الباطنية الغارقة في التناقض والخلط والتخليط، يهبط صوت عبد العال الباكي الشاكي: يارب، وكذلك يهبط أيضًا نور نافذة ليلي ليضيىء الظلام كأنه الكوكب، ووراء النافذة، تتقلب ليلي بقميص نومها على سريرها، بجمالها الفاحش، آلهة في برجها السماوي، جمالها كوني رفيع يضيءُ ويكشف ظلام الباطنية، لكن لا يمحوه.
تقوم ثقافتنا التقليدية على صراع الثنائيات الضدية، بين مئذنتين، أو نورين، لا يريد أن ينتهي حتى يومنا هذا، باعتراف كل منهما بالآخر، فيتكاملان، ولا تصير الغرائز في غربة عن الروح، ولا الروح بالغريبة عن الغرائز، وإنما الاثنين في الواحد الإنساني، ينهضان معًا ويوجدان معًا، دون تحارب يقضي فيه أحدهما على الآخر، كتكامل دونزيوس وأبولو، في فلسفة نيتشه، أو العقل والغريزة، أوالنفس والجسد. وذلك لأنهما ليسا منفصلين أصلًا في الواقع الفعلي، وإنما في الذهن التقليدي، وهكذا تتلبس ليلي الباطنية كلها، كما يتلبس الجمال القبح، تلك الباطنية التي رفعت الغرائز إلها تعبده، وتركت الروح المتسامي، أو القدرة على قيادة النفس بالعقل.
وعبد العال، الشيخ الشاب الموكل إليه هداية الجميع إلى جمال الروح، غارقًا حتى أذنيه في صراع شهوات الجسد وغرائزه، كلما كبتها تألم وتوجع مرضًا، كأنه بنفي غرائزه، لا يقوى فيه إرادة قيادة نفسه بحرية، وإنما يضعفها ويستنيم للبكاء والحزن، فإذا هو بين أمرين إما أن ينال ما يريده، أي يشبع غرائزه فيسقط في الإدمان وغياب الإرادة، ذلك أننا كلما أشبعناها ازدادت علينا قوة ونَهَمًا، أو يبكي ويتوجع منها شاعرًا بالذنب المطلق، رافعًا بذلك ضعفه إلها يعبده، دون مواجهته والتغلب عليه بالعقل والإرادة.
أنهك الصراع العبثي عبد العال وسلبه إرادته وعقله، فنسي الآذان فوق مئذنته، وراح يردد كلمة: يارب، بكل النبرات الحزينة الشاكية، حتى صار هو صوت أهل الباطنية جميعًا، يتوجعون معه وبه ومن خلاله، حتى أتوا إلى المسجد فجرًا، واصطفّوا وراءه، عشرة صفوف، يأمهم في الصلاة، التي نسي آذانها، ونفسه فصار سليب غرائزه، حتى لم يقوَ، على إنهاء الصلاة، فتركها فجأة، والمصلون ساجدون، وتسلل من نافذة المسجد هاربًا إلي ليلي، التي استقبله باسمةً كما يستقبل إله بشر مُخطئًا، في جنته، أخبرها أنه أتى يعلمها القرآن كما طلبت، فقالت وقد أعطته ظهرها مستغنية: أنها اشترت مسجل يعلمها القرآن باللغة الإنجليزية التي تجيدها، وليست بحاجة إليه، ثم أغلقت بابها في وجهه، وكذلك النور.
في البدء كانت النكتة، وفي النهاية ليست نكتةً تمامًا، وإنما حقيقة الألم وتمزق الإنسان.
إعلان
