هل انتهى دور الشرع؟
نقد كتاب (الدين والتدين)
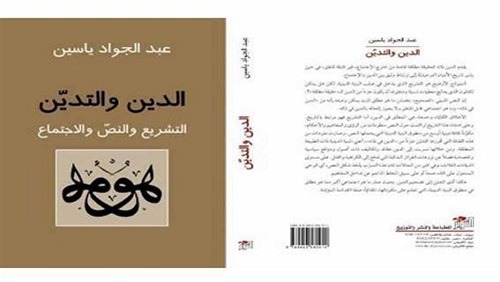
توجد ثلاثة مواقف تجاه تطبيق الشريعة الإسلامية:
- النصية:
وهو موقف يَعتبر الأحكام الشرعية ثابتة ودائمة ولا يجوز تغييرها إطلاقًا، وأنه لا اجتهاد مع النص؛ أي أن نجتهد ونبحث لاستنباط أحكام فيما لم يَرِد فيه نص فقط، أما ما ورد فيه نص فلا مجال للاجتهاد والبحث بل المسألة ببساطة: ربٌ يأمر وعبدٌ يطيع وأن الغرض من التشريع هو اختبار الطاعة.
- المقاصدية:
يقسِّم التيار المقاصدي الشريعة إلى عبادات ومعاملات، فأما العبادات فهي طقوس رمزية غير معقولة المعنى، كمناسك الحج وهيئة الصلاة، وبالتالي فهي ثابتة ولا تتغير. أما أحكام المعاملات، فهي تستهدف مصالح العباد وبالتالي فهي معقولة المعنى، منطقية ومعللة، والقاعدة: “الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا”، و” تتغير الأحكام بتغير موجباتها”، لذلك فأحكام المعاملات قابلة للتغيير، ليس لأنها أحكام غير صحيحة أو يوجد أفضل منها، وليس نسخًا للحكم ولا تبديله، بل لتغير محل الحكم، أي أن الشروط التي يُطبق عندها الحكم لم تتوفر، وتطبيق الحكم في غير محله لا يسمح له بتحقيق مقصده.
- التاريخية:
يتفق هذا التيار مع التيار المقاصدي في أن أحكام الشرع قابلة للتغيير، وأنها تدور مع مصلحة العباد، لكنه يفارقه بعد ذلك ويرى أن أحكام الشرع نزلت لعصر النبي وبيئته فقط، وبالتالي فدورها ينتهي بوفاة النبي، وبعد ذلك كان على العقل المسلم أن يطوي صفحة النص ليعيد البحث من جديد بعقله ويحكم بما يراه المجتمع صالحًا لزمنه وبيئته. لكن للأسف نشأت المنظومة الفقهية التي حجَّرت الفكر وقيَّدته بعصر التنزيل، وهذه المنظومة بمثابة دين جديد ظهر بعد وفاة النبي، دين قائم على الكهنوت وتسلط الفقهاء وتدخلهم في حياة البشر، وقائم على النصية والحرفية، يريد أن يعيدنا دائمًا لعصر التنزيل، والواجب علينا نسف كل هذه المنظومة والتحرر من النص.
ونحن نتبنى التيار المقاصدي، وفي هذا المقال نحلل تيار التاريخية، ونجد كتاب (الدين والتدين) للدكتور عبد الجواد ياسين أحد أقيم الكتب التي يستشهد بها تيار التاريخية، لذا فنفهم التاريخية ونقف عند أدلتها وننتقد مضمونها.
أولًا: عرض الكتاب
بدايةً يجب التفريق بين الدين والتدين؛ فالدين هو الجانب المقدس، الثابت، المطلق والكلي، وهو يتمثل في (الله – الأخلاق)، أما التدين فهو التزام البشر بالدين، أي ممارسة بشرية للدين، وهو متغير.
إعلان
غرض الكتاب هو إثبات أن التشريع الإسلامي والأحكام الفقهية، عبادات ومعاملات تندرج تحت التدين وليس الدين، ومن ثم فهي متغيرة، ومتجددة(1).
يقول د. عبد الجواد:
تهدف هذه الدراسة إلى إثارة النقاش حول تسكين التشريع بما في ذلك شِقِّه المنصوص داخل التدين لا الدين؛ أعني داخل دائرة المتغير القابل للتطور، لا دائرة الثابت الممتنع على التغير(2).
ويضيف:
النص الديني (الصحيح) يتضمن ما هو مطلق وثابت، يمكن وصفه بأنه من (الدين في ذاته)، وما هو اجتماعي قابل للتغير لا يجوز إلحاقه بالدين في ذاته، أي لا يجوز القول بتأبيده، لأن طبيعته النسبية المتغيرة سوف تفرض ذاتها في أرض الواقع بقوة الاجتماع وقانون التطور. الأخلاق الكلية وحدها هي التشريع أو القانون المطلق في الدين، وحين يقوم النص بإنزالها تطبيقيًا على الواقع متبنيًا خيارات اجتماعية فهو يعلن أن شقًا من البنية الدينية اجتماعي، قابل للتطور. يمكن تسمية هذا الشق بـ(الاجتماع المنصوص) وإلحاقه مجازًا بمفهوم التدين(3).
وأدلة ذلك:
تنجيم القرآن
لم ينزل القرآن في صورة نص واحد مجمَّع مرة واحدة، بل نزل منجمًا عبر ثلاثة وعشرين سنة، ونزول الآيات جاء استجابةً لنداء الواقع، فقد وقعت مشكلات استدعت وجود حكم إلهي، عندئذ نزل حكم الله، ولولا الواقعة، ما نزل حكم.
يقول د. عبد الجواد:
على المستوى التشريعي لم تصدر لائحة قانونية عامة ومجردة تستبق الوقائع والأحداث، بل كانت الأحكام التكليفية ترد متفرقة، كرد فعل لاحق للوقائع والأحداث، وذلك في إطار منهجية التنجيم التي اتبعها النص القرآني(4).
أسباب النزول
صياغة الآيات غالبًا لا تشير لأسباب نزولها والحادثة التي تعلِّق عليها، رغم أن معرفة هذه الأسباب جزء أساسي من فهم النص، ولا يمكن فهمه بدونها، مما يقتضي أن النص يخاطب قوم يعرفون جيدًا هذه الأسباب والحوادث، وهذا متوفر للمخاطَبين وقت النزول وغير متوفر لنا، إذن فهم المعنيون بهذه النصوص وليس من بعدهم.
كما أن قاعدة: “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب” التي صاغها الفقهاء جرَّت النص لأفهام غير مقصودة إطلاقًا.
مثلًا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى)، فقد تخبطت أقوال المفسرين كثيرًا، وأقروا أن الحر لا يُقتل بالعبد! في حين لو عرفنا من أسباب النزول أن الآية نزلت في حيَّين تقاتلا، وكان أحدهما أقوى من الآخر فقال الحي الأقوى: نقتل بالعبد منا الحر منكم، والمرأة منا الرجل منكم. فنزلت الآية لتنهى عن هذا الظلم وتقول: القصاص هو الحكم المقرر في القتل، لكن لا تقتلوا الحر البريء بالعبد ظلمًا وعدوانًا، بل اقتلوا الحر بالحر والعبد بالعبد.
وقوله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) لا يمكن فهمها كنص تشريعي عام، وقد جرَّ ذلك للقول بأن الآية نسخت كل آيات التسامح والسلم! بل الحقيقة أنه نص نزل في جماعة محددة وانتهى دوره.
يقول د. عبد الجواد:
لم يبدُ أن النص يقصد إلى إصدار لائحة نهائية تشرِّع للمستقبل، بقدر ما كان يقصد إلى معالجة الأحداث والحالات القائمة، بما يمكن اعتباره إقرارًا وقتيًا متعلقًا بسببه ومحله(5).
لا مفر من الإقرار بخصوصية الخطاب، وأنه كان يعالج كمقصود أساسي حالات الواقع الآنية التي يعانيها المخاطبون، ولم يكن النص يصدر قانونًا عامًا مجردًا يشرِّع للمستقبل (بغض النظر عن النقاش حول استنباط التشريع منه لاحقًا(6).
السُنَّة التقريرية
كانت القاعدة في التشريع وقت النبي هو اتباع العرف السائد، فلم تتوقف حياة المسلمين في انتظار الوحي، بل عاشوا كما يعيش قومهم، فتزوجوا وطلقوا ومارسوا السياسة والقتال طبقًا لعاداتهم، وكان بينهم النبي يرى ولا يعترض، بل يشارك معهم. لكن فيما بعد سُمي هذا السلوك (سنة تقريرية) فأصبح كل ما يمارسه النبي أو لا يعترض عليه كأنه سنة عن النبي مصبوغة بصبغة دينية، في حين أنه في الأصل عرف مصدره عهد الجاهلية، والنبي أقره بحكم السائد.
إذن فسلوك النبي والصحابة كان تابعًا لشريعة المجتمع باستثناء بعض الأحكام التي نزل بها الوحي، أما التعامل مع عصر النبي باعتباره كله هو الدين الثابت المقدس فهو تدليس.
اقتباس القرآن من شرائع الأمم
رغم أن الإسلام أحدث ثورة انقلابية في العقيدة، إلا أن أحكامه لم تكن انقلابية، بل هي أحكام مستوحاة من الواقع، ومقتبسة من التشريعات البشرية؛ فأغلب – إن لم يكن كل – تشريعات الإسلام ليست اختراعات دينية، بل هي انتقاء واختيار من البدائل المتاحة وقتئذ، فنظام المكاتبة مع العبد لتحرره موجود في اليهودية، ونظام الولي في الزواج موجود في الجاهلية، ونظام قطع يد السارق موجود في قريش، والعرب قبل الإسلام عرفوا العدة، وربع الغنيمة كانت تذهب للقائد، وتحريم القتل في الأشهر الحرم، إذن فدور النص كان تعديل للواقع أكثر منه إنشاء واختراع تشريعات جديدة.
يقول د. عبد الجواد:
إذا كان بإمكاننا الحديث عن انقلاب جذري أحدثه القرآن في مجتمع الجزيرة على مستوى العقيدة، فليس بإمكاننا الحديث عن انقلاب جذري، أو حتى انقلاب كبير، على مستوى التشريع والقانون. كما يظهر مثلًا في تبني القرآن لتقاليد الزواج التي كانت سائدة في المجتمع المكي، والتي تتشابه تشابهًا لافتًا مع تشريعات ما بين النهرين، وفي التعديل الجزئي الذي أدخله النص على أحكام الطلاق كما في تنويع مدد العدة(7).
جميع الأحكام التي تبناها القرآن في مجالي العقوبات والأحوال الشخصية وفي غيرهما من مجالات التشريع كانت، باستثناءات قليلة، مستعارة من النظام العرفي السائد قبل الإسلام أو لها أصل فيه أو على الأقل لا تمثل تناقضًا مع خطوطه الأساسية. لقد عكست التشريعات القرآنية كأصل عام أعراف وتقاليد المجتمع العربي قبل الإسلام، وتوافقت إجمالًا مع نظامه القانوني العرفي، وليس العكس(8).
النسخ وتغير المصالح
أنكر اليهود النسخ، وقالوا بأن النسخ يعني البداء؛ أي بدى لله ما كان يجهله! وهو مستحيل على الله، لذلك يستحيل نسخ الشرائع الدينية.
أما في الإسلام، فكل المسلمين يقرُّون أن الشرائع الدينية جائز نسخها بين الشرائع. ولو كانت الأحكام غرضها استهداف المصلحة، فالواقع يتغير، والأحكام التي كانت تحقق المصلحة لم تعد صالحة لتحقيقها مع تغير الواقع.
إذن فالعقلية الإسلامية لا تجد مانًعا من تغير الأحكام، لماذا تحجَّرت عند النص القرآني ومنعت تغيير أحكامه؟ لماذا ناقشوا النسخ عن الأحكام السابقة، ولم يناقشوا النسخ في المستقبل؟! لماذا أكَّدوا أن مصالح العباد تغيرت من عهد موسى إلى محمد، ثم أنكروا كل تغير حدث بعد وفاة النبي؟!
يقول د. عبد الجواد:
برز التساؤل حول إمكان تغير الشرائع التي أرادها الله، وكانت زاوية النقاش موجهة نحو الماضي، إذ انصب على الدفاع عن مفهوم النسخ الكلي لشريعة التوراة، لصالح الشريعة المنزلة في القرآن، فحاور الرؤية اليهودية القائلة بامتناع النسخ في حق الله باعتباره ضربًا من البداء. ورغم أنه في هذه المحاورة اعتمد جزئيًا على فكرة المصالح المتغيرة، إلا أنه توقف بهذه الفكرة عند حدود التوراة، فلم يطور البحث من خلالها ليطاول النظر في الأحكام المنزلة في القرآن، والتي ستقابل بدورها في الزمن المتغير مصالح متغيرة(9).
ثانيًا: انتقاد الكتاب
رسالة الكتاب أن الأحكام الشرعية قابلة للتغيير، وهو ما نجح الكتاب في إثباته بشكل عميق ومفصل، وهو محل اتفاق بين التيار المقاصدي والتاريخية.
لكن كيف تتغير الأحكام؟ هل انتهى دورها تمامًا؟ هل نأخذ من القرآن مقاصده ونبني أحكامًا تفصيلية تحققها؟ هل تستمر الأحكام طالما تحقق المصلحة وعلة الحكم متوفرة، وإن انعدمت العلة يزول الحكم؟ هل يتبنى الكتاب المقاصدية أم التاريخية؟ هذا ما لم يجب عليه الكتاب صراحةً.
لكن كرر الكتاب في أكثر من موضع كلمات تساعد على تحديد وجهته؛ إذ قال:
لم يبدُ أن النص يقصد إلى إصدار لائحة نهائية تشرِّع للمستقبل، بقدر ما كان يقصد إلى معالجة الأحداث والحالات القائمة، بما يمكن اعتباره إقرارًا وقتيًا متعلقًا بسببه ومحله(10).
وأضاف: “لا مفر من الإقرار بخصوصية الخطاب، وأنه كان يعالج كمقصود أساسي حالات الواقع الآنية التي يعانيها المخاطَبون، ولم يكن النص يُصدِر قانونًا عامًا مجردًا يشرِّع للمستقبل”(11).
كما نقد الفكر المقاصدي للشاطبي في جملة مختزلة جدًا فقال: “نظرية الشاطبي في النهاية نظرية تفسيرية، أعني تؤدي إلى تبرير الشريعة التفصيلية كما هي عليه، ولكنها غير كافية لمواجهة شافية لمشكل التطور”(12).
كما ذكر د. عبد الجواد في ندوة (الدين والتدين – مشكلة الإصلاح): “كان عصر تدوين الإسلام لا يزال يعيش نفس مناخ عصر التنزيل، ولم يحدث تغيرًا جزريًا يمثل تحديًا حقيقيًا لمنظومة الفقه، أما الآن بعد الحداثة، بعد التطور في الهياكل الكلية، لم يعد بمقدور نظام التدين الحالي أن يواجه هذا التطور”(13).
فيتضح أن الكتاب يتبنى تيار تاريخية النص الذي يقر بانتهاء دور التشريع تمامًا، وأن التشريع نزل لزمن وبيئة محددتين فقط، ولم يشرِّع للمستقبل.
هل أدلة الكتاب تثبت تاريخية النص؟
إجمالًا أعتقد أن كل أدلة الكتاب صحيحة، لكنها لا تثبت التاريخية، ولا يلزم عنها توقف العمل بالشرع، بل يلزم عنها تبني تيار المقاصدية.
ونناقش أدلة الكتاب تفصيلًا ..
الدين والتدين:
التفريق بين الدين والتدين، والشريعة تندرج تحت التدين المتغير.
نتفق مع هذه التفرقة، وقد استقر عند علماء الكلام أن العقيدة لا يجوز نسخها، أما الأحكام فجائز نسخها، لذلك نسخ الإسلام شرائع اليهودية.
واتفق الفقهاء على جواز تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
والمنهج المقاصدي يربط الأحكام بعلتها، فالحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.
وقد ميَّز محمد رشيد رضا بين الشريعة والدين فقال: “الشريعة اسم للأحكام العملية، وأنها أخص من كلمة (الدين)”(14).
وقد فرَّق خالد محمد خالد بين الدين والشريعة، أو بين الدين والفقه؛ فالدين هو المسائل التعبدية، أما الشريعة فهي الأحكام التي تستهدف مصلحة العباد، والدين ثابت بينما الشريعة متغيرة(15).
تنجيم القرآن:
تنجيم القرآن يدل على أنه لم يقصد وضع تشريع دائم وشامل.
القول بأن القرآن لم يستهدف بناء تشريع شامل، فهو واضح جلي في كم أحكام المعاملات القليلة جدًا، ومساحة الاجتهاد التي فتح الإسلام أبوابها.
أما تنجيم القرآن، فقد نصَّ القرآن صراحةً على علة تنجيمه، فقال: (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا)، فهو ينص صراحة أن علة التنجيم هي تدرج الأحكام وتعطش الناس للتنزيل، وتدبر الآيات على مكث.
ولا يلزم عن تنجيم القرآن أنه ما قصد وضع تشريع دائم.
ولنا أن نلاحظ أن آيات العقيدة هي نفسها لم تنزل جملة واحدة، بل نزلت منجمة هي الأخرى، فهل يلزم عن ذلك تغييرها؟! وكذا العبادات والقصص نزلت منجمة، فلا علاقة إطلاقًا بين تنجيم النزول وعدم استدامة الأحكام.
والقوانين البشرية عمومًا تصدر بعد وقوع مشكلات عملية لا نجد لها حلًا، تضطرنا لوضع قانون يحلها، ولا يُتصور صدور قانون لم يحتج إليه الشعب! فلا يصدر قانون ينظم عمل مؤسسة إلا بعد تكوينها، كذلك المجتمع الإسلامي كان في طور النشأة، فلا حاجة لتشريعات في مكة، ثم تتابع صدور التشريعات بعد الانتقال للمدينة، أي بعد الاحتياج إليها.
أسباب النزول:
أسباب النزول تقتضي أن أحكام القرآن تاريخية نزلت لأسباب محددة ووقائع منتهية.
هنا يجب التفريق بين نوعين من أسباب النزول:
1- أحداث غير متكررة : مثل حادثة معقدة عقَّب عليها القرآن وانتهت، مثل تعليقات القرآن على الغزوات، وكقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ)، أي قاتلوا من يقربون منكم، ثم الأبعد فالأبعد، فواضح من سبب النزول أنها تتحدث عن موقف بعينه يصعب تكراره بتفاصيله، ولا مانع من فهم مقصد الحكم والوقوف على توجهه للقياس عليه.
كذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً)، و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ)، و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ)، فكلها أحكام نزلت لسبب فريد لن يتكرر، وانتهى دورها بوفاة النبي، أو بتعبير الفقهاء: ذهاب محل الحكم.
2- أحداث متكررة، مثلًا لو سرق أحمد فنزل الوحي بقطع يده لأنه سارق، فلو سرق محمد بعد عام أو مئة عام، هل نقول: لم ينزل نص في محمد والنص المنزل يخص أحمد فقط؟! أم نقيس حالة محمد على أحمد ونكرر الحكم لتكرر الحدث؟
ولو قلت لك: “لا تضع الزيت في الكوب، لأن به ثقب”، ومرت سنوات ووضعت ماءً في الكوب، ظنًا منك أني نهيتُك عن وضع الزيت فقط، فأنت مذنب وغير معذور، لأن علة المنع واضحة: “الكوب به ثقب”، والعلة متوفرة في الماء والزيت؛ فكلاهما سيقع من الكوب.
وبذلك نتفق على أن الأحكام نزلت لحالات محددة في زمن النبي، لكن لا مانع عقلي أو شرعي من القياس عليها لتوفر العلة، بل هو واجب عقلي وشرعي.
ونسقط ذلك على مثال، فقال تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، فقد نزلت في صلح الحديبية، هل يمكن القول: لا نطبق هذه الآية الآن؟!
وقوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، فقد نزلت في أم أسماء، هل نوقف العمل بها؟!
ومما يثبت أن الشرع لم ينزل لحالات محددة وانقطع دوره أن النبي حين أرسل ولاةً خارج الجزيرة العربية، ألزمهم بالتشريع الديني مما يعني أن الشرع متجاوز لسبب نزوله.
إقرار النبي:
إقرار النبي لوضع الجاهلية لا يعني نسبتها للدين.
نتفق مع هذه النقطة تمامًا، ونزيد عليها تأصيلًا أكثر دقة:
للنبي أكثر من دور، فهو رسول الله ورئيس الدولة وقاضٍ وإنسان له عاداته وتقاليده الخاصة، وبذلك قسَّم القرافي والدهلوي وابن عاشور ومحمود شلتوت والقرضاوي أقوال النبي وأفعاله إلى ما هو تشريعي وما هو دنيوي، فحين يقول النبي: “من أصلح أرضًا فهي له“، فهو اجتهاده البشري الدنيوي السياسي غير الملزم لمن بعده.
وبناءً على ذلك فختان الإناث مثلًا كان موجودًا قبل الإسلام، ولم يعترض النبي عليه لكن لم يربطه بالدين فلا نعتبره تشريعًا إسلاميًا. وطرق العلاج التي اتبعها النبي وأرشد إليها، هي طب العرب وليس طبًا نبويًا.
يقول محمد الغزالي:
إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا واستراليا، إننا مكلفون بنقل الإسلام فحسب(16).
أما حين يرى النبي فعلًا سائدًا فيَعِد فاعله بالثواب أو يتوعد فاعله بالعقاب فهو تشريع ديني.
وبذلك فإقرار النبي لفعل قد يكون استمرارًا للواقع الدنيوي المُعَاش، وبالتالي فهو اجتهاد دنيوي، وقد يكون مصحوبًا بوعد أو وعيد، عندئذ فقط نربطه بالدين.
اقتباس القرآن
اقتباس القرآن من شرائع السابقين يعني تبعية النص لأحكام عصره.
أولًا: العرب كانت تعرف الجوار، وأقره القرآن بقوله: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ).
والجزية كانت نظامًا معروفًا، لم ينشأه القرآن، بل استخدمه فقط.
والمرويات مليئة بموافقات القرآن للصحابة فيما اقترحوه، وكثيرًا ما اختلف الصحابة حول رأيين، ونزل القرآن ليختار أحدهما.
إذن فاقتباس القرآن من البشر واقع ومُصرَّحٌ به ومعروف منذ القدم، وقد صرح به الجاحظ ومحمود شلتوت وعدنان إبراهيم والمفسرون من قبل.
ثانيًا: لا يقدح في القرآن ولا ينتقص منه اقتباسه من أحكام بشرية، فالحلول التي تحل مشكلات البشر مؤكد هي من جنس أفعال البشر، ويتعقلها البشر، ويمكن لعقل بشري أن يصل إليها، وكون القرآن اصطفى وانتقى من الحضارة الإنسانية كلها ما يفيد ونهى عما يضر فهو دور عظيم.
يقول خالد محمد خالد:
التشابهات الكثيرة بين القوانين القديمة جدًا والحديثة جدًا، والتشابهات القائمة بين الشرائع الوضعية والشرائع السماوية، لعلها تشير إلى هذه الحقيقة: إن القوانين يجب أن تكون استجابة صحيحة لمقتضيات العقل الإنساني ومنطقه، بل هي لا تكون إلا كذلك(17).
ثالثًا: حين يقترح مستشارون على مَلِكٍ باقتراحات مختلفة، ثم يتبنى الملك اقتراحًا منهم ويصدر قانونًا رسميًا به، ألم يصبح القانون قانون الملك بمجرد تبنيه له ومخالفته هي عصيان للملك رغم أن مصدره أحد المستشارين؟
كذلك لا يهم مصدر التشريع، طالما قد تبناه القرآن وأقرَّه، ووعد فاعله بالثواب، وتوعَّد مخالفه بالعقاب.
ولعل ذلك ما جعل المسلمين يسألون عن أمور في بداية الإسلام لديهم حلول لها، لكنهم سألوا عن موقف الدين منها، هل يبقيها ويتبناها أم يحرِّمها؟ فقد سألوا عن السعي بين الصفا والمروة، فأباح القرآن ما كان ساريًا دون تغيير، (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، وبهذا الإقرار الإلهي أصبح السعي عبادة إسلامية مقدسة يُثاب فاعلها.
النسخ وتغير المصالح
طالما أن التشريع تابع للمصلحة ومحصور في وسائل العصر، وطالما المصلحة والوسائل يتغيران، فيلزم عن ذلك تغير الأحكام.
هذا هو أهم دليل، والمقاصدية لا تنكره بل توظفه بدقة، فالمقاصدية تفرق بين الوسائل والمقاصد، فالوسائل تتغير متى ظهرت وسائل أفضل لم تكن متاحة وقت التنزيل أو متى ثبت أن الوسائل القديمة لا تحقق مقصد الحكم أما المقاصد فثابتة.
وأمثلة ذلك:
- الطلاق بلفظ الثلاث طلقات هل يُعد طلقة واحدة أم ثلاثة؟ تفاوتت الإجابة عبر العصور طبقًا للمصلحة؛ فقد جعله الصحابة طلقة واحدة، ثم جعله عمر ثلاث طلقات حتى لا يستسهله الناس، ثم جعله ابن تيمية طلقة واحدة حتى لا تكثر المطلقات.
- الجزية – باعتبارها وسيلة لحماية أهل الذمة – قد تطورت طبقًا للمصلحة؛ فسقطت عمن شارك من أهل الذمة في الجيش، ثم سقطت عندما ساد مفهوم المواطنة الذي ألزم أهل الوطن الواحد بالتجنيد الإجباري.
- توزيع المغانم على الجنود – باعتباره وسيلة لمكافأة المقاتلين – قد تغير إلى مرتبات ثابتة للجنود، ودخول الغنائم في الميزانية العامة للدولة.
وغير ذلك كثير من الأحكام التطبيقية والتفصيلية التي تغيرت صورها لكن ثبت مقصدها.
كما رأيت التيار المقاصدي يحلل علة كل حكم ثم يرصد الواقع ليرى هل تتوفر العلة أم لا، فإن غابت العلة عندئذ يوقف تطبيق الحكم لعدم توفر شروطه.
أما الادعاء بأن الواقع عمومًا قد تغير فنوقف الشرع بالكلية!! فهو حكم عام وسطحي، فماذا تغير بالضبط؟ ولماذا هذا التغير أثر في تطبيق الحكم؟
يقول ابن عاشور:
معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون أحكامها كليات ومعاني مشتملة على حِكَم ومصالح، صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد، ولذلك كانت أصول التشريع الإسلامي تتجنب التفريع والتحديد.
وقد نهى النبي أن يكتبوا عنه غير القرآن، لأنه كان يقول أقوالًا ويعامل الناس معاملة هي أثر أحوال خاصة، قد يظن الناقلون أنها صالحة للاطراد(18).
التاريخية في مواجهة المقاصدية
- أليست أحكام الشرع وقت البعثة هي الحل المقدس الإلهي المثالي؟
أعتقد أن كل من آمن بأن هذا النص مصدره الوحي ستكون إجابته: نعم، كان التشريع (وقت نزوله) هو الحل الإلهي المقدس المثالي.
- لو نزل حكم في زمن النبي لعلة محددة ومقصد معروف، ثم تغير الواقع وأصبح الحكم لا يحقق مقصده، هل نستمر في التطبيق؟
يتفق المقاصدية والتاريخية على زوال الحكم لزوال العلة.
- لو نزل حكم في عهد النبي لعلة محددة وبعد مرور ملايين السنين وُجدت حالة مطابقة لحالة نزول الحكم، هل نعتبر الحكم ساريًا ونطبقه باعتباره الحل المثالي الإلهي المقدس أم ننسخ الحكم ونلغي دوره كأنه لم يوجد ونعيد البحث من جديد؟
لو كانت الإجابة هي الالتزام بالحكم فهي إجابة المقاصديين التي تقول: الحكم سارٍ ما لم تتغير موجباته والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، وبذلك الدعوة لتغيير حكم تحتاج إثبات أن الواقع قد تغير وأن العلة غير متحققه.
أما لو كانت الإجابة هي عدم الالتزام بحكم النص حتى لو تطابقت الحالتان.
فهنا نقطة الافتراق، فهذه الإجابة هي تمرد واضح وصارخ على النص الإلهي وإنكار لقدسية النص وإلغاء لدوره وتشكيك في صحته، وهذا الموقف يفضح الدعوة لتغير الأحكام التي ليس دافعها تحقيق المصلحة وإنزال الشرع منزله بل إسكات الوحي وعزل الشرع وعصيان الله.
نرشح لك: آدم -عليه السلام-: بين نظرية التطور ونصوص الخلق
المصادر: 1- لم يتحدث د. عبد الجواد في الكتاب عن العبادات والطقوس، لكن ذكرها في ندوة (الدين والتدين – مشكلة الإصلاح) ق: 49-53 2- (الدين والتدين) ص26 3- (الدين والتدين) ص8 4- (الدين والتدين) ص38 5-(الدين والتدين) ص44 6-(الدين والتدين) ص62 7-(الدين والتدين) ص42 8-(الدين والتدين) ص302 9-(الدين والتدين) ص89 10-(الدين والتدين) ص44 11-(الدين والتدين) ص62 12-(الدين والتدين) ص331 13-ندوة (الدين والتدين – مشكلة الإصلاح) ق1:10 – 1:13 14-(تفسير المنار) ج6 ص342 15-(الديمقراطية أبدًا) ص176 16-(السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) ص59 17-(الديمقراطية أبدًا) ص159 18-(مقاصد الشريعة الإسلامية) ص105
إعلان
