على أطلال الشعر الجاهلي
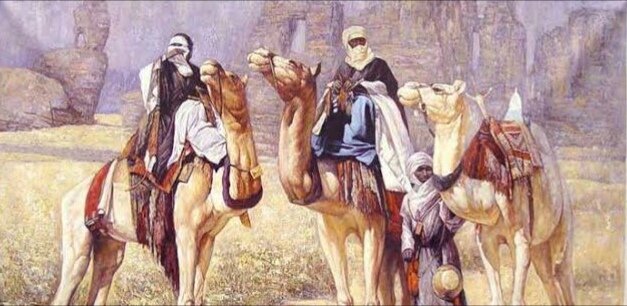
ليس التاريخ بكم متصل من الأحداث والوقائع، بل هو أشبه بكمات من الوقائع توصل كل منها إلى معنى؛ فالمجتمعات ما انعقدت إلا على شرائع ظاهرة انطوت على معنى باطني هو روح الجماعة، تلك الروح التي من شأنها أن تصهر وعي الفرد في أتونها فتنزع أهواءه وتكسب ولاءه، وبقدر ما تتصل أسباب الفرد بهذه الروح فإن وجوده يتبرَّر، وتصطبغ أفعاله بصبغة المعنى والوحدة.
لكل مجتمع روحه كما أن لكل عصر مآثره، فما الذي يجعلنا نميُّز بين عصر وعصر، مجتمع وآخر؟ إلا أننا وعَيْنا _بشكل ما_ ذاك المعنى الباطني الذي يضفي على المجتمع وحدة عضوية خاصة بما اشتمله من شعر وفن، ودين، وعلوم، وسياسة. وباختزال هذا المعنى فإننا نمسي غير قادرين على قراءة التاريخ ولا الكشف عن سننه العامة، وهذا ما أقر به القرآن (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا).
من هذه الحقيقة التي قد تبدو بسيطة إلا أنها تتطلب وعياً حاضراً بالتاريخ تملّك الشك أديبنا طه حسين حيال كل ما هو جاهلي؛ ذلك لأنه قلنا إنَّ الفنون _والشعر منها_ ليست بدعاً، تعبر عن روح العصر الذي ولدت فيه وتصوِّره لنا، أما الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين فيظهر لنا حياة غامضة جافة بريئة من الشعور الديني والعاطفية الدينية “أوليس عجيباً أن يعجز الشعر الجاهلي كله في تصوير الحياة الدينية للجاهليين؟” (1)
إنَّ الدين قدّم دوراً مركزياً في حياة الجاهلية، وهل يستقيم أن ينافح الجاهليون عن دينهم بالجدال أو بالسيف إلا بسبق من عاطفة دينية قوية؟ فأين تلك العواطف مما روي عن امرئ القيس وغيره؟ ألم يتأثَّر بها وإن قليلا؟ اللهم إلا أن يكون امرئ القيس هذا قد عاش خارج التاريخ!
الشك كآلية ومنطلق:
لم يعتد طه حسين بالاتفاق حول المروي، الكل سواسية في منهاج الشك كثر رواته أو قلوا، صلحوا أم فسدوا؛ ذلك لأنَّ “الكثرة في العلم لا تعني شيئا فقد كانت كثرة من العلماء تنكر كروية الأرض وحركتها وظهر بعد ذلك أن الكثرة مخطئة”، (2) وليس هذا الشك حول أصالة الشعر الجاهلي أو انتقاده بحديث عهد؛ إذ إنَّ القدماء حملوا شكاً وانتقاداً بمثل ما حمله المحدثون، فابن سلام “يحدثنا بأن قريشاً كانت أقل العرب في الجاهلية فاضطرها ذلك إلى أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر في الإسلام”. (3) كما أن ابن سلام نفسه لم يقبل شعراً قد روي عن عاد وثمود وعدَّه منحولاً، فالله قد أهلك عادا وثمود ولم يبق لهم من باقية،وقد تبيّن القدماء هذا غير أنَّ “مناهجهم في النقد كانت أضعف من مناهجنا فكانوا يبدؤون ثم يقصرون الغاية”. (4) واتفق أن يكون بحث طه حسين هذا -أو شكّه – قائمًا على منهاج نقدي حديث، الديكارتي تحديداً، ذلك لأن “منهج ديكارت ليس خصباً في العلم والفلسفة والأدب فحسب، وإنما هو خصب في الأخلاق والحياة الاجتماعية”. (5)
حمل كتاب “في الشعر الجاهلي” دعوة للتخلص من عبء الموروث، وجعل طه حسين يلغم بالشك مَشيد الأدب الجاهلي غير أنَّ “الشك لا ضرر منه ولا بأس به … خير للأدب أن يزال منه في غير رفق ولا لين ما لا يستطيع الحياة ولا يصلح لها “ (6) بدلًا من أن يثقل كاهل الحراك الأدبي أكثر مما هو مثقل، لذا فإن كتابه هذا لم يتوجه به إلى أنصار القديم أولئك “الذين لا يستطيعون أن يبرؤوا من القديم ويخلصوا من أغلال العواطف والأهواء حين يقرؤون العلم أو يكتبون فيه”، فهم ليسوا بأحرار حقاً ولا قادرين على أن يرثوا إرادة الشك، ولعل اطمئنانًا إلى المستقبل هو ما دفع طه حسين إلى نشره كتابه “ذلك لأن عقليتنا نفسها قد أخذت منذ عشرات السنين تتغير وتصبح غربية … وهي كلما مضى عليها الزمن جدّت في التغير وأسرعت في الاتصال بأهل الغرب”، ونحن إزاء حقيقة أننا إذ نتأثَّر بالغرب فإننا _سواء رضينا أم كرهنا_ سنرث عنهم هذا المنهج، بل “لا بد من أن نصطنعه في نقد آدابنا وتاريخنا كما اصطنعه أهل الغرب “. (7)
إعلان
وقد آن لهذا الجيل أن يزيل قطمير القداسة أثناء بحثه عن كل ما هو قديم، ليس الشعر الجاهلي فحسب بل ما اتصل من قرآن، وحديث، وسير، وتاريخ. “نعم! يجب حين نستقل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتها , وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به وأن ننسى ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين ” (8) فالباحث الحق هو ذلك الذي يذعن فقط لسلطان منهاج البحث الصحيح، وما منهج ديكارت إلا أحد تلك المناهج، وطه حسين في هذا ليس بمستشرق ولا برجل دين إنما انطبق عليه ما درج مثلاً “إن كان ثمة ولا بد (فبيدي لا بيد عمرو)”. وبإمكاننا أن نلمح صورة في الكتاب كيف اختلف طه حسين مع كليمان هاور فما يثبته الأخير من شعر جاهلي لأمية بن أبي الصلت -أحد الشعراء الأحناف- بل ويعده مصدراً أخذ القرآن عنه، ينفيه الأول ويعده شعراً منحولاً ليثبّت المسلمون لهم قدماً من طريق إبراهيم، فمن أحق بالحنيفية؟
الحامل التاريخي في ميزان الشك :
يقسّم طه حسين سِفره كما يحلو له أن يسميه إلى ثلاثة كتب: الأول وهو الأسباب التي دعته إلى الشك في الشعر الجاهلي، الثاني في ذكر أسباب الوضع والنحول، أما الثالث فيعرج فيه على طوائف من الشعر والشعراء لينتهي أخيرًا إلى النتيجة التي فجأنا بها في المقدمة: “وأول شيء أفجؤك به هو أني شككت في قيمة الشعر الجاهلي وألححت في الشك حتى انتهى بي هذا كله إلى أن الكثرة المطلقة مما نسميه شعراً جاهلياً ليس من الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة مختلَقة بعد ظهور الإسلام فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين”. (9) وقد رأى طه حسين أنّ صورة المجتمع الجاهلي ما زال يمكن استردادها لكن من نصوص القرآن؛ لأن نص القرآن نص تاريخي وهو أجدر من أن يمثل حياة الجاهليين. ” إنَّ القرآن أصدق مرآة للحياة الجاهلية … وليس من اليسير أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النبي فيه إلا أن يكونوا قد فهموه ووقفوا على سرائره ودقائقه ” 10
فليس من شك أن يكون القرآن قد نزل باللغة التي كان يصطنعها الناس في عصره عصر الجاهلية، ولعل طه حسين هنا يلوّح إلى أن يكون النص القرآني نص تاريخي بامتياز، فهو ما جادل إلا الفرق الدينية التي تمثلت بالبلاد العربية، “ولولا ذلك لما كانت له قيمة ولا خطر… أفترى أحد يحفل بي لو أني أخذت أهاجم البوذية أو غيرها من هذه الديانات التي لا يدينها أحد في مصر؟ “. (10)
بل إنَّ يد الشك تجاوزت هذا كله وطالت المأثور من تاريخ العرب بل وما اتصل به من أحاديث , فيما يُنقل أن العرب انقسموا نسبًا إلى قحطانيين منازلهم اليمن، وهؤلاء قد فطروا على العربية فسموا بالعاربة، وعدنانيين قد استعربوا وعدنان من ولد إسماعيل.
ويروى عن النبي قوله “أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن عشر سنين” أي إن إسماعيل قد نسي لغة أبيه إبراهيم الكلدانية حين فتق الله لسانه بالعربية، ومن ولد عدنان مضر وربيعة أما مضر فمنها كنانة ومن كنانة قريشًا وقد روى عن النبي قوله “إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة” وعلى ما يبدو أن طه حسين لم يطمئن لمثل هذا التاريخ ولا لمرويات الأحاديث التي ذكرت في شأنه , بل آثر الاستناد إلى ما روي عن عمرو بن أبي العلاء “ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا”. (11) ولعل استخدام طه حسين المركب “لغتهم بلغتنا” بدلاً من “عربيتهم بعربيتنا” طلباً للاتساق مع العرض، فالفروق التي أثبتها العلم الحديث استناداً للنقوش بين لغة حمير العاربة ولغة عدنان المستعربة، هي فروق من البعد بمكان أن تسمح بتفسير استعراب ولد اسماعيل، وإلّا فما سر هذا التباعد بين اللغتين وما سر قول ابن أبي العلاء؟.
وهنا لم يغفل صاحب الكتاب أن ينبهنا إلى مقصوده باللغة فإن سلّمنا أن ابن أبي العلاء قال: (عربيتهم كعربيتنا) فان اللغة العربية المراد بها “معناها الدقيق المحدود الذي نجده في المعاجم حين نبحث فيها عن لفظ اللغة ما معناه نريد بها الألفاظ من حيث هي ألفاظ تدل على معانيها “. (12) ولم يشفع ذكر إسماعيل في التوارة أو القرآن أو ما ذكرناه من حديث عنده إلى أن يخلص إلى نتيجة مفادها أنَّ:
“الصلة بين اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانية واللغة التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة من اللغات السامية المعروفة , وإن قصة العاربة والمستعربة وتعلم إسماعيل العربية من جُرهم كل ذلك أحاديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه” (13)
ولعل “أقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية ويبثون فيه المستعمرات “ فإن ثمة حروباً قد نشأت بين المستعمرين والعرب فلا يبعد أن يكون الصلح قد قام نخب أبناء العمومة أولاد إسماعيل وإسحاق، أما قريش فقد رحبت أيما ترحيب بهذه الأسطورة، فنحن إذ نعلم أن الكعبة مركز الوثنية كانت قد قارعت كلاً من اليهودية والمسيحية قبيل مولد النبي حتى إن أبرهة الحبشي قد قرر هدم الكعبة وبناء مركز ديني مسيحي بدلاً منها، لكن مراده لم يتم وقد خلّد الله هذه الحادثة في القرآن، إذًا فإن حملة أبرهة تبرز لنا أهمية الكعبة إبان ذاك الوقت، وقد تمسحت الوثنية بإبراهيم تماما كما تمسح به اليهود والمسيحيون، فالنبي حين دخل الكعبة مزق صورة للنبي إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام فكان قوله (أما لهم ! فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة , هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم !)
لما أظهر الله الإسلام على غيره من ديانات العرب، أراد المسلمون أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل بعثة النبي، فلم يك غير طريق الحنيفية ملة إبراهيم؟ فإن كان اليهود والنصارى قد استأثروا بدينهم الذي جادلهم فيه القرآن (بما يحرفون الكلم عن مواضعه) بل ورفع صبغة الاصطفاء عنهم (بل أنتم خلق ممن خلق) فكان لا بد أن يستأثر المسلمون بالحنيفية والله أيدهم بقوله: (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين )
ومن هنا يبدي العميد رأيه أنّ
“هذا الشعر المضاف إلى أمية بن أبي الصلت وإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا النبي أو جاؤوا قبله إنما انتحل انتحالا . انتحله المسلمون ليثبتوا – كما قدمنا- أن للإسلام قدمة وسابقة في البلاد العربية.(14)
ليست النتائج -التي توصل إليها العميد – بحد ذاتها هدفاً لهذه المراجعة، فالضجة وردود الفعل الساخطة حول الكتاب ما أثيرت إلا حول سياقه، وإلا فإن الكتاب سمح له بالتداول تحت اسم (في الأدب الجاهلي) بعد حذف تلك السطور الخاصة بواقعية القرآن.
وهذا السياق إنما يدفعنا دفعًا نحو إشكالية القرآن والتاريخ، فالقرآن واقعة تاريخية وهو بحد ذاته لا يمثل وثيقة تاريخية مستقلة، حيث إن الرواية الإسلامية التي تضع القرآن في مجرى التاريخ ينالها الاضطراب خاصة إذا اتصل الشأن بقضايا القرآن التفصيلية وحيثيات النزول، وبالتنبه -فيما يتصل بالشعر الجاهلي- أن لغة عرب الشمال ما وصلتنا إلا وقد نضجت نضجاً سمح لها بمثل هذا الإنتاج الأدبي الفريد، تثار الشكوك أخيرا حول إمكانية وجود موائمة متأخرة بين الشعر الجاهلي ولغة القرآن ما من شأنه أن يرسم طريقاً لقراءة مغايرة في التاريخ الإسلامي .
المصادر: 1- في الشعر الجاهلي ص19 2- نفس المصدر ص 133-134 3- نفس المصدر ص 66 4- ففس المصدر ص 67 5- نفس المصدر ص 14 6- نفس المصدر ص182 7- في الشعر الجاهلي ص 45 8- نفس المصدر ص 12 9- نفس المصدر ص 7 10- نفس المصدر ص 16 11- نفس المصدر ص25 12- نفس المصدر ص24 13- نفس المصدر ص 29 14- نفس المصدر ص 86
إعلان
