صورة الإلهيِِّ في الدين الإسلاميِّ: كيف تَجَلَّى اللهُ في مُدَوَّناتِ علم الكلام؟ (الإله السياسي)
قراءة في كتاب (تَجَلِّي الإله - جدليَّة الإلهيِّ والإنسانيِّ في الثقافةِ الإسلاميَّة) (2/4)
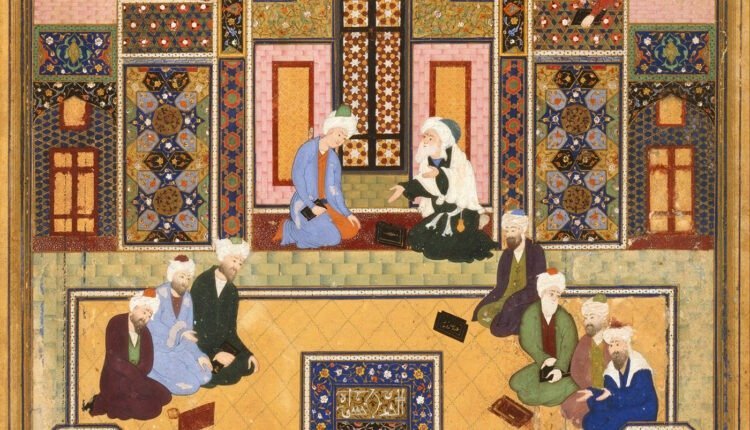
اقرأ أيضًا: جناية الفقهاء والمتكلمين على الإسلام
الجدلُ مع المخالف سمة أساسيَّة في الإسلام منذ بدء نزول الوحي
“ظَهَرَ علم الكلام؛ ليتبارى في الدفاع عن الإسلام، ويعرض تاريخيًّا لكل هذه الفِرَق [المخالفة للإسلام] والردِّ عليها”[1].
يأتي التعريف الكلاسيكي لعلم الكلام مُوَضِّحًا أنَّه العلم الذي يدافع عن العقيدة بالحجة العقلية؛ لذا حمل هذا العلمُ داخلَه تجسيدًا للصراع المذهبي بين الفرق الإسلاميَّةِ نفسِها وبين تلك الفرق والأديان والمِلَلِ المُخالفة للإسلام، وحاولتْ كلُّ فرقة في خِضَمِّ هذا الصراع الذي لا ينتهي بيان مدى أحقِّيَتِها بملكيَّةِ حقيقةِ العبادة، وأن تصوُّرَها عن الإله هو التصوُّر الصحيح.
يرى أحمد سالم أنَّ الوحيَ عندما نزلَ في شبه الجزيرة العربية لم ينزل في فراغٍ مُطْلَق، وإنما نزل على قوم لهم أديانهم ومِلَلُهم المُخْتلفة، وكان لهذه العقائد حضور واضح في بنية النص القرآنيِّ نفسِه الذي اشتبك مع تلك العقائد اشتباكًا يحاول منازعتَها في أحقيَّة الإسلام.
وبعد اتساعِ رقعة الدولة الإسلامية بفعل الفتوحات كان على الإسلام تحديات أخرى بسبب دخولِ كثير من الحضارت الغريبة عن الإسلام في نسيجِه؛ فكانت مواجهات جديدة بين علماء الكلام وأصحاب المِلَلِ الأخرى من أهل البلاد المفتوحة.
أدَّتْ هذه المواجهة إلى نوع من الانتصار في إثبات الإسلام ذاته، كما أدَّتْ إلى “تَعَدُّدِ تَجَلِّياتِ صورة الألوهية الإسلاميَّة على الأرض، وتَعَدُّد أشكال التَّدَيُّنِ الإسلاميّ؛ فقد أثَّرَتْ هذه الأديان والثقافات في صياغة التَّعَدُّدِيَّة في مجال الفرق والمذاهب الإسلامية”[2].
إعلان
ثنائيَّة الإيمان والإلحاد في الثقافة العربية والإسلاميَّة
“تجاوزَ المؤمنون حدود تفسير العالَم من المادِّيِّ إلى اللامادي، ومن الطبيعيِّ إلى ما وراء الطبيعيِّ؛ لأننا لا يمكن أن نسندَ هذا النظامَ والوجودَ القَصْدِيَّ الكائن في العالَمِ لتلك الطبيعة المادِّيَّةِ الصَّمَّاء”[3].
“العلاقة بينَ الملاحدة والمؤمنين هي علاقة مُمْتَدَّة على مدار التاريخ البشري”[4].
النزوع المادِّيّ لدى الدهريَّة
الدهرية فرقة قديمة في نسيج المجتمع العربي والمسلم منذ القِدَمِ، حاول بعضُهم ربط جذورها بالفرس، وحاولَ البعضُ ردَّ أصولها إلى الثقافة الهنديَّة، ولا يُعْنَى د. سالم بذلك كثيرًا بقدر ما يُعنى بحضورها في الثقافة الإسلاميَّة.
ما هي الدهرية إذن؟ إنَّها نزوع ماديّ خالص يرفض تجاوُزَ حدود الواقع المادِّيِّ والطبيعيِّ؛ فالدهريُّون هم “الذين أنكروا الاعتقادَ في الله، وأنكروا خلقَ العالَم والعناية الإلهيَّة، ولم يُسَلِّمُوا بما جاءتْ به الأديانُ كالشرائعِ السماوية والبعث والعقاب، وقالوا بقِدَمِ الدَّهر”[5]، وأنَّ العالَم صادر عن امتزاج الطبائع الأربعة (التراب، والماء، والنار، والهواء) ليس إلا، وأنَّ الطبيعةَ، والمادَّة، والحركة، والزمان كل هذا قديم (لا أوَّلَ له).
انتشرتِ الدهريَّةُ في أرضِ العربِ قبل الإسلام فيما يرى جواد علي، بل كان لها حضور بعد ذلك في الخطاب القرآنيِّ في قوله: “وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ” (الجاثية: 24)، “وقد أجمعتْ كتبُ التفسير على وجودِ هذه الطائفة”[6].
ولقد صور المقدسي في (البدء والتاريخ) الدهريَّة بشكل إباحيٍّ؛ لنفيهم الإيمان الذي أباح لهم فعل الفواحش واستباحتها، بل “ربط الغزالي [كذلك] بين كفر الدهرية ومدى انهماكهم في الشهواتِ واللذات بما يعني تحقير هذه الطائفة من المنظور الأخلاقيِّ الذي ساد في تصوير الدهرية في كتب التفسير والتاريخ وفي مدونات علم الكلام”[7]، وقد أعاد الأفغانيُّ في رسالته (الرد على الدَّهْرِيِّينَ) تلك الفكرة رابطًا بين الإيمان والأخلاق والفضيلة! يرى سالم أنَّ هذه الفرضية “قد ينكرها الواقعُ؛ لأنَّ أهلَ الإلحادِ ليسوا بالضرورة مُتَحَلِّلِينَ من كافَّةِ أشكالِ القِيَمِ والأخلاق”[8].
الإلحاد في الحضارة العربية والإسلامية
“إنَّ الإلحادَ اليونانيَّ كان يَتَّجِهُ إلى نفي الإله مباشرة، في حين أنَّ الإلحاد العربيَّ كان يَتَّجِهُ إلى نَفْيِ فكرة النبوة”[9].
-عبد الرحمن بدوي.
يُنَبِّهُنا د. سالم أنَّ ارتكازَ الإلحادِ في الحضارة العربية والإسلامية غالبًا لم يكن على نفي وجود الله، ولكنه ارتكز على “نفي نبوة محمد، وعلى القدح في المعجزات الحسية الخاصة به، وعلى التشكيك في صدق القرآنِ”[10].
أبرز مثال على ذلك ابن الراوندي الذي نظر إلى الأنبياء على أنهم مجرد سحرة، وأنَّ المعجزات التي تُرْوَى عن محمد ما هي إلا أكاذيب مُلَفَّقَة، كما طعن في إعجاز القرآن وشكَّكَ به، وكان يرى أنَّ العقل قادر على التمييز بين الحسن والقبيح، بل رأى أن بعض الشرائع الدينية تنافي العقل كالسعي بين الصفا والمروة؛ فهما حجران لا ينفعان ولا يضرَّان، وأنْ لا فرقَ بين الطواف بالكعبة وغيرها من البيوت.
وقد كان الرازي يرى أيضًا ما يُقارِب ذلك؛ فأنكر إعجاز القرآن، وادَّعَى أنه مملوء بالتناقض، وهاجمه من ناحية النظم والتأليف والمعنى، وانتهى إلى أن العقل وحده كافٍ لهداية البشر، ولسنا في حاجة إلى نصٍّ هادٍ، أو نَبِيٍّ مُرْسَل.
لا شكَّ أن علماء الكلام قد قاموا بتفنيد آراء ابن الراوندي والرزاي في مُدَوَّنَاتِ علم الكلام في أبواب النبوة وإعجاز القرآن، إلا أنَّ اهتمامَ د. أحمد سالم لا ينصَبُّ على هذا النوع من الإلحاد، ولكنه ينصب على ذلك النوع الدَّهْرِيِّ الذي ينفي وجودَ الله من الأساس.
عَوْد على بدء: كيف ردَّ علماءُ الكلامِ على الدَّهْرِيِّين /الملاحدة
يُلاحظ د. أحمد سالم أن الأدلةَ التي أقامها المتكلمون على وجود الله تستند على طرح مُسَلَّمَاتٍ في شكلِ أسئلةٍ استنكاريَّةٍ لمقدمات الملاحدة، ومن ثم يبني المتكلمون على هذه المقدمات نتائجَ تتعارض مع الطَّرْحِ الإلحاديِّ.
يرى كذلك أنَّ الأدلة الحجاجية لدى المتكلمين من الصعوبة بمكانٍ عند العوام بل عند أهلِ العلمِ أحيانًا، وأنهم تَتَطَلَّبُ جهدًا فائقًا لفهمها والوقوف عليها، وأنَّ أدلة الإلحاد والإيمان ما زالتْ تتطور وتتغير حسب متغيِّرات كل عصر، وأن المعركة بينهما تأخذ أشكالًا متعدِّدة على مرِّ العصور حتى الآن.
يطرح الكاتبُ أيضًا فكرةَ تَكَافُؤِ الأدلَّةِ وأنها قد تؤدِّي ببعضِ علماءِ الكلامِ إلى سلوك طريق التصوف والإلهام؛ حتى يحقق اليقين المطلوب، أو قد تؤدِّي بهم إلى مقالاتٍ من قبيل “اللهم إيمانًا كإيمانِ العجائز”[11].
إبليس أصل الغواية
“يرى ابن الجوزي أن الدهرية نتجت عن غواية إبليسَ؛ لأنه أوهم خلقًا كثيرًا أنه لا إلهَ ولا صانع”[12].
ورؤية ابن الجوزي هذه صادرة عن عقلٍ دينيٍّ يأبى إلا أن يُدْخِلَ إبليسَ في معادلة الإلحاد والإيمان؛ فبدلًا من عرضِ آراء هذه الفرقة، ومن ثَمَّ الردّ عليها يكتفي ابن الجوزي بالقول بأنَّ إبليسَ أساسُها.
يرفضُ د. أحمد سالم هذا الموقفَ؛ “لأنَّ الإلحادَ الماديَّ الدهريَّ قد يكون موقفًا فلسفيًّا وفكريًّا من العالَم والوجود”.
أصْلُ الخلق: اجتماع الطبائع الأربعة
يرى الدهريون أن أيَّ مخلوقٍ قد كان بفعلِ اجتماعِ الطبائعِ الأربعة (التراب /اليبوسة، والماء /الرطوبة، والنار /الحرارة، والهواء /البرودة)، وتلك هي حجة الدهرية الأولى التي حاولَ علماءُ الكلامِ دحضَها وتفنيدَها.
ومن الردود على فرضية الدهريِّين تلك قولُ المتكلِّمين أنَّ الطبائع الأربعة أَعْرَاض لا يمكن أن تقومَ بذاتِها أبدًا، وتحتاجُ دومًا إلى مَحَلٍّ لِتَحِلَّ فيه، وهي تحدثُ وتفنى كلَّ وقتٍ؛ مما يدلُّ على أنها مخلوقة، ومَحَالُّهَا التي تقوم فيها مَحَلٌّ للحوادث أيضًا.
كذلك رأى المتكلمونَ أنَّ الطبائع الأربعة لها خصائص منفصلة مُتَشَاكِسَة؛ فلا يمكن بحالٍ امتزاج الحرارة مع البرودة مثلًا، ومع ذلك نجد أنَّ امتزاج هذه العناصر /الطبائع الأربعة حادث في الإنسان وغير الإنسان مما يدلُّ على أنها مقهورة على الامتزاج من قبل خالق وصانع.
“إنَّ الله وحده هو الذي مزجَ بين الطبائع المتنافرة، وجمع بينها في تآلف”[13].
ردُّ المتكلمين على القول بقدم الطبيعة والمادة الأولى (الهيولي)
يرى الطبائعيُّونَ أنَّ العالَم يُنْسَبُ إلى طبيعة قديمة، يرفض الباقلانيُّ أن تُعْطَى الطبيعةُ صفةَ الخلق بديلًا عن الله، ورأى أنَّ الطبيعة إما أن تكون قديمة (لا أولَ لها)، وإما أن تكون مُحْدَثَة (مخلوقة)؛ فإنْ كانتْ قديمةً (لا أولَ لها) كان لا بد أن تكونَ الكائناتُ كلُّها قديمةً (لا أول لها)، لكننا نعلم بالضرورة أنَّ تلك الكائنات مُحْدَثَة (مخلوقة لها أول)؛ ولهذا لا يمكن بحال أن تكون الطبيعةُ قديمةً؛ “لأنَّ كلَّ ما خرج عن الطبيعة حادث (مخلوق)، ومن ثمَّ لا يمكن أن ننسبَ الوجودَ إلى الطبيعة؛ لأنها حادثة”[14].
ويرى الدهريُّون كذلك أنَّ المادَّةَ القديمة (الهيولي) هي أصل العالَم الذي وُجِدَ منها، ويردُّ عليهم البغداديُّ مثَلًا أنَّ العالَمَ يمتَلِئ بجواهرَ كثيرةٍ (الجوهر هو الأساس الذي يُشَكِّلُ جسمًا ما وتقوم فيه الأعراض)، ولا يمكن بحالٍ أن تكون تلك الجواهرُ الكثيرة الموجودة في العالَم ناتجةً عن جوهر واحد وهو الهيولي؛ ولأنَّ الأعراض إن قامتْ به؛ فإنها تغير صفته ولا تغير جوهرَه، وكذلك لا يمكن بحالٍ أن يكونَ الهيوليُّ جواهرَ كثيرة؛ لأنه إن كان جواهرَ كثيرة؛ فإنه لن يخلوَ من الاجتماع والافتراق، وهما عَرَضَانِ في حينِ أنهم يقولون أنَّ الهيوليَّ خالٍ من الأعراض.
يرى الدهريون كذلك المادةَ قديمةً، ويرفض المتكلمون ذلك؛ لأنَّ الصورةَ تلازم المادةَ دائمًا، ولأنَّ تلك الصورة تقبل العدم؛ فلا يمكن أن تكونَ مادَّتُها قديمةً بحالٍ، ويستحيل القول بأنَّ المادةَ يمكن أن تكونَ دون صورةٍ؛ لأنه لا شيءَ له وجود ماديٌّ من غير صورة، ولا يبقى إلا أنْ يقولوا إنَّه قبل هذه الصورة المعدومة كان قبلها صورة أبسط منها، وهذا خلاف ما يفترضونه من كون الصورة الأولى هي أبسط الصور وليس فوقها ما هو أبسط منها.
الصراع بين الثنوية والتوحيد
الثنوية: من هم؟
يقول الثنوية على اختلاف طوائفهم بوجودِ إلهين للعالَم هما النور والظُّلْمَة (الخير والشر)، وتشمل الثنوية كل أديان فارس القديمة كالمانوية (يقولون بوجود أصلين قديمين للعالَم هما النور والظلمة)، والمجوس (يقولون بقدمِ النور وحدوث الظلمة)، والديصانيَّة (يقولون بحياة النور وموت الظلمة)، والمرقونية (يثبتون مُتَوَسِّطًا بين النور والظلمة)، والمزدكيّة (يدعون إلى مذهب ديني يشبه الشيوعيَّة).
دخل كثير من أصحاب الأديان الثنوية في الإسلام وهم كارهون له، وأسلمَ بعضُهم وتأثَّرَ إسلامُه بدينه القديم وثقافته التي كان عليها؛ فحدث نوع من التَّضَادِّ بينَ هؤلاءِ والثقافة الإسلامية الغالبة، وقد أسهمتِ الشعوبيَّة (حركة اجتماعية قومية تُفَضِّلُ العجم على العرب) في انتشارِ الزندقة؛ ذلك اللقب الذي يكاد يكون حِكْرًا على القائلين بالثنوية، ثم اتَّسَع ليشملَ كلَّ صاحبِ بدعة ومجون وإلحاد.
لم تَكتفِ الثنويةُ بالدعوة إلى مذاهبهم الدينية القديمة، ولكن توغلوا في مناصبِ الدولة من وزارة وكتابة وغير ذلك، بل عملوا على هدمها والثورة عليها؛ فاستعمل الخلفاءُ العباسيُّون القوةَ في تَتَبُّعِهم والقضاء عليهم، ولم يسلم حتى المأمون من ذلك؛ فأعمل فيهم القتلَ.
يقول الخليفة المهدي في نصيحة وجَّهَها لابنه الهادي:
“إن صارَ لك هذا الأمر؛ فَتَجَرَّدْ لهذه العصابة (أصحاب ماني)؛ تدعوا الناسَ إلى ظاهرٍ حَسَنٍ، ثم تخرجُ من هذا إلى عبادةِ اثنين: أحدهما النار، والأخر الظلمة”[15].
الرد على الثنوية بين أبي الهذيل العلاف والباقلاني والقاضي عبد الجبار
أبو الهذيل: السِّجال الحواريّ
يُنْقَلُ عن أبي الهذيل العلاف بعضُ الحجاج الحِوارِيّ مع الثنوية ومن ذلك حواره مع الشاعرِ صالح عبد القدوس حول نشوء العالم عن أصلَيْنِ قدِيمَينِ بامتزاجِهِمَا، ونقاشه معه حولَ مفهوم الشكِّ الجَدَلِيّ، وما نُقِلَ عنه من حوارٍ مع ميلاسي المجوسي حول كون الإنسان مخلوقًا بامتزاجِ الأصلينِ القديمَينِ: النور والظلمة.
في حوارِه مع ميلاسي ينقدُ أبو الهذيل فكرة امتزاج الإنسانِ ومجيئِه من أصلَيِ النور والظلمة؛ إذ يرى ميلاسي أنَّ النور امتزج بالظُّلْمة حتى يؤدِّبَه ويُغَيِّرَه، وهنا يتساءل أبو الهذيل: هل يقبل الظلامُ الأدبَ؛ فينقلب عن طبعه الذي هو الظلمة؟! يرى ميلاسي أنَّ الظلمة لا تنقلب عن طبعها أبدًا، وهنا يهزَأُ به أبو الهذيل أنْ لا فرق بين قول المجوسي وقول من قال للنار: كوني باردة!
يطرحُ الثنوية فكرةً أخرى لا تسلمُ من عقلِ العلافِ؛ لتفسير امتزاج النور بالظلمة، يقولون إنَّ الظلام قد وَثَبَ على النور؛ فأسَرَه، وهنا يجيبهم العلاف بقوله إنَّ أسرَ الظلامِ النورَ لا يكون إلا عن فَضْلِ قُوَّةٍ، وهذا خير، وكون النور مأسورًا بالظلمة؛ فهذا شرّ؛ فكيف يكون في الخير (النور) شر، وفي الشر (الظلمة) خير؟!
الباقلاني: عرضيَّةُ النور والظلمة، ودليل التمانع
ترى الثنويةُ أنَّ الأجسامَ مُمْتَزجَةٌ نورًا وظلمةً، وينتقد الباقلانيُّ هذه الفكرة؛ إذ يرى أن النورَ والظلمةَ يستحيلُ أن يكونَا جِسْمَيْنِ؛ لأنَّ الأجسامَ كلَّها من جنسٍ واحد، وهذا الجنس الواحدُ تقوم به الأعراضُ المختلفةُ؛ فالأجسام كلها ليس فيها نور ولا ظلمة، ولا اجتماع ولا افتراق، “والنور والظلمة حادثان ليسا بقديمَيْنِ؛ لأنهما يتَرَدَّدانِ على الشخص؛ فمرة مضيئًا منيرًا، ومرة أسودَ مظلمًا، وكلاهما يحلُّ محلَّ الآخر؛ فهما يحدثان ويتجدَّدَانِ على الأجسام”[16]، وبذلك يدحضُ الباقلانيُّ الفكرَ الثنويّ عن طريق القول بعَرَضِيَّةِ النورِ والظلمة.
يطرحُ الباقلانيُّ كذلك دليلَ التمانع ردًّا على الثنوية؛ فيستحيل أن يكون هناك إلهانِ للعالَم؛ لأنه لو أراد أحدُهما شيئًا، وأراد الآخرُ ضدَّهُ يستحيل إنفاذ الإرداتين كليهما؛ فلا يبقى حينئذٍ إلا إتمام إرادة وردّ أخرى، وبذلك يمكن القول أنَّ من تمَّ مرادُه؛ فهو الإلهُ حقًّا، وأنَّ من تخلَّف مرادُه؛ فليس بإلهٍ على الحقيقة.
القاضي عبد الجبار: نقد فاعلية النور والظلمة
ترى الثنويةُ أنَّ النورَ والظلمة يفعلانِ الخير والشرَّ طبعًا أو اختيارًا، الأمر الذي يرفضه القاضي عبدُ الجبار؛ لأنَّ الفعلَ يستحيل أن يكونَ إلا من قادر مُخْتَار كالإنسان بكماله دون أجزائه؛ فالإنسان بكماله يملك إرادة واحدة عنها يقع الخيرُ والشرُّ، والحسن والقبح، والعلم والجهل وغير ذلك.
ماذا إنْ كانَ الفعل الصادر عن النور والظلمة بالطبع لا بالاختيار؟! يرى عبد الجبار أنَّ النورَ منافٍ للظلمة طبعًا؛ فيستحيل امتزاجهما لذلك؛ لأن الشيء لا ينقلب إلى ضده، ولا يعني الامتزاج سوى تَغَايُرِ الطبع.
يقول القاضي عبد الجبار:
“وطبعهما يقتضي التبايُنَ؛ فكيف يصحُّ المزاجُ فيهما؟”[17].
والنورُ ليس دائمًا مصدرًا للخير في نظر القاضي عبد الجبار؛ فقد يكون “نور النهارِ سببًا لظهور من يطلبه العدوُّ؛ فيؤدِّي إلى قتله”[18]، وليستِ الظلمة دائمًا مصدرًا للشرِّ؛ فقد تكون سببًا لأن يتخفَّى مظلوم من ظالمٍ يريد إيذاءه.
السِّجال الكلامي بين الأديان الإبراهيميَّة
إنه في ظِلِّ المدِّ الإسلاميِّ على مساحَتَي الفكرِ والأرض لم يقف النصارى ولا اليهود مكتوفي الأيدي في الدفاع عن إيمانهم وعقائدهم، خاصَّة النصارى الذين “دَبَّجُوا الرسائلَ اللاهوتيَّة في الدفاعِ عن أنفسِهم، وعن عقيدتهم، وفي التشكيك فيما جاء به الإسلام، ولا شكَّ أنَّ هذا كان حافزًا على إثارة المسلمين للردِّ عليهم وتفنيد عقائدهم”[19]، وكذلك اهتمَّت كتب المِلَلِ والنِّحَلِ بِعَرْضِ آراءِ وتَوَجُّهَاتِ اليهود والنصارى.
يرى د. أحمد سالم أنَّ الأديان الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) تَنْتَمي إلى جذر واحد وهو الجذر الإبراهيميّ، ومع ذلك نظر كلُّ دين إلى نفسه على أنه صاحب الدين القويم وأنه قد حاز الحق بإطلاق؛ فكانتْ “أزمة الحوار بين الطرفين على المستوى اللاهوتي، والذي يبدو وكأنه حوار الطرشان؛ فكل واحد لا يسمع إلا نفسَه، ولا يقتنع إلا بما يعتقده هو دون غيره”[20].
التَّأثير اليهودي والمسيحي في الإسلام
دخل كثير من اليهود والنصارى في الإسلام وكانوا يفكِّرون في العقائد الإسلامية من خلال العقائد التي كانوا عليها في السابق، كما أدَّى الجدل اللاهوتي بين الأديان الإبراهيمية إلى أن يؤثِّرَ بعضُها في بعض.
إنه يُظَنُّ مثلًا أنْ كان لليهود بعضُ الأثر في ظهور المعتزلة؛ فيُرْوَى أنَّ أولَ من قال بخلق القرآن لبيد بن الأعصم الذي أورثها ابن أخته طالوت، ويُرْوَى أيضًا أنَّ أول من قال بها المغيرة بن سعيد العجلي الذي كان من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، ويُرْوَى أن بشرًا المريسي أحد أكبر الدعاة إلى خلق القرآن كان أبوه يهوديًّا، بل يرى البعضُ أنَّ اسم المعتزلة نفسه مأخوذ عن فرقة الفروشيم اليهودية.
وكانت لمحاورات المعتزلة والنصارى الكثيرة تأثير بالغ في صياغة الفكر المعتزلي في مسألة الذات والصفات؛ إذ اتَّهم المسيحيون المسلمين أنهم قائلون بأقانيم كثيرة، وأنه لا فرق بين الأقانيم المسيحية الثلاثة وصفات الله عند المسلمين؛ فانتهى المعتزلة إلى عقيدة تقول أن الصفات هي عين الذات.
السجال الإسلامي اليهودي حول الشريعة
كانتْ صورة الإله عند اليهود أقرب ما تكون إلى المسلمين؛ إذ يقولون بإلهٍ واحدٍ؛ فلم يكن هناك تقادح بين المتكلمين واليهود حول صورة الإله اليهودي، بل كان السجالُ دائرًا حول الشريعة الموسوية ومدى اتِّصال هذه الشريعة بالشريعة الإسلامية ومدى انفصالها عنها.
يرى القرافيُّ مثلًا في معرض حديثه عن الشريعة الموسوية أنَّ فيها أنواع كثيرة من الإحسان؛ لقربها وشبهها بالشريعة الإسلامية، ورغم إشادته بها إلا أنه لم يُبْرِزْ مدى تأثُّر الشريعة الإسلامية بالشريعة اليهودية؛ فالشريعة الإسلامية في حقيقتها تستقي أفكارها ومبادئها من نفس الجذر والمنبع اليهودي، وليستْ مُنْبَتَّةَ الصلة عن الشرائع الموسوية.
“تكشف [كثير من الشرائع اليهودية] عن وحدة المصدر في الأديان الإبراهيمية، والواضح أنَّ ما هو مُتَّصِل بين اليهودية والإسلام في أمر التشريع أكثر بكثير مما هو منفصل بينهما”[21].
السجال الإسلاميّ المسيحيّ حول العقيدة
تذهب معظمُ الطوائف المسيحية إلى القول بالتثليث والاتِّحاد عدا أتباع الآريوسية الذين قالوا بالطبيعة البشرية للمسيح؛ فالمسيحي الأصيل -وجهة نظر المسلمين- هو من يقول بالتوحيد، وأن الطوائف المُثَلِّثَة دَخيلة على المسيحية ولم تلبث أن طَغَتْ عليها.
الحجاج المسيحي في القرن الثالث الهجري: يوحنا الدمشقي نموذجًا
ألَّفَ يوحنا الدمشقي كتابًا جاء بعنوان (الهرطقة المائة) أبرز فيه موقفه من عقيدة الإسلام، وبيَّنَ مدى عجز المسلمين عن فهم العقيدة المسيحية وأسرارها.
“ما اعترفنا به لِتَوِّنَا معروف على أنه كفر وإشراك في الدين بالنسبة إلى المسلمين الذين لا يمكنهم أن يفقهوا هذه الحقائق الإلهية، ولهذا السبب عينه علينا أن نساعدهم بِحَمِيَّةٍ؛ ليعرفوا المُخَلِّصَ”[22].
-يوحنا الدمشقي
يرى يوحنا أنَّ المسلمين يعرفون التوحيد مُشَوَّهًا، وأنَّ التوحيد الحقيقي هو التوحيد المسيحي القائم على سر التثليث، وحاول أن يقيم الحجة على المسلمين ببعض ما جاء في القرآن من أنَّ المسيح كلمة الله وروحه؛ فيرى أنَّ الكلمة والروح لا ينفصلان عن من يكونان فيه بالطبيعة؛ فعلى هذا يكون المسيحُ مُتَّحِدًا بالله وإلا كان اللهُ بلا روح وكلمة.
يطعنُ يوحنا كذلك في مصداقية القرآن ككلام الله، ويشكك في نبوة محمد، ويتَّهِمه بالتعرف على العهدين: القديم والجديد عن طريق الراهب الآريوسي ورقة بن نوفل، وأنه انتحل بعضًا من ذلك، وادَّعَى نزول الوحي عليه من السماء.
مرحلتا الردِّ على النصارى
مرَّ الجدل الإسلامي المسيحي بمرحلتين، اتَّسَمَتِ الأولى بالبعدِ عن التَّشَنُّج والتعصب والسباب والسخرية، وكانتِ الردود فيها من الطرفين تتوسَّلُ العقل والمنطق ومحاولة التماس البرهان، بل ابعتدت اللغةُ فيها عن التكفير كثيرًا، أما المرحلة الثانية؛ فاتسمتْ بالعنف والتكفير، وبدأت هذه المرحلة بعد مجيء الحملات الصليبية على الشرق وارتكابها كثيرًا من المجازر في حق المسلمين وغيرهم؛ فتأثَّر موقف العلماء المسلمين بذلك؛ فجاءت ردودهم عنيفة عنفَ هذه الحملات المسيحية على الشرق.
الجدل اللاهوتي العقلاني: القاضي عبد الجبار نموذجًا
اعتنى المسلمون عناية شديدة بالرد على النصارى منذ فترة مبكرة جدًا من تاريخ الإسلام، وقدموا الحججَ اللاهوتية ضد عقائد النصارى من تثليث واتحاد وغير ذلك، وهنا سنحاول عرضَ نقد القاضي عبد الجبار المعتزلي لعقيدَتَي التثليث والاتِّحاد
نقد التثليث
يرى القاضي عبد الجبار أن التثليث ليس معقولًا؛ فقول النصارى أنَّ الإله جوهر واحد بثلاثة أقاليم ليس ممكنًا لسبب بسيط وهو أنَّ الجوهرَ لا ينقسم ولا يتجزَّأ ولا يمكن تبعيضه، وإذا قلنا أنَّ الجوهر يحتوي على ثلاثة أقانيم؛ فإنَّ هذا يعني تَجَزُّؤَه، وهذا تناقض يشبه أن نقول إن الشيء معدوم وموجود، أو قديم ومحدث في آنٍ واحد، وبجانب ذلك؛ فإنَّ الله ليس بجوهرٍ أصلًا؛ لأنه لو كان جوهرًا لكان مُحْدَثًا، وقدمه ثابت لا جدال فيه، وبذلك يُثْبِتُ عبد الجبار فساد قولهم من جهتين؛ الأولى: عدم إمكان تَجَزُّؤ الجوهر، والثانية: أنَّ الجوهر يقتضي الحدوث والله قديم ليس بحادث.
نقد الاتِّحَاد
يرى المسيحيون أنَّ مشيئة الله قد اتَّحَدَت بمشيئة المسيح؛ فصارتا مشيئة واحدةً. ينقدُ عبد الجبار هذه الفكرة عن طريق القول بأنَّ القديم (الله) يريد بإرادة لا تكون في مَحَلٍّ ما؛ لأنَّه ليس بجسم، وأنَّ المسيح جسمٌ؛ فإذا أراد فإنَّ تلك الإرادة لا بد أن تحلَّ في بعض جسمه؛ فلا يصح لذلك أن تكون إرادةُ الله هي إرادة المسيحِ؛ لأنها لا يمكن أن تحلَّ في بعض الله، وإذا كانتْ إرادةُ الله غير إرادة المسيح؛ فلا يمكن أن يكون فعلهما (الله والمسيح) واحد؛ لأن الفعل لا يتخص إلا بمن صدرت مِن جهته.
ولو جاز أن تَتَّحِدَ المشيئتان للزم أن نوجبَ للقديم سائر ما يكون في قلب المسيح؛ فنوجب له (للقديم) الجهلَ والاشتهاءَ والظن والندم وغير ذلك من الصفات الإنسانية المتعلقة بشخص المسيح، “وكل ذلك يستحيل عليه تعالى؛ فيجب إبطالُ ما قالوه في مشيئته أنها مشيئة له”[23].
السِّجال الإسلامي العنيف: القرافي وابن تيمية نموذجًا
القرافي: الأجوبة الفاخرة
كان للحملات الصليبة كما ذكرنا سابقًا تأثير كبير على موقف المسلمين من النصارى وعقائدهم، وتجلَّى هذا الموقف عنيفًا في الكتب التي أُلِّفَتْ ردًّا عليهم، ومن ذلك كتاب القرافي الذي ألفه ردًّا عليهم من منطلقات قرآنية وعقلانية وسماه: (الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة في الردِّ على المِلَّةِ الكافرة)، ويُعَدُّ هذا الكتاب تجسيدًا للعداء الصريح بين المسلمين والمسيحيين في هذا العصر، مُمَثِّلًا للغة الحادة والعنيفة التي اتَّسمَ بها السجال فيه.
ينتقد القرافيُّ صورة الإله عند المسيحيِّين ويرى أنهم لا يفهمونه، وأنهم يعبدون ثلاثة آلهة، وهم كمن لم يفهم حقيقة القتل؛ فلما قتل أنكر على من ينسب إليه فعلَ القتل.
“فينبغي لهذه الطائفة النصرانية أن تبكي وتنوح على فقد العقل قبل أن تبكي على فقد الدين”
-القرافي
والأناجيل عنده حكايات وتواريخ وكلام كفرة، ويرى أنَّ تاريخ الطبري عند المسلمين أصح نقلًا من هذه الأناجيل، ثم يتساءل: “أين هذ الإنجيل المُنَزَّل من عند الله تعالى، وأين كلماته من بين هذه الكلمات؟”[24].
ابن تيمية: الجواب الصحيح
أما ابن تيمية؛ فإنه أَلَّفَ كتابًا أسماه (الجواب الصحيح لمن بَدَّلَ دِينَ المسيح)، يناقش فيه عقائد المسيحيين عن طريق “تحليل مضامين القرآن أو الحجج اللاهوتية أحيانًا، مُوَظِّفًا ما وَرَدَ في كتبِ علمِ الكلام في مراحله المُبَكِّرَة”[25].
لم يكن هدفُ ابن تيمية الحقيقي بيان بطلان دين النصارى فحسب، ولكن تكفير أيّ طائفة إسلامية تشابه عقائد النصارى من قريب أو بعيد.
يقول ابن تيمية:
“فبمعرفة حقيقة دين النصارى وبطلانه، يُعْرَفُ بطلانُ ما يُشْبِهُ أقوالَهم من أقوالِ أهل الإلحاد والبدع”.
كيف حدثَ تَسْيِيسُ الإلهيّ /الدينيِّ في الإسلام؟
“الصراع البشريّ حول السياسة كان يبحث عن الإقصاء والتفكير عبر أصول الاعتقاد”[26].
يرى د. أحمد سالم أنَّ المسلمين اختلفوا بدايةً في السياسة ثمَّ اختلفوا بعد ذلك في أصولِ العقائد، بل كان من المفترضِ أن تكون المساحة التي تجمعهم أكبر بكثير من المساحة التي تُفَرِّقهم، ورغم ذلك استُعْمِلَتْ أدواتُ الإقصاء من تكفير وقتل بفعل السياسة؛ فكيف حدث ذلك؟
صورة الإلهيِّ في الجدل الإسلامي الإسلامي
قبل الإجابة عن هذا السؤال يحاول الكاتبُ إعطاءنا نبذةً عن صورة الإلهيِّ في الجدل الإسلاميِّ الإسلاميِّ؛ فيرى أنَّ المسلمين على اختلاف فِرَقِهِم ءامنوا بإلهٍ واحدٍ، وأقاموا الأدلة الكلاميةَ على وجوده، وكان دليلُ حدوثِ العالمِ هو الدليل الشائع بدايةً، ثم استعملوا دليل الممكن والواجب بعد ذلك عندما تأثَّرَ علمُ الكلام بالفلسفة.
أقرَّ المسلمون بما يُسَمَّى بتوحيد الربوبيَّة (يعني الإيمان بأنه الإله الوحيد المُسْتَحِقّ للعبادة)، وتنازعوا حول مفهومِ توحيد الألوهية الذي ينفي وجود أي وسائط بين العبد وربه؛ وقام أصحابُ النزعاتِ السلفية بتكفيرِ كل من يرى نوعًا من التوسُّطِ بين الإنسانِ وخالقه.
اختلف المسلمون كذلك في مسألة الأسماء والصفات؛ فأثبَتَتِ الصِّفَاتِيَّةُ من السلف الصفاتِ لله تعالى كما وردتْ دون أي نوع من التأويل، ورأى المعتزلة أن الصفات ما هي إلا عين الذات الإلهية، ورآها الأشاعرةُ زائدةً على الذات، ثم تنازعوا حول صفات الأفعال التي قال المعتزلة بأنها مخلوقة كصفة الكلام، ورأى الأشاعرةُ قِدَمَهَا، كما أثبتَ المُجَسِّمَةُ الصفاتِ الجسيمة للذات الإلهية على منوال الصفات الجسمية للبشر.
كما تنازعَ المسلمون حول الأسماء الإلهية كونها توقيفية أم لا؟ ذلك الخلاف الذي وصفه الغزالي بـ “الطويل الذيل، القليل النَّيْل”[27]، ويرى الرازي أنه كان أولى بالعقلاء أن لا يجعلوا مثل هذه المواضع موضع خلافٍ أصلًا، ورغم ذلك فإنَّ مسألة الأسماء الإلهية تحتلُّ مكانة بارزة عند أهل التصوف في أورادهم الخاصَّة، كما تُمثِّلُ طرف اتِّصال الله بالعالم وتَجَلِّيهِ فيه.
مسألة خلق القرآن ودورها في تسييس العقائد
وقع خلاف بين المسلمين في مسألة القرآن هل هو كلام الله قديم أم مُحْدَث؟ فرأى المعتزلةُ ومن وافقهم إلى كونه مُحْدَثًا مخلوقًا، ورأى مخالفوهم أنه قديم قِدَمَ الله، وتحوَّلَت هذه المسألة إلى أداة تكفير بين الطوائف الإسلامية رغم أنها لا تستحق كلَّ هذا التضخيم الذي نالتْه.
يرى أحمد سالم أنَّ السبب في ذلك أنَّ القائلين الأوائل بخلق القرآن أمثال جهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وعمر المقصوص، كانوا يخرجون على سلطة بني أمية بجانب قولهم بالخَلْقِ؛ فاستعملتِ السلطة آراءَهم التي شنَّعَتْها بمباركَة الفقهاء من أجل قتلهم والتَّخَلُّصِ منهم.
والدليل على أن الخلاف اللاهوتيَّ في هذه المسألة لم يكنِ السبب في تكفير المسلمين بعضِهم بعضًا أنَّ المعتزلة كانوا على الساحة في عهد العصر الأموي، وكانوا ينفون الصفات ويقولون بالخلق إلا أنَّ الحكام لم يتعرَّضُوا لهم بأذىً؛ لأنهم كانوا بعيدين كلَّ البعد عن السياسة.
اعتلى المعتزلةُ شئون السلطة أيام المأمون وامتحنوا المتكلمين والفقهاء في مسألة خلق القرآن، وحاولوا جعلها مذهبًا رسميًّا للدولة، ولما انقلبتِ السلطةُ على المعتزلة أقصتهم وطاردتهم وامتحنتهم؛ فذاقوا من نفس الكأس الذي أذاقوه غيرهم، وقد كانت تلك سقطة عظيمة للمعتزلة.
“وهكذا فإنَّ ما تعترف به السلطةُ السياسيةُ من مذهبٍ دينيٍّ يكون هو المذهبُ السائدُ، والذي يملك الحقَّ، والباقي يمكن إقصاؤه وتكفيره من خلال هذه السلطة، وإذا ما تَغَيَّرَتْ أحوالُ السياسةِ في مواقفها تتغير مواضعُ ترسيم المذاهبِ والفرق”[28].
مَنْشَأ الخلاف والإقصاء: مسألة الإمامة
“أَوَّلُ ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيِّهم اختلافهم في الإمامة”[29].
-الأشعري
ينتهي الكاتبُ إلى نتيجةِ أنَّ الاختلاف بين الفرق الإسلامية قد أخذ منحنىً عنيفًا ليس بسبب الخلافِ اللاهوتي، وإنما بسبب اختلافهم في مسألة الإمامة؛ فقد كان الخلافُ فيما بينهم أشدّ حدَّة من خلافهم مع أصحاب العقائد المُغَايرة؛ فــ “الصراع بين الفرق الإسلامية كان شديدَ الأثر؛ لأنه كان صراعًا حول من يملك الأحقِّيَّةَ في السلطة”[30].
ترى الشيعةُ أنَّ الإمامةَ أصل من أصول الاعتقاد الديني، وأنها بالنَّصِّ على الهاشميِّينَ من أبناء علي بن أبي طالب، وترى السنة أنَّ الخلافة تكون بالاختيار في قريش لا في الهاشميين خاصة، ويرى الخوارجُ أنَّ الإمامة بالاختيار، ويصحُّ أن تكون في أي أحدٍ من المسلمين ما دام عادلًا مُؤَهَّلًا لشؤون الحكم والإدارة.
أصل الخلاف إذن كان سياسيًّا، ثم تحوَّل إلى خلاف دينيٍّ بإدراج مسألة الإمامة ضمن العقائد الدينية، خاصَّة إذا ما وضعنا في اعتبارنا آراء الفرق الإسلامية في مسألة الخروج على الحكام الظلمة؛ إذ ترى أهلُ السنة عد جواز الخروج على الحكام مخافةَ حدوث الفتنة، وترى المعتزلة جواز الخروج لكن بشرط القدرة، ورأتِ الخوارجَ وجوب الخروج ولم يشترطوا شيئًا، هذا الأمر أدَّى إلى نوع من الصراع بين هذه الفرق، وكان مدعاةً إلى الكفير المتبادل في مسألة ليست من صلب الاعتقاد ولا من أصوله.
كان تكفير الخوارج مثلًا لا يتعمد إلا على قولهم بوجوب الخروج على الحاكم الظالم بالسيف؛ فيقول أحمد بن حنبل: “أما الخوارجُ؛ فلا يرون للسلطان عليهم طاعةً، ولا لقريشٍ عليهم خلافةً، وأشياء كثيرة يخالفونَ فيها الإسلامَ وأهلَه، وكفى بقومٍ ضلالةً أن يكون هذا رأيُهُم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء”[31].
خاتمة: حقيقة الصراع اللاهوتي
ينتهي كاتبُنا إلى حقيقة أنَّ الصراعَ بين المسلمين وغيرهم كان هادئًا يقوم على الججة والبرهان، ويُقَارَعُ فيه الدليلُ بالدليلِ، ولم تظهر آلية الإقصاء والتكفير فيه إلا في مرحلة متأخرة بعد الحملاتِ الصليبية على الشرق وما ارتكبتْه.
كما أن الصراع الذي كان دائرًا بين الطوائف الإسلاميةِ نفسِها لم يكن صراعًا لاهوتيًّا فحسب، وإنما كان الصراعُ اللاهوتيُّ مجردَ ستارٍ ظاهريٍّ لمعركة الخلافِ على الإمامةِ والشَّأنِ السياسيِّ.
“ما سُلَّ سيف في الإسلام على قاعدةٍ دينيَّةٍ مثلما سُلَّ على الإمامةِ في كلِّ زمان”[32].
[1] تجلي الإله، جدلية الإلهي والإنساني في الثقافة الإسلامية، د. أحمد سالم، نيوبوك للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 37. [2] المصدر السابق، ص 36. [3] المصدر السابق، ص 47. [4] المصدر السابق، ص 51. [5] المصدر السابق، ص 38. [6] المصدر السابق، ص 40. [7] المصدر السابق، ص 41. [8] المصدر السابق، ص 39. [9] المصدر السابق، ص 42. [10] المصدر السابق، ص 42. [11] المصدر السابق، ص 50. [12] المصدر السابق، ص 44. [13] المصدر السابق، ص 46. [14] المصدر السابق، ص 47. [15] المصدر السابق، ص 55. [16] المصدر السابق، ص 60. [17] المصدر السابق، ص 61. [18] المصدر السابق، ص 61. [19] المصدر السابق بتصرف بسيط بالحذف، ص 70. [20] المصدر السابق، ص 70. [21] المصدر السابق، ص 65. [22] المصدر السابق بتصرف بالحذف، ص 67. [23] المصدر السابق، ص 73. [24] المصدر السابق، ص 75. [25] المصدر السابق، ص 76. [26] المصدر السابق، ص 85. [27] المصدر السابق، ص 80. [28] المصدر السابق، ص 82. [29] المصدر السابق، ص 84. [30] المصدر السابق، ص 87. [31] المصدر السابق، ص 86. [32] المصدر السابق، ص 84.
إعلان
