كيف تحرر المنهج العلمي من منطق أرسطو (2-2)
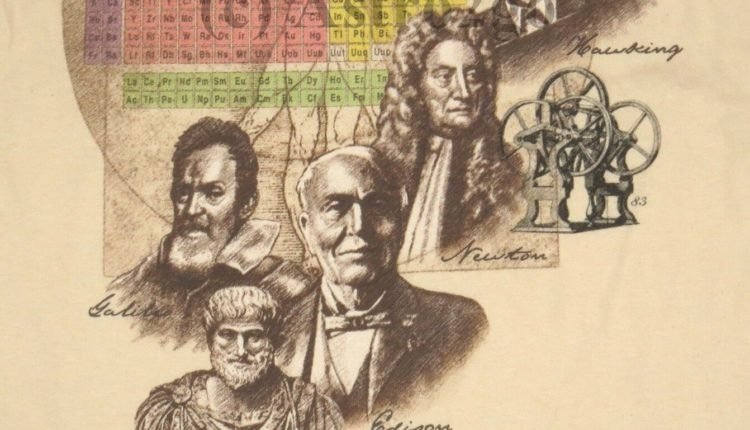
تحدثنا في الجزء الأول عن مقدمة تاريخية عن المنهج العلمي في الحضارات القديمة والقرون الوسطى وعن مقدمة لطبيعيات أرسطو تعين في استيعاب الفروقات الرئيسية بين منطقه وبين المنهج العلمي إبان الثورة العلمية في أوروبا وما بعدها. وهاك سبعة عناصر تلخّص فيما كانت تلك الفروقات وكيف تحرر المنهج العلمي منها:
الاستقراء بين أرسطو وبيكون
عرّف أرسطو الاستقراء بأنه إقامة البرهان على قضية كلية لا بإرجاعها إلى قضية أعمّ منها، بل بالاستناد إلى أمثلة جزئية تؤيد صدقها، على خلاف القياس إذا استندت إلى قضية أخرى أعم منها. لكن ماذا كان يعني أرسطو بالأمثلة الجزئية؟ وعلى ماذا أقام استدلاله؟ لنستعرض المثال الذي ساقه هو بنفسه لنفهم ما كان يقصده بالضبط. يقول: “الإنسان والحصان والبغل إلخ… طويلة العمر. الإنسان والحصان والبغل إلخ… هي كل الحيوانات التي لا مرارة لها. إذًا الحيوانات التي لا مرارة لها طويلة العمر.”
ونلحظ من المثال الماضي نقطتين بالغتي الأهمية، الأولى: هي أي أمثلة يريدنا أرسطو أن نستقصيها في الخطوة الأولى، أهي الأمثلة الجزئية بمعنى الأفراد؟ أم هي الأمثلة الجزئية بمعنى الأنواع؟ وواضح أن الإنسان والحصان… إلخ، الواردة في المقدمات هي الأنواع، فلا هي أفراد الإنسان زيد وعمرو وخالد، ولا أفراد الحصان هذا الحصان وذاك.
والثانية: أنّي لكي أكون المقدمة الكبرى – مثلًا – لا بد لي من عدة قضايا هي في ذاتها قضايا كلية هي: الإنسان طویل العمر والحصان طويل العمر إلخ…، وهذه القضايا لا تحتاج بدورها إلى جزئيات تؤيدها.
أطلق على هذا الاستدلال القياسي الذي تُذكَر الجزئيات في مقدماته بالقياس الاستقرائي لأنه قیاس من حيث صورته العامة واستقراء من حيث استقصاء الجزئيات في مقدماته وهو الذي عناه بيكون بمنهج أرسطو الاستنباطي أو القياسي.
يحدد الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه “المنطق الوضعي” أربعة عيوب للقياس الاستقرائي عند أرسطو توضح الفرق بين ما ذهب إليه وما ذهب إليه فرانسيس بيكون في كتابه “الأورجانون الجديد”. الأول: أن الجزئية الواحدة في استقراء أرسطو هي في الواقع تعميم من الدرجة الثانية.
فالخطوة الأولى هي التعميم من الجزئيات أي أنْ ألاحظ الأشياء التي حولي على اختلافها وأقارن بينها لأستخرج العلامات التي تميز النوع الإنساني من سائر الأنواع وأقول الإنسان دائمًا يتصف بكذا وكذا.
والخطوة الثانية في التعميم هي أن أبحث في الأفراد الذين يتقرر بحكم التعريف أنهم من بني الإنسان فأرى أنهم طوال العمر، وعندئذ أقول الإنسان طویل العمر. قد يقال دفاعًا عن أرسطو إنّ خطوة التعريف لا تأتي نتيجةً للمشاهدة الحسية للجزئيات على الرغم من أننا نری خصائص الجزئيات وصفاتها بالحواس فنعلم أنها مؤيدة للتعريف إنما التعريف ندركه بالحدس العقلي المباشر، فبالعقل – لا بالحواس – عرفت أن صفة الحيوانية وصفة التفكير ترتبطان ارتباطًا ضروريًا في الكائن الذي يكون إنسانًا كالطفل الذي يتعلم بالخرزات أن 2+2=4 لتتكشف له الحقيقة الرياضية ممثلة في جزئية من جزئياتها لا ليستمد الحقيقة الرياضية من تلك الجزئية، قد يقال ذلك دفاعًا عن أرسطو ونحن نسلّم به جدلًا دون اقتناع بصدقه؛ لأن استطراد الحديث فيه يخرجنا عن سياق الموضوع نسلّم به جدلًا لنسأل وما الرأي في الخطوة الثانية التي تأتي بعد التعريف؟ أليس من الضروري فيها أن أرجع إلى الملاحظة – ملاحظة زيد وعمرو وخالد حتى يتسنى لي أن أدخلها مع غيرها من الحقائق في المقدمة التي أستعين بها في الاستدلال الاستقرائي؟ إنْ كان ذلك كذلك فالأساس الذي بنى عليه أرسطو استقراءه لم يكن يصلح أن يقام عليه البناء بل كان لا بد له من خطوة سابقة.
الثاني: استحالة استقصاء الجزئيات استحالة منطقية. فإذا كان أرسطو لا يقصد بالجزيئات الأفراد وقد أغناه حدسه العقلي للبغل عن استقصائها بغلًا بغلًا ليعرف أن البغل طويل العمر وليس له مرارة، لكنه بعدئذ يأتي لإحصاء الأنواع كلها إحصاءً كاملًا لا يغني عنه الحدس العقلي في شيء ـ حسب منطقه ـ فمن ذا أدرك أن قائمة الأنواع التي لاحظت أنها ليس لها مرارة هي كل ما هنالك من أنواع من هذا القبيل في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل على السواء؟
الثالث: وهو أنه حتى لو وفق في حصر الجزئيات جميعًا في مقدماته لما بقي هناك استدلال نستدله بالنسبة إلى شيء نصادفه. فافرض مثلًا أن النتيجة التي أصل إليها بالعملية الاستقرائية كانت بعد أن أستقصي كل أجزاء المادة فأجد أن كل مادة تتعرض للجاذبية، فأين الاستدلال إذًا؟ إنما يكون الاستدلال حين يصادفني شيء لم أكن قد بحثته بذاته ضمن الأمثلة التي أدت بي إلى النتيجة فأستدل أن الحكم الذي في النتيجة لا بد منطبِق عليه هو أيضًا بالرغم من أني لم أكن قد بحثته. مثال ذلك أن أبحث بعض أجزاء المادة فأجده معرّضًا للجاذبية فأستنتج أن كل مادة هي كذلك معرضة للجاذبية، وبعدئذٍ يصادفني حجر فاستدل أنه لا بد هو الآخر معرض للجاذبية.
الرابع: يجب التفرقة بين نوعين من القضية الكلية من حيث معنى التعميم، فهنالك قضية كلية يكون تعميمها عبارة عن تلخيص للجزئيات الكثيرة التي مرت بتجاربنا مثل كل طالب في الجامعة يحمل الشهادة الثانوية، وقضية كلية يكون تعميمها غير قادر على تلخيص المفردات التي وقعت لنا في التجربة، بل يكون تعميمها ضروريًا في أي زمان ومكان مثل كل مثلث سطح مستوٍ محوّط بثلاث خطوط مستقيمة ولو كان منطقيًا مع نفسه لما أجاز لنفسه أن يستنتج من المقدمات إلا نتيجة كهذه: كل السينات التي بحثتها ولاحظتها هي ص لأنه ليس هناك مانع منطقي أن تظهر سينات جديدة غير التي بحثها ورأى أنها تتصف بالصادية. لكن هذا المأخذ الرابع مردودٌ عليه من أرسطو نفسه إذ تراه يذكر في التحليلات الثانية مصدر آخر تستمد منه القضايا الكلية العامة تعميمًا ضروریًا غير الجزئيات المحدودة المحصورة وذلك يكون بالحدس العقلي المباشر كما يقول.
إعلان
من الكيف إلى الكم
كان العلم القديم قائمًا على أساس الصفات الكيفية لا على أساس المقادير الكمية، مثال ذلك أن يُقال عن العالم إنه مكون من العناصر الكيفية الأربعة: التراب والهواء والنار والماء – وهذه بدورها تتألف من ترکیبات من الأضداد الآتية: رطب و یابس، بارد وحار، ثقيل وخفيف. فلم يكن يعنيهم بل لم يكن يطوف ببالهم أن هذه الأضداد إنما هي أضداد من حيث الكيف فقط. وأما إذا أردنا أن نحددها بدرجاتها الكمية فعندئذٍ لا يكون البارد مضادًا للحار، بل يصبح هذان درجات متفاوتة من ظاهرة واحدة فليس عند العلم الحديث شيء اسمه “حار” ولا شيء اسمه “بارد” والذي يعني به هذا العلم هو درجة حرارية مقدارها كذا؛ فالمهم هو التفاوت الدرجي مع أن هذا التفاوت في الدرجة الكمية لظاهرة ما – وهو من العلم الحديث في القلب والصميم – كان يعد عند اليونان أحداثًا عارضةً لا تمس العلم في قليل ولا كثير؛ لأن العلم عندهم هو العلم بالجوهر أو بالماهية الثابتة التي لا تعرف تفاوُت في الدرجة ولا تغيُر في المقدار فللحرارة – مثلًا – ماهية خاصة وللبرودة ماهية أخرى وتعريف هذه غير تعريف تلك، ومؤدى هذا كله أن قياس الظواهر قياسًا كميًا لم يكن عند العلم اليوناني – ولم يكن كذلك عند المنطق الأرسطي – شيئًا ذا بال اللهم إلا أن يكون ذلك من أجل غايات عملية دنيا يترفع عنها العلم النظری فحسبك – إذن – أن تقارن العالم اليوناني الذي لم يجعل ضبط المقادير الكمية جزءًا منه بالعلم الحديث الذي ينصرف بكل اهتمامه وفي كل خطوة من خطواته إلى القياس الكمي للظواهر وتصويرها تصويرًا رقميًا رياضيًا لتعلم أن الشقة بين العلمين بعيدة، وأن منطق الأول يستحيل أن يصلح منطقًا للثاني.
وهاك مثال الحركة كيف تصورها اليونان وكيف يتصورها العلم الحديث؛ فبدل أن تُعد الحركة ضربًا من التغير يطرأ على الوضع المكاني وهو تغير يقاس مقداره و يشغل فترة من الزمن يقاس مقدارها كذلك، ولا فرق عندئذٍ بين أن تكون الحركة لجسم ساقط أو لجسم صاعد أو لجسم يتحرك في دائرة كما هي الحال في الأجرام السماوية أقول بدل أن تتجانس الحركة كلها فتصبح ضربًا من التغير يقاس مقداره قياسًا كميًا دقيقًا. كان اليونان يعدون الحركة الدائرية نوعًا قائمًا بذاته، والحركة إلى أمام أو إلى وراء نوعًا آخر، والحركة إلى أعلى أو إلى أسفل نوعًا ثالثًا وهلم جرًا، كلها ضروب من الحركة تختلف کيفيًا بحيث لا يدخل نوع منها في نوع آخر، بل زادوا على ذلك أن نسبوا هذه الأنواع المختلفة من الحركة إلى أنواع الكائنات التي تتفاوت منازلها في سلم الأنواع علوًا وسفلًا فمن الأشياء ما هو بحكم طبيعته الأصيلة دني – كالتراب – تكون حركته دائمًا إلى أسفل.
ومنها ما هو بحكم طبيعته الأصيلة سني – كالنار – تكون حركته دائمًا إلى أعلى ومنها ما يدنو من المرتبة الألوهية فيتحرك أكمل ضروب الحركة وهي الحركة الدائرية -وتلك هي أجرام السماء. فأين هذا كله من تصور العلم الحديث للحركة على أنها بشتى صورها ظاهرة متجانسة إذا تميزت أجزاؤها فهي تتميز باتجاهات الزوايا و بقوة الدفع والسرعة، وهي كلها جوانب يمكن قياسها قياسًا كميًا دقيقًا.
من الغائية إلى الآلية
ومثال الحركة السابق يسلمنا إلى عيب رئيس آخر عند أرسطو، فعندما ربط الفكرة عن تناغم العالم بفكرة الغائية التي تقود الكائنات وحركاتها أو لماذا يتطاير الدخان بينما تسقط الأحجار يرجع أرسطو علة ذلك إلى طبيعة كل منهما التي تحفزه إلى اللحاق بمكانه الطبيعي الأسفل بالنسبة إلى الأجسام الثقيلة، والأعلى بالنسبة للأجسام الخفيفة، فعنده أن كل الأشياء إنما تتحرك لغايتها كما يجذب المغناطيس الحديد. اعترض أبوالبركات البغدادي (1155 م) في نظريته للاندفاع والتى فسرت حركة المقذوفات ومن قبله أيضًا يحيي النحوي (570 م) على تفسير أرسطو الغائي للحركة إلّا أنهما لم يتحررا بالكامل من نموذجه.
أما اليوم ومنذ جاليليو وديكارت وخاصة نيوتن ونظريته فى الجاذبية الكونية أصبحت الفيزياء الكلاسيكية تفسر حركة الأجسام بالأسباب الخارجية الآلية وحدها، أو كما يقول نيوتن:
لقد فرغنا من تفسير ظواهر السماء والبحار بقوة الجاذبية، ولكننا لم نستطِع أن نكتشف علة هذه القوة من الظواهر، وأنا لا أفرض الفروض، وليس للفروض مكان في الفلسفة التجريبية سواء كانت الفروض ميتافيزيقية أو فيزيقية، في هذه الفلسفة -أي التجريبية- تُستنبط القضايا الجزئية من الظواهر، ثم نجعلها عامة بالاستقراء. إننا قانعون بمعرفتنا أن الجاذبية موجودة في الواقع وأنها تؤدي دورها حسب القوانين التي شرحناها.
أو كما يملينا مبدأ العطالة لديكارت الذي يستلزم أن جسمًا متحركًا يواصل حركته المستقيمة المنتظمة بلا نهاية في غياب الاحتكاك ما لم تتغير سرعته أو اتجاهه صدمه جسم آخر ومن ثم فقد أصبح الكون حقل من القوى الفوضوية لا تنتظم إلا في نطاق الصدمات دون أي تناغم أو دلالة معقولة بالنسبة لنا كرصاد.
من تصور الكليات إلى الاسمية
حين نشير إلى مجموعة من الأشخاص لكل واحد على حدة فنقول هذا إنسان وذلك إنسان آخر فهل للشيء المشترك بينها وجود حقيقي أم لا؟ وفق أرسطو الجواب هو نعم؛ فالإنسانية شيء واقعي مثلها مثل باقي الكليات مثل کلمات الحيوان والوجود التي تعني بالطبائع الثابتة وليس بالفيزيقيا المتغيرة. أما وفق الاسمية فلا وجود لهذا المشترك بل للأفراد فقط وما هذه الكليات إلا ألفاظ ورموز وليس لها خارج التصور الذهني وجود حقيقي، بعکس العبارات المتعلقة بالأفراد فهي تدل على أمور واقعية؛ لأنه يمكن إدراك الأفراد هنا بطريق الحواس ولهذا يمكن ملاحظة أن هذا الحائط الأبيض يشبه حائطًا آخر له اللون نفسه، لكن هذا التشابه لا ينطوي على نوع من البياض المجردة ليكون مشترکًا بينهما.
يري بيير دوهيم ـ مؤرخ وفيلسوف العلوم ـ أن سبب تقهقر المشائية أواخر القرون الوسطى إنما يعود إلى تنامي النزعة الاسمية عند اللاهوتيين أمثال وليم أوكام ودانز سكوت وروجر بيكون والتجريبيين الباريسيين أمثال جون بوريدان ونقولا أوريزم وغيرهم إبان القرن الرابع عشر الذين تصوروا علمًا خاصًا بالميكانيكا مختلفًا عما قال به أرسطو والمشائيين من بعده وهو وثيق الصلة بميكانيكا جاليليو واللاحقين.
من الأعراض إلى العلاقات
أما الفرق الخامس فنراه في عناية العلم الحديث بالعلاقات القائمة بين الظواهر المختلفة. مع أن المنطق القديم كان قائمًا على نظرية في الطبيعة تجعل العلاقات كلها أمورة عرضية لا تمس جواهر الأشياء وحقائقها فتعلق شيء بشيء سواه معناه من وجهة النظر الأرسطية أن يكون الشيء معتمدًا على شيء خارج عنه، وما دام خارجًا عنه فليس هو جزء من طبيعته بل هو من أضداده. فجوهر الشيء المعين مستقل بذاته مكتفٍ بكيانه، والجوهر وحده هو الذي يصلح أن يكون موضوع العلم بمعناه الصحيح. أما العلاقات الظاهرة بين الأشياء فهي – شأنها شأن الاختلاف الكمي فيها – أعراض تجيء وتذهب ولا شأن للعلم بما يتغير ولا يثبت على حال. فكون الشيء هنا الآن وفي موضع آخر في لحظة أخرى ضرْب من التغير إن وجد مكانه عند الحواس فهو لا يجد عند العقل مكانًا، وهو إن لوحظ في المادة الدنية فهو لا يطرأ على المعاني العقلية المجردة وإذن فليس هو من العلم وإذن فليس هو ما يعني به المنطق- فأين هذا كله من العلم الحديث الذي يجعل التغير وما فيه من علاقات تربط المتغيرات موضوع البحث العلمي؟
من معرفة الطبائع إلى الانتفاع بالطبيعة
عند المناطقة لا تكون ذا علم بالطبيعة إلا إذا أدركت بالعقل ماهيات الأشياء الحقيقية، فماذا يجدیك أن تعرف درجة حرارة الجو اليوم ودرجة حرارة هذا الماء وهكذا؟ إن هذه كلها أعراض تجيء وتذهب وما تنفك تتغير لحظة بعد أخرى وإنما الجدوى كل الجدوى هي أن تعرف ما الحرارة على إطلاقها باعتبارها حقيقةً قائمةً بذاتها في الكون في الطبائع الثابتة وليس من ماهية الحرارة أو جوهرها أن تقیس درجاتها التي تقل هنا وتكثر هناك. واختلاف الدرجة هذا إنما يدرَك بالحس لا بالعقل، فإذا وقفنا عنده كنا بمثابة من يقف عند مدخل المعرفة الخارجي، مع أنه لا معرفة إلا إذا جاوزنا مرحلة الحس إلى مرحلة الإدراك العقلي. أما الانتفاع بالعلم كغاية فى ذاتها بغض النظر عن معرفة ماهيات الأشياء وغاياتها فقد أخذ مكانته في أوروبا مع عصر النهضة والإصلاح الكنسي، وتحدث عنه بيكون بما سماه السيطرة على الطبيعة وتطويعها.
نقض مبدأ إنقاذ الظواهر
يصادر هذا المبدأ مسلمة التطابق بين العقل والطبيعة عند لحْظ أي تعارض مرصود بين الوقائع الخارجية للطبيعة والمسلمات العقلية حولها. على سبيل المثال تبدي البيانات الملحوظة للحركات الفلكية بأنها تتحرك حركات غير دائرية بالتمام. في حين أن المسلمة العقلية لنظام أرسطو توجب أن تكون هذه الحركات دائرية الشكل تمامًا باعتبارها أكمل الأشكال؛ لذلك لم يلتفت أتباع النظام القديم المدرسيون إلى ما قدمه جاليلو إبان النهضة العلمية الحديثة من رؤى حسية تثبت خطأ علم الفلك البطلیمي أو التقليدي الذي عوّلوا عليه، فقد استعان جاليلو بمقرابه لتقريب فكرة خطأ التصور الفلكي القديم المبني على المسلمات العقلية وفكرة الكمال والجمال، إذ تبين أن للمشتري أقمارًا تدور حوله دون أن يكون لها علاقة بالأرض وأنها لم تكن محسوبة ضمن حسابات الفلك القديم. وقد رفض خصومه النظر في مقرابه لرؤية هذه الأقمار أصلًا. يقول جاليلو بهذا الصدد: “حين رغبت أن أُري النجوم التابعة للمشتري لأساتذة فلورنسا رفضوا أن يراقبوها أو أن ينظروا بالتلسكوب ويعتقد هؤلاء الناس أن ليس من حقيقة في الطبيعة للبحث عنها وأن لا حقيقة سوى ما يمكن مقارنته في الأصول.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر: ــ المنطق الوضعي، زكي نجيب محمود، مكتبة الأنجلو المصرية، الفصل الحادي والعشرون: الأورجانون. ــ نحو فلسفة علمية، زكي نجيب محمود، مكتبة الأنجلو المصرية، الفصل الحادي عشر: من الكيف إلى الكم. ــ أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، لوك فيري، مكتبة التنوير، الفصل السادس أرسطو وتخصيب الفلسفة بالملاحظة. ــ ظاهرة العلم الحديث، عبد الله العمر، عالم المعرفة، الفصل الرابع عشر: السابقون على جاليليو . ــ المنطق نظرية البحث، جون ديوي، ترجمة د.زكى نجيب محمود، التصدير بقلم د. زكي نجيب محمود. ــ منهج العلم والفهم الديني، يحيى محمد، الفصل الأول: النظام الإجرائي. - تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، يوسف كرم، مكتبة هنداوي، الفصل الرابع: الاسميون الباريسيون.
إعلان
