قراءة في كتاب الإرهاب وصناعه المرشد / الطاغية / المثقف
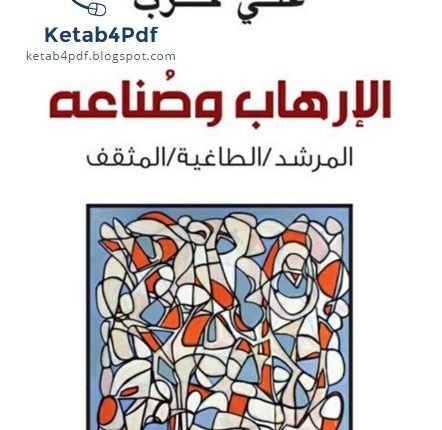
أصبح الصِّراع في مصر الآن بين إخوان مسلمين ومجلس عسكري وبين إخوان وسلفيين وبين مسلمين ومسيحين وبين سلفيين وصوفيين وبين أزهريين وسلفيين وأزهريين وإخوان، وبين موالي لقطر وتركيا وموالي للسعوديَّة والإمارات وغيرها من الصِّراعات الجزئيَّة.
انتقل الصِّراع في مصر لدرجاتٍ كبيرة من الإرهاب والتخوين والاتهام بالعمالة والاستهانة بالمُمتلكات والأرواح. ولهذا قرَّرت تقديم قراءات لكتب تحاول تحليل وتفكيك وضعنا الراهن للوصول لموطنِ الخلل وعلاجه ومنها كتاب الإرهاب لفرج فودة وهموم داعية لمحمَّد الغزالي والإسلام بين المدنية والعلم لمحمَّد عبده وغيرها من الكتب. وسوف أراعي في اختياراتي التَّنوع بين اليسار واليمين والوسط وبين ماهو روحانيٌّ وماهو مادي فالتَّنوع في الأُطروحات ودراستها يُعطي مساحة أكبر للتَّشخيص.
سأبدأ بكتاب علي حرب الإرهاب وصُنَّاعه، وقد انتقيت من الكتاب مايناسب حالة الإرهاب وأسبابه وطرق علاجه بصورةٍ عامة وذلك لأنَّ دراسة علي حرب يركز فيها على الحالة اللبنانية وإرهاب حزب الله من جهة وداعش من جهة أخرى.
يقول علي حرب أنَّنا إزاء عالم مشلول وعاجز عن إدارة شؤونه وتطوير أوضاعه باستخدام لغة العصر ومفاهيمه أو قيمه ووسائله. مايجري هو العكس تمامًا، بعد أن تمَّ الإنقلاب على الثورات التي قامت بها الأجيال الجديدة ضد الطغيان والفساد، سواء من جانب القوى القديمة المُضادة لأيّ تغيير أو إصلاح أو تحديث، أو من جانب القوى الأصولية التي ركبت الموجة الثورية وحاولت استغلالها لترجمة مشروعها الذي ينتج كل هذه الدِّماء وكل هذا الدمار.
وإذا كان العالم العربي يشهد على عجزه فإنَّه مُستهدفٌ من الخارج بتوسل الدُّولِ الكُبرى والقوى الفاعلة: أمريكا وروسيا وإيران وتركيا. ولذا لايصح الحديث عن الوضع العربي من دون التَّطرق للوضع العالمي، لأنَّ الأزمة العربيَّة هي وجه من وجوه الأزمة العالميَّة. ومن السذاجة والغفلة الإعتقاد أن اللاعبين العالميين سوف يساعدون على حلِّ المُشكلات في البلاد العربيَّة. إذ لكل لاعب حساباته الخاصة وربَّما أهدافه المشبوهة. ومن هنا فهم يتعاملون مع هذا البلد العربي أو ذاك كساحةٍ للصِّراع وتصفية الحسابات، أو كأداة للضغط وورقة للمفاوضة ممّا يحوله إلى رهينة بيد هذه الدولة أو تلك.
وفي ظلِّ وضعٍ مأزوم وبائسٍ كهذا الوضع الذي يتسمُّ عربيًا بالشلل والعجز والتَّردي كما يتسمُّ عالميًا بالتَّورط والتواطؤ، ما الذي يمكن أن نفعله؟. لاشك أنَّ الحلول ليست سهلة بل هي مُعقَّدة وشبه مُستحيلة ومع ذلك لامهرب من أن نفكر في ابتكارِ الحلول:
1 – عدم استقواء أي طرف بالخارج على طرف آخر.
2 – الحل يقتضي تشكيل قناعات جديدة بحيث يعترف الواحد بأنَّه يخطئ ولايملك الحقيقة وإلا وقع في خطأ مضاعف، ومارس جهلًا مُركبًا بالذَّات والآخر والواقع. مثل هذه القناعة تعني كسر إرادة التَّملك والقبض والتحكم.
3 – لاحلول من دون كسر عظام أنماط التَّفكير السائدة والمستهلكة التي تعيد إنتاج الأزمة بشكلها الأسوأ.
من هنا فالحل يحتاج إلى خيالٍ خلَّاق يجترح إمكاناتٍ جديدةٍ للعملِ الوطني نبتكرُ معه صيغ جديدة، مرنة يجد فيها كلّ فريقٍ قسطه ويمارس دوره في بناء المجتمع وتقدُّمه.
ثالوث الإرهاب المرشد والطاغيَّة والمُثقف
إنَّ هذه المقاربة النقديَّة لظاهرة الإرهاب وإن تمَّ التَّركيز فيها على المؤسسة الدينية فإنَّها ليست وحيدة الجانب وإنَّما تشمل ثلاثة فاعلين يُشكِّلون ثالوث المرشد والطَّاغية والمُثقف:
1 – المرشد الذي يُسخِّر اسم الله لسلطته وأهوائه أو لأحقاده ومغامراته بقدر مايتعامل مع كل من لا يفكر على شاكلته بلغة التَّكفير والإرهاب والاستئصال.
2 – الطَّاغية الذي يتعامل مع بلده كمالك الملك كي يتصرف في ملكه كما يشاء. والحصيلة هي الاستبداد والفساد والإرهاب، والإطاحة بمكتسبات الدولة الحديثة فيما يخصُّ مفاهيم المواطنة والعلمانية والديمقراطية.
3 – المثقف الذي لم يحسن طرح أفكاره ولم ينجح بالعمل عليها لإعادة ابتكارها وتحويلها بحيث تترجم لمنجزٍ حضاري سياسي أو اقتصادي أو مجتمعي.
إعلان
هل الإسلام دين متطرف أم معتدل ؟
هذا السؤال قد طُرِحَ في الآونة الأخيرة بعد أن صدم المسلمون والعالم أجمع بالتَّصرفات الهمجية للحركات الجهادية، كما جسدها تنظيم داعش في ما أقدم عليه بعد سيطرته على أراض واسعة في سوريا والعراق وإعلانه دولة الخلافة من أعمال سبي واغتصاب وتنكيل وقتل وتهجير وتطهير طائفي ومذهبي بحق المسلمين وغير المسلمين. ولمعالجة هذا التساؤل يحسن مقاربة مصطلح الإسلام مقاربة مركبة وعلى غير مستوى أو وجه حضاري ومدني، أو علمي ومعرفي أو عقائدي وثقافي.
الأول هو المستوى الحضاري، حيثُ الإسلام تشكل كعالمٍ واسعٍ متعدد الأبعاد مُتَّنوع العناصر والفئات والتَّيارات، إذ تعايشت في فضائه ديانات وطوائف وأمم ولغات شتى وإن حصل ذلك في ظل هيمنة اللغة العربيَّة والعقيدة الإسلاميَّة. على هذا المستوى تكوَّنت وازدهرت حضارة إسلامية استوعبت خُلاصة الثقافات والديانات القديمة والسَّابقة، لكي تُضيف الجديد والثمين إلى سجل الحضارة والمدنيَّة، سواء على مستوى الفلسفة والعلوم أو الآداب والفنون أو الشرائع والقوانين. مثل هذا الفضاء الحضاري هو الذي أتاح ممارسة حريَّة الفكر التنويري النقدي والعقلاني تجاه الدين. وكما تمثل ذلك لدى العديد من أعلام الفكر والفلسفة كالفارابي والنّظام والمعري وابن الراوندي وابن رشد وابن العربي وسواهم من الذين أخضعوا الإسلام لنقد عقلي يقصر اليوم عنه كثيرون ممَّن يدَّعون الحداثة والعلمانيَّة.
وماكان للإسلام أن يصبح عنوانًا لحضارة مزدهرة لولا أنَّ بعض مكوناته الحيَّة وحقوله الديناميكية من حكام وعلماء وتجار ومغامرين وبناة مبدعين قد اشتغلوا بمنطق الانفتاح والتعدد والتبادل أو بلغة الخلق والابتكار والتجديد في مواجهةِ القوى المحافظة والتَّيارات الأصوليَّة أي ماكان يسمَّى يومئذٍ أهل النقل والنص والحديث.
ومعنى ذلك عند من يقرأ ماحدث أنَّ هوية المسلم قد تشكلت وتخلقت وتركبت، بل أُعيد بناؤها وتركيبها وتغييرها باستمرار حدثًا بعد حدث وتجربةً بعد أخرى وطورًا بعد طور في ضوء المُستجدات والتَّحولات وعلى وقع الخلافات والصِّراعات على السلطة والثروة والمعرفة وسائر مصادر القوة، بقدر ماكانت تتغذى من الثقافات المحلية والوطنية للشعوب والأقوام التي انخرطت في مشروع الدين الجديد.
ولذا فإنَّ هذه الهوية كانت تغتني بقدر ماتتنوع وتتهجن أو تتكيف وتتعدل بحسب البيئات والثقافات والعصور وذلك في غير وجه أو بعد، من مفهوم الذَّات الإلهية إلى المذاهب الفقهية، ومن كيفية أداء الصلاة إلى أسلوب عمارة المساجد. ومن عادات الزَّواج إلى أعراف الإجتماع.
هذا ماينقلنا للمستوى الثاني وهو بيت القصيد وأعنى به النَّظر إلى الإسلام على المستوى اللاهوتي بوصفه منظومة عقائدية قوامها جملة تعاليم وأحكامٌ يعدُّها المسلم بمثابةِ حقائق مطلقة ونهائيَّة غير قابلة للمُساءلة والمُناقشة بل يجبُ العمل بها وتطبيقها وبالتَّالي نحن أمام معتقد اصطفائي يصنع لأتباعه هوية نرجسية استثنائية بين البشر بوصفهم الأُمَّة التي اختارها الله ليختم رسالته.
ومن شأن هذه الهويَّة المغلقة على ثوابتها ومحرماتها أن تُقَولِب العقول وتختم على الأجساد لكي تصنع من وجهه الأول النَّموذج المثالي للمسلم كما يتمثل في تقديس النصوص وتقليد السلف تقليدًا أعمى ولكي تقيم من وجه آخر جدرانًا عازلة بين المسلم وسواه بل بين الناس عامَّة من خلال ثنائيات تفصل على نحو حاسم بين الإيمان والكفر أو الطهر والرجس أو الطَّاعة والخروج، أي بين العبودية المقنعة بتأليهٍ بشري لسواه وبين استقلاليَّة الشخص البشري وحريته في التَّفكير.
وبالتالي إذا كان المسلمون قد انفتحوا على بعضهم البعض وعلى غير المسلمين وبالعكس، قد انفتح غير المسلمين على المسلمين. فالمسيحية لم تعمل بلغة التسامح إلا بعد هزيمتها أمام العالم الحديث بقواة الحية والصاعدة. هذا مع أنَّ التَّسامح لايحل مشكلة لأنه لايبنى على الإعتراف بالآخر وبأنَّ له قسطه من الحقيقة، بل هو مجرد تساهل تجاهه مع الإعتقاد في قرارة النفس بأنَّه مخطئ أو منحرف أو آثم.
أيًا يكن فالقيم المتعلقة بالتَّسامح والإعتدال أو التعدد والتواصل سواء منها ما اقتبس من أوروبا أو ما أُخِذ من كتب التُّراث الديني قد تمَّت استعادتها أو جرى استثمارها بفضل الاندراج في العالم الحديث بعناوينه وقيمه ونظمه ومؤسساته، ولذا عندما عاد المسلمون عن مكتسبات الحداثة كل إلى فقهه وعقائده لم يكن أمامهم سوى الغرق في متون الفتن المذهبيَّة بأبشع أشكالها. وتلك هي عاقبة الإرتداد عن لغة العصر ومفاهيمه للعمل بصيغ ونماذج وأحكام قد استهلكت وفات أوانها.
لنعترف إذًا بما تصنعه أفكارنا ودعواتنا. كلنا يستخدم الدين للهدم لا البناء وللتَّفرقة لا للتَّواصل وللهيمنة لا للتدبير العاقل والإدارة الرشيدة. ومن المُفارقات أنَّ للإسلاميين أي أصحاب مشاريع الخلافة الإسلامية والولاية الفقهية والحاكمية الإلهية دولًا وحكومات أو أحزابًا ومنظمات لا يقيمون وزنًا للقيم التي هي أساس الشرائع والأحكام والتي يكون بها الإنسان إنسانًا، كالتُّقى والتَّواضع والعفو والتَّعارف والتَّكافل والتَّراحم، لأنَّ هاجسهم هو الوصول إلى السلطة والقبض عليها بأي ثمن، أي انتهاك كل مايدعون محاربته. وهكذا فالجميع سواء، إذ كلهم يصنعون النماذج التي يدَّعون محاربتها. ولهذا نرى أنَّ من يتَّهم غيره بممارسة التكفير والإرهاب هم تكفيريِّن أصلًا وفصلًا ، وهو أول من صنع الإرهاب وصدره، كما نجد من جهة اخرى أن داعية الديمقراطية يدعم الأنظمة الاستبدادية كما يمشي داعية العلمانية في ركاب الأنظمة الدينية أو يتعامل مع علمانيته بصورة لاهوتية.
وهذا هو التحدي أمام الإسلاميين وسواهم : الاشتغال على التراث الديني لتحويله لعملة حضارية راهنة، قابلة للتداول والتبادل لكي يسهموا في صناعة الحياة ويشاركوا في بناء الحضارة القائمة. فالأديان والمعتقدات هي لخدمة الحياة وليس العكس، كما يعتقد السلفيون والإسلاميون. نحن لانعيش لكي نخدم الإسلام وسواه من العقائد والأفكار، أكانت دينية أو علمانية، بل لكي نتقن فنَّ العيش وبالأخص لكي نحسن العيش سويًا. وهذا يقتضي إجراء تغيير جذري يطال المسلم بهويته الدينية، على نحو تتغير معه أطر النظر ومناهج العمل ومباني العقيدة ومقاصد الشريعة.
الفرق بين اليوم والأمس:
يتجسَّد الأصل لدى الأصولية الإسلامية في النَّص الذي هو القرآن أو الحديث النبوي ولكن أصبح الأصل الآن تفاسير العلماء وأقوالهم التي تحل محل النص الأصلي في النهاية. حيث أنَّ كلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم باتت من الدرجة الثانية أو الثالثة قياسًا على الرموز الخاصة بكل مذهب إنساني. وذلك هو مآل كل أصولية تقوم على عبادة الأصل واحتكار الحقيقة وانتهاك الأصل واستئصال الآخر. ومن هنا تشكل الأصولية منبعًا لاينضب لممارسة التَّعصب والتَّطرف والعنف.
على المستوى المعرفي لا جدة في الخطاب الديني لدى الإسلاميين بل هم تراجعوا عن عصر النهضة والتنوير العربي. فمحمَّد عبده مثالًا كان مفكرًا تنويريًا بقوله ( بعد وفاة النبي لا وصاية على العقل لأحد) بينما نجد اليوم داعية لم يحصل من العلم إلا القليل يعتبر نفسه وصيًا على الأمة أو نجد طالبًا من طلاب العلوم الدينية ينصب نفسه أميرًا للجهاد ويعلن حربًا تقود المسلمين لهلاكهم.
نجد العالم الإسلامي يتسمُّ بالفقر المعرفي والخواء الفكري والتشبيح الثقافي، بقدر مايتشبث أهله بثوابتهم المعيقة وبقدر مايشتغلون بالتبرير الأيديولوجي لتمويه الحقائق وطمس الوقائع. أو للدفاع عما ينافي العقل والحس السليم مما حفلت به كتب التراث من الأكاذيب والشعوذات والترهات. وهكذا لاجديد لدى الذين يريدون إصلاح الأمة بل عناوين مستهلكة أو شعارات قديمة أو قوالب جامدة للختم على العقول والأجساد.
ليس هذا فحسب بل هم ومن أجل تسويق مشروعهم في الصحوة وإلباسه لبوسًا حداثيًا يقتبسون أحيانًا بعض الأفكار التي ينتجها مفكرون غربيون وعرب حول النهوض والتحديث وينسبونها إلى أنفسهم لكي يحولوا النهضة والصحوة إلى عتمات دامسة. فيا خجلنا من الخوارزمي وجابر بن حيان وابن الهيثم الذي كانت لهم إنجازات في علوم الجبر والكيمياء والفيزياء. ومن ناحية أخرى مايميز العقل الاستبدادي الديني هو الوهم الأيديولوجي الذي عشَّش في أذهان جماعة الإسلام السياسي ومفاده أنَّ المسلمين هم أمة واحدة ولكنَّ الاستعمار فرقهم والحداثة أخرجتهم عن دينهم الحنيف. هذا الوهم نفسه الذي عشَّش في عقول أصحاب المشاريع العروبية الوحدوية، ولذا فالكل تعاملوا مع شعارات التوحيد والوحدة والخلافة بصورة سحرية طوباوية أو أحادية تبسيطية بل بصورة عنصرية فئوية، بقدر ماتعاملوا مع الواقع المجتمعي بتنوعه وتعقيداته بتناقضاته وشروخه، بالتباساته وأفخاخه بتحولاته وأطواره. وكانت النتيجة مزيدًا من الفرقة والتجزئة. وكما أنَّ العروبيين دمَّروا فكرة الوحدة وأثبتوا أنَّهم عاجزون عن توحيد حي في مدينة فإنَّ الإسلاميين لم ينتجوا أيضًا سوى الشرذمة والتفتيت بقدر ما أثبتوا عجزهم عن توحيد فصيلين يتقاتلان في جبهة واحدة كالنصرة وداعش.
هناك فارق كبير بينهم وبين السلف الصالح:
1 – الأول كانوا خلاقين فاتحين، بقدر ماكانوا بناة للحضارة بقدراتهم الخلاقة ومبادراتهم الفذة في حين أنَّ المعاصرين هم تابعون مقلدون عاجزون لايشبهون الأول إلا من حيث الإسم والحرف والطقس.
2 – الأول فرقوا بين الدين والدولة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين الذي كان عصرهم استثنائيًا. تجلى ذلك في الفصل بين الحكام والعلماء بين المجالين السياسي والديني. ولذلك لم تسمى الدولة يومئذٍ بإسم الإسلام بل بإسم بناتها والقائمين بها. أما المعاصرون فهم يريدون الجمع بين السلطتين الرمزية والسياسية ليفشلوا في كليهما وليمارسوا استبدادًا مضاعفا.
3 – الماضون كانوا متواضعين، لم يدعوا بأن الإسلام هو دين العقل، لأن أساس الدين هو الوحي الذي يضرب بجذوره في منطق اللامعقول. ولكن القدامى استثمروا العقل واستثمروا طاقاتهم الفكرية، في تأويل النصوص وقراءة الواقع المتحول أو المفاجئ. بالإفادة من منجزات الحضارات السابقة فأنشأوا علومًا جديدة وطوروا علومًا قديمة. أما المعاصرون فعلاقاتهم بالمعرفة تقوم على الإدعاء والتشبيح أو على السرقة والسطو على منجزات الغير. ومن هنا انتهى المشروع الديني على يد دعاته وحراسه للإخفاق الذريع والانهيار الشامل. فهم مادافعوا عن قضية إلا وعملوا بعكسها ومارفعوا شعارًا إلا وتُرجِم ضده كما تشهد عليهم أعمالهم مثل:
1 – دعو للوحدة الإسلامية فعملوا على تفكيك الدول ونسف وحدة الأوطان وتمزيق المجتمعات.
2 – طالبوا بإقامة دولتهم فكانت الحصيلة ازدهار مهنة رجال الدين الذين احتلوا الشاشات والساحات ليبتلعوا باقي السلطات العائدة للأهل والمعلم والنقابي والمثقف والسياسي. وازداد الخراب أكثر حين ساعدهم انتشار المافيات المالية والميليشيات الأمنية.
3 – دعو لاحترام المقدَّسات والقيم الدينية وكانت الحصيلة انتهاك كل القيم الخلقية والإنسانية كما تشهد أعمالهم البربرية من تفجير المدارس إلى تفجير المساجد ومن خطف الطالبات لاغتصاب النساء ولا يضاهيهم في همجيتهم إلا الوجه الآخر للعملة، أي الطاغية الذي يدمر بلده ويفتك بشعبه.
4 – ادَّعوا أنهم يملكون الحل والبديل بعد صعودهم على المسرح ولكنهم أثبتوا جهلهم بالسياسة التي تحتاج عقول مفتوحة مرنة ومركبة تحسن الإدارة والتدبير.
في ضوء هذه القراءة للمشروع الديني أخلص للنتائج التالية:
1 – ماعاد مجديًا الاشتغال بالمصالحة بين الإسلام والحداثة.
2 – الكف عن استخدام الصِّفة الدينية في تعريف الدول والمجتمعات أو تعريف الأفراد والمؤسسات.
3 – لم تعد قضية الإصلاح الديني هي الإشكالية، نحن نعرف أنَّ هذه القضية مطروحة منذ زمن، كان للمفكر محمد إقبال الباكستاني محاولة في هذا الخصوص وفشلت. وكان للشيخ محمد عبده محاولات ولكنه أدرك صعوبة المهمة بل استحالتها.
4 – لم تعد تجدي المؤسسات والأطر الدينية التي تجمعنا بالمسلمين غير العرب. فهي روابط لم نستفد منها منذ أبي الحسن الندوي إلى الخميني. إذ صدرت لنا العقائد التكفيرية ثم النماذج الإرهابية. الأحرى أن نهتم بشأننا العربي خاصة وأن العالم العربي هو اليوم مستهدف من جانب اللاعبين الكبار على المسرح : أمريكا وروسيا وتركيا وإيران.
5 – وليستيقظ من سباتهم أولئك المثقفون العرب الذين يدعون إلى إقامة الحوار مع إيران على سبيل التبادل المثمر والبناء. لن يكون ذلك ممكنًا قبل انهيار النظام الشمولي القائم في طهران. تمامًا كما أنه ليس ممكنًا إصلاح الفكر الديني قبل هزيمة مشروع الإسلام السياسي. فالأجدى أن نقوم بعلاقات مع الدول الناجحة التي نفيد منها لا مع الدول الفاشلة والاستبدادية.
والسؤال الذي نود طرحه الآن، من الذي يسيء للإسلام؟ الرسوم المسيئة الكاريكاتورية أم أهله الذين يصرون على ممارسة هويتهم الدينية في هذا العصر بصورة هزلية كاريكاتورية أو عدوانية إرهابية. من يسيء للشرع والفقه؟ هل رسم امرأة مُبرقعة بصورةٍ سافرة أم الفتاوي المضحكة حول رضاعة الكبير أو مفاخدة الأنثى بقصد الاستمتاع ولو رضيعة. كما يفتي المفتون لدى السنة و الشيعة على السواء.
ونتحدث الآن عن مايقدمه العلماء الذين عقدوا مؤتمرًا في الأزهر المؤسسة الدينية الأبرز في العالم الإسلامي من أجل محاربة التطرف والعنف والإرهاب وللتأكيد على أن الإسلام دين الاعتدال والوسط والتسامح ولكن مافعلوه هو العكس وتصرفوا كشرطة للعقيدة أو كحراس للحقيقة. وحولوا المؤتمر لنقاشات بيزنطية حول ما إذا كان الداعشي الإرهابي هو مؤمن أو غير مؤمن . فيا لها من نصيحة.
ولذلك فالمصالحة بين الإسلام والحداثة لاتعني أن ننخرط في صراع حضارات لأنه بات من الخداع أن يصنف الإسلام بوصفه حضارة توضع في مواجهة الحضارة الغربية الحديثة. فالأحرى أن يصنف مع المسيحية واليهودية والبوذية وسواها من العقائد القديمة . إن الإسلام الذي كان في الماضي عنوانا لحضارة مزدهرة يتحول الآن كما يمارسها حراسه إلى هوية أثرية أو إلى ديناصور ثقافي أو بعبع خرافي أو تنين إرهابي في مواجهة موجات الحداثة المتلاحقة التي أفاد منها المسلمون وتأثروا بها وإن أنكروا ذلك وجهلوه .
في حالة أعجبك المقال، ربما ستعجبك مقالات أخرى، نرشح لك
نظرة في كتاب مذكرات حرب أكتوبر للفريق سعد الدين الشاذلي
علي الحفناوي يكتب: أصل الإرهاب
كيف تسببت الخيانة في القضاء على دولة المماليك ؟!
إعلان
