الطاعون في زمن الكورونا
دروس لم نتعلمها من رائعة ألبير كامو.
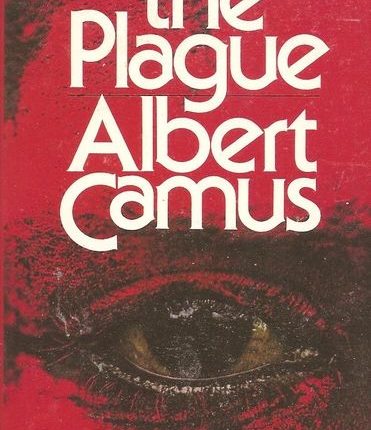
إنّ كُلَّ ما يستطيع الإنسان أنْ يربحه في معركة الطاعون والحياة هو المعرفة والتذكُّر.
-ألبير كامو
كيف سيكونُ شعورك حين تجد بَلدتك، بل وطنك كله، وهو معزولٌ عن بقيِّة العالم؟ الجميعُ أسرى لجدرانِ منازلهم، العدوى تنتشر، أرقام المصابين في اضطِّراد، والآلافُ منهم قيد الحجر الصحّي؟
كيف سيكون شعوركَ حين تعلم أنَّ العالم بأسره راضخٌ تحت وطأة هذا الدّاء العُضال؟ نيرون في روما يواجه الموت، تمثالُ الحريّة على أعتاب نيويورك؛ لا يبدو مُرحِّبًا بالقادمين عبر المُحيط نحو المدينة المنكوبة!، وأحفاد بُناة الأهرام في مصر يواجهون الهلاكَ وأبناء تونس الخضراء يصارعون الخوف و الهلع؟
فمن أجلِ مواجهة هذا الوباء، عُطِّلت الحياة اليومية، أُغلقت أبواب المدارس، وما بقي منها مفتوحًا تحوَّل إلى بواباتٍ توصلنا إلى المستشفيات الميدانيّة. لا مجال لتجمّعات عائليّة، لا مجال لحفلاتِ الزفاف ولا حتى سرادقات العزاء. أُغلقت المساجد والكنائس وانخفض صوت رجال الدين. عُلّقت الأحداث الرياضيّة والحفلات الموسيقيّة والمؤتمرات والمهرجانات ورحلات الطيران. كُل هذا لأجلٍ غيرِ مُسمى. أجواءٌ كابوسيّة، سوداويّة لمْ يتوقعها أكثرنا تشاؤمًا وعدميّة، ولكن بين هذا وذاك، وجد المواطن العالميُّ اليوم نفسه مساقًا نحو ما صاغَهُ روائيٌّ استثنائيٌّ بارع في خضم جو مُماثل، طغتْ عليه المشاهد الدّامية و خطابات الفزع. نعم، إنه صاحبُ جائزة نوبل في الأدب، العظيم ألبير كامو، الذي أهدانا رواياتٍ نُحتت عناوينها فوق حجر التاريخ، و من بينها روايتُه الخالدة التي يتذكرها الجميع كلما أحاط بالبشريّة خطر مُحدق!.
تذكَّرها اليابانيونَ مع أحداثِ فوكوياما سابقًا وتذكَّرها الأمريكان حينَ ضربهم إعصارُ كاترينا، والآنَ وبينما نعيش تحت أجواء “الكورونا” المرعبة، ارتأى البعضُ منّا أنْ يستغلوا ساعاتِ الحَجْرِ المنزليّ الإجباريّ إلى نفض الغُبار عن نُسخهم العتيْقة من روايةٍ لكلِّ العُصور، فيما توجَّه آخرون إلى المَكتباتِ ومواقع بيعِ الكُتب على الشبكة العنكبوتيّة، علَّهم يَحظون بنسخةٍ جديدةٍ منها.
اقرأ أيضًا: ألبير كامو بين الرواية والمسرحية
“الطاعون” رواية مُفزعة ومفسِّرة، تُخفيْ بين سُطورها حالاتِ القلق الاستثنائيّة التي تحياها الإنسانيةُ اليوم. سطورٌ كتبت إبانَ نهاية حرب عالميّة كبرى، واليومَ تدفعنا جائحةُ الكورونا إلى إعادةِ قراءتها بحثًا عن إجابة لسؤالٍ وجوديّ، عن هشاشةِ الوجود الإنسانيّ أمام كونٍ عدائيّ حتى النُخاع.
إعلان

عامُ الطاعون
1947 و ما أدراك ما 1947. هكذا تعلن أبواق التاريخ اليوم عن هذا العام تمامًا كما ستردد العدد 2020 في الأعوام القادمة. عامٌ صرخت فيه الإنسانية، تألمت، تكلمت حتى رأينا آلامها تُكتب بحبرٍ على الورق..
في مقالها على موقع literary hub بعنوان” ما يمكننا تعلُّمه من طاعون كامو” تحدثت ليزيل شيلينجر عن عام 1947 وهو العام الذي شهد مرورَ أربعةٍ وثلاثين سنة من -العمر القصير- للجزائريّ المولد، فرنسي الجنسيّة والهوى، ألبير كامو، الكاتب والصحفيُّ و الفيلسوف و الرِّوائي الذي فاز بجائزة نوبل للآداب بعدها بعشر سنوات، أي قبل ثلاثِ سنواتٍ فقط من مغادرة دنيانا إثرَ حادث سيارة.
1947، هو العام الذي طرح فيه كامو أسئلة حيّرتنا وظلّت تحيّرنا إلى يومنا هذا؛ العام الذي تمَّتْ عنونة صفحات “الطاعون” فيه، روايةٌ خياليّة تحكي وقائعَ سوداويّة لوباءٍ سيِّء السُّمعة يظهر فجأة، يجثمُ ثقيلًا ثمَّ ينسحب دون نذير نحو مخبئه الغامض، تاركًا الجميع في حيرة، يضربون كفًا بكفّ متسائلين كيف ظهر؟ وأين اختفى؟ ومتى يضرب من جديد؟.
خصَّ الكاتب بلدة وهرانَ الساحلية الجزائرية بوقائع روايته الفلسفية، وفتَّش في شوارعها عن معنى الوُجُود، والحدِّ الفاصل بين الحياة والموت في تلك الأيام من شهر نيسان/أبريْل، من أربعيناتِ القرن الماضي.
أسئلةُ الموتِ والحياة
نعم الطاعون هي في مجملها محاولةٌ للإجابةِ عن سؤال وحيد ” كيفَ نحيا والمَوتُ على الأبواب؟“.
في المقال المنشور على موقع صحيفة الجارديان “الطاعون لألبير كامو، قصةٌ لعصرنا وكلِّ العُصور” يقول إدْ فوليامي:
من بين جميعِ روايات كامو، جاءتْ هذه الرّواية لتمنحنا وصفًا رائعًا جليًا للحظاتِ مواجهة الإنسانِ لقَدَره وتعايُشهِ مع المَوت المتشكِّل على نطاق ملحميّ في صورةِ مرضَِّ الطاعون.
حكايات الموت الأسود “الطاعون”

درسٌ لمْ نتعلمه!
مع بدءِ القصة، تترنَّح الفئرانُ واحدةً تلو الأُخرى في ظلال وهران، وبمرور الوقت تتوالى “دفعات” حاملات الوباء خارجةً من جُحُورها لتسقط صريعةً، بشكلٍ بشعٍ من هبوطها إلى أزقّة المدينة الكئيبة .
كانَ الدُّكتور “ريو” طبيبَ البلدةِ، وهو أوَّل من واجهَ تلكَ الظَّاهرة، وحين يستدعي حارس منزله، “ميشيل” للتعامل مع الإزعاج، يبدو ميشيل “غاضبًا”، ويعزو الأمر إلى مداعبةٍ صبيانيّة من شباب الحي.
وعلى غرار ميشيل، فإن أغلبَ مواطني وهران يُسيئونَ تفسيرَ “تلك الشعوذةِ المُحيِّرة“، ولا يقدِّرون عواقبها. ولفترةٍ من الوقت، فإن الإجراء الوحيد الذي يقومون به هو إدانة إدارة الصرف الصحي المحلية والشكوى من السّلطات، تمامًا كما فعل الإيطاليون والأسبان اليوم . “كانوا بحسب قول كامو إنسانيين: كفروا بالأوبئة“. وحين سقط ميشيل ميتًا أثناء علاجه على يد ريو، الذي وجد نفسه هو والسلطة البيروقراطيّة في مواجهة الطاعون، أنكرهُ المحافظ واعتبره إنذارًا كاذبًا. أو “نوع خاص من الحمّى”. ولكن مع زيادة وتيرة وعدد الوفيات، يرفُضُ ريو العباراتِ الملطّفة، ويضطّر قادة البلدة إلى عزل المدينة عن العالم.
يقول كامو إنَّه ضعفٌ إنسانيّ عالميّ:
“الجميع يعرف أنَّ الأوبئةَ لها طريقةٌ متكررة في العالم، ولكنْ بطريقة ما نجدُ أنَّه من الصّعب أنْ نعتقد في أنَّها قد تسقط علينا فجأةً من السماء “.
وبعدها يبدأُ تركيز كامو على التداعيات العاطفيّة لوقت الطاعون: مشاعرُ العزلة والخوفِ التي نمرُ بها الآن مع انتشار فيروس الكورونا حول العالم.
في رواية كامو حارب الناسُ شعورهم بالعزلة بالتجوُّل بلا هدفٍ على طولِ شوارع وهران؛ واشتعلتْ الرغبة المحمومة للحياة التي تزدهرُ في قلب كل كارثةٍ كبيرة”: لمْ يكن لدى سكان مدينة وهران الملاذ الذي يتمتع به المواطنون العالميون اليوم، من رفاهيَّة التجوُّل في الواقع الافتراضيّ.
عاداتٌ جديدةٌ في زمنِ الكورونا
اليوم، ونحن منفيُّون في ما يشبه الإصدارَ الثاني من الطاعون يبدو كامو ماثلًا أمامنا ونحنٌ نتجوَّل في شوارعنا، مُحاولين قدرَ الإمكان تطبيقَ العاداتِ الاحترازيّة التي توصي بها وسائلُ الإعلام: غسلُ أيدينا. تجنُّب القُبلات والمصافحاتِ حين اللِّقاء وحينَ الوداعِ، والأفضل من كل ذلك أنْ نمارسَ أعمالنا عن بُعد حتى لا نقعَ فريسةَ للفيروس أو ننقله للآخرين، لا وقت للحفلات!.
لكنْ إلى متى يستمر الحجر وهل كان كامو يعرف الجواب؟
نرشح لك: الفَيْض. قراءةٌ في كتابٍ تنبَّأ بـ وباء الكورونا
إعلان
