ثرثرة فوق النيل: كيف أضفى حسين كمال قتامة على رؤية محفوظ؟
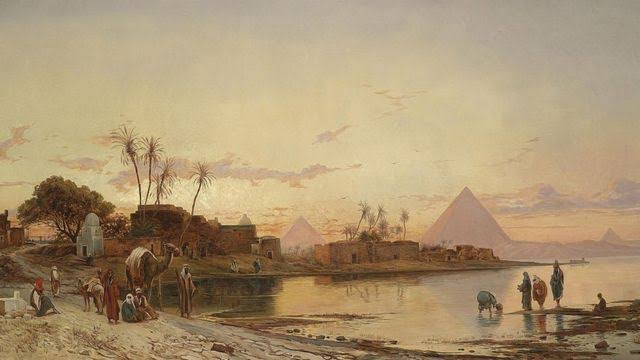
تأخذنا رواية ثرثرة فوق النيل لنجيب محفوظ، التي نُشرت عام 1966، في رحلة لاستكشاف الحالة المزرية التي كانت تعيشها مصر قبل النكسة، حيث تُشير الرواية إلى الهزيمة من خلال تصوير مجتمع فاسد يعاني من خيبة الأمل نتيجة الانتكاسات التي واجهها بعد ثورة 52؛ تضمنت هذه الانتكاسات فساد المؤسسات الحكومية والإعلام وانهيار الذوق العام. يقدّم محفوظ هذه المشكلات بأسلوب غير مباشر ودقيق، حيث تدور أحداث الرواية حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون كل ليلة لتدخين الحشيش على عوامة. ورغم أن القارئ يستطيع أن يستشعر النبرة الكئيبة للعمل، إلّا أنّ النقد فيه يبقى ضمنيًا، كما أنه يترك مساحة للأمل في نهاية الرواية. على الجانب الاخر، فإن النسخة السينمائية التي أخرجها حسين كمال عام 1971 أدخلت العديد من التعديلات وكانت أكثر كآبة ومباشرة إلى حد كبير، كما أنها لم تترك أي مساحة للأمل، بل كانت نهايتها مأساوية، وهو ما يمكن عزوه إلى تأثير النكسة التي زادت من عمق الجراح. وبالتالي، جاءت هذه النسخة أكثر قتامة من الرواية، لتعكس الأوقات الحزينة التي مرّ بها المصريون بعد النكسة.
حادثة التقرير: البيروقراطية والفساد
في بداية الرواية، يُطلب من أنيس كتابة تقرير وإرساله إلى المدير العام. يكتب أنيس معظم التقرير باستخدام قلم فارغ دون أن يلاحظ ذلك لأنه كان تحت تأثير المخدرات. على الناحية الأخرى، يتم تقديم هذا الحدث بشكل مختلف في النسخة السينمائية؛ حيث أُضيفت تفاصيل أكثر حول تقرير أنيس. ففي حين تكتفي الرواية بذكر أن أنيس كان عليه كتابة تقرير، تشير النسخة السينمائية إلى أن التقرير يهدف إلى نفي الادعاء الذي نشرته صحيفة الأهرام حول وجود نقص في الأدوية.
مونولوجات أنيس: من الخيال إلى النقد القاسي
خلال مونولوج، يتساءل أنيس عن سبب اضطراره لكتابة التقرير إذا لم يكن هناك نقص في الأدوية بالفعل. ويرى أن سبب ذلك يرتبط بفكرة الاكتفاء الذاتي، حيث يُجبر الموظّفين المدنيين على كتابة تقارير عديمة الفائدة لاستهلاك الورق، مما يُبقي مصانع إنتاج الورق قيد العمل. ويضيف أنّ جميع التقارير تُكتب بنفس الطريقة -أي بغياب وعي كتابها مثلما كان أنيس مغيبًا-، خاصة بعد أن اتهمه المدير العام بأنه كان تحت تأثير المخدرات أثناء كتابته للتقرير. يمثّل هذا المشهد نقدًا قاسيًا للفساد الذي كان يسيطر على المؤسّسات الحكومية في ذلك الوقت، وهو نقد لم يظهر في الرواية.
هذا المونولوج لأنيس هو جزء من الأفكار العديدة التي يعبر عنها طوال الفيلم أثناء سيره في الشوارع متحدّثًا مع نفسه، وهي على النقيض تمامًا من الرواية. ففي الرواية، يظهر أنيس كشخص كثير الشرود يتمتع بخيال واسع ومونولوجاته ليست تعليقات أو انتقادات، بل وصف لأفكار متفرّقة وبعيدة عن الواقع. حتى أثناء حديثه مع شخص ما، يكون ذهنه مشغولًا بأمور أخرى. على سبيل المثال، عندما كان المدير العام يطلب تفسيرًا لحادثة التقرير، كان أنيس يتأمّل في نشأة الحياة ويتساءل عن أسرار الكون والطبيعة، مما يعكس شروده وخياله الواسع:
– خبِّرني يا سيد أنيس كيف أمكن أن يحدث ذلك؟
إعلان
أجل كيف؟ كيف دبَّت الحياة لأوّل مرّة في طحالب فجوات الصخور بأعماق المحيط؟! (محفوظ، 8)
أما في النسخة السينمائية، فإنّ جميع تعليقاته مباشرة وسلبية، منتقدًا الوضع السيئ في البلاد، حيث يزعم أنيس أنّ مصر تعاني من تفاوت طبقي شديد، فيحصل البعض على أجور مرتفعة بينما ينغمس آخرون في الفقر. كما ينتقد لجان التخطيط التي تستمرّ في إصدار أوامر بالحفر في الشوارع لأكثر من مرّة لمجاري المياه وخطوط الهواتف والكهرباء، والذي يسبّب اضطرابًا في الحياة اليومية:
اللي يردموه يرجعوا تاني يفحتوه واللي يسفلتوه يرجعوا تاني يهدوه، مره علشان الكهربا ومره مواسير الميه ومره سلك التليفون ومره المجاري، يا مجاري في الدنيا يا مجاري، طب ما كانوا فحتوا مره واحده، مش بيقولوا في لجنة تخطيط؟ يمكن الواحد غلطان ولجنة التخطيط هي اللي صح. آه، ما دام بيجتمعوا كتير ويخططوا كتير يبقى لازم يفحتوا كتير. (كمال، 1971، 0:04:30)
الاستعارة من زقاق المدق: تناقض الحكومة
في مونولوج آخر في النسخة السينمائية، ينتقد أنيس الحكومة لكونها متناقضة، حيث تحظر الحشيش بينما تسمح بالخمر. ولكن هذه الفكرة لم تٌذكر في ثرثرة فوق النيل، بل في عمل آخر لنجيب محفوظ وهو زقاق المدق. في تلك الرواية، ينتقد المعلم كرشة الحكومة قائلاً: “إنها تحلل الخمر التي حرمها الله، وتحرم الحشيش الذي أباحه! وترعى الحانات الناشرة للسموم، في حين تكبس الغرز وهي طب النفوس والعقول” (56). على الرغم من أن حُجة المعلم كرشة باطلة، إلّا أنّ ذلك الاقتباس يدلّ على إلمام حسين كمال بأعمال محفوظ، مما جعل النسخة السينمائية أكثر غنىً وترابطًا. كما أنّ هذا الانتقاد يظهر بُعدًا سوداويًا، إذ أنّ زقاق المدق قد نُشرت قبل ثرثرة فوق النيل بنحو 20 عامًا، لكن أفكارها لا تزال قابلة للتطبيق، مما يكشف عن جمود الإيديولوجيات الحكومية.
العوامة كرمز للطبقية والأخلاق
في الرواية، العوامة التي كانوا يجتمعون فيها لتدخين الحشيش كانت ملكًا لأنيس، ويشهد القارئ اجتماعهم الأول معًا في الفصل الثالث، حيث يدخلون العوامة واحدًا تلو الآخر، وكانوا أصدقاء بالفعل قبل بدء أحداث الرواية. أما في النسخة السينمائية، فالوضع مختلف تمامًا؛ العوامة ملك لرجب القاضي، الذي كان أغنى بكثير من أنيس. عندما التقيا لأول مرة، ظهر رجب وهو يقود سيارة ربما من نوع شيفروليه، بينما يسير أنيس كعادته على قدميه في الشارع. ويمكن تفسير ذلك كانتقاد غير مباشر للرأسمالية.
في النسخة السينمائية، يلتقي رجب بأنيس أثناء قيادته للسيارة، ثم يدعوه إلى العوامة حيث يجتمع أصدقاؤه. في البداية، يظنّ الجميع أنّ أنيس ليس مدخنًا للحشيش، لكن المفارقة تظهر عندما يتضح أنه بارع في ذلك، بل ويزودهم بالحشيش، مما يدفعهم للهتاف: “يعيش وزير شؤون الكيف” (0:18:50)، وكأن العوامة تجسيد للبلاد. مرة أخرى، هذه الإضافة تجعل النسخة السينمائية أكثر سوداوية؛ فهي تُظهر انهيار القيم الأخلاقية، وكأنّ معيار النجاح هو القدرة على التعاطي.
دور الإعلام في نشر خيبة الأمل
في مشهد ليس له أي وجود في الرواية، يظهر رجب وهو يرقص وسط الفتيات احتفالاً بفيلمه الجديد، مرتديًا فستانًا ومكياجًا مبالغًا لدرجة أنّ المشاهد قد لا يتعرّف عليه في البداية. خلال هذا المشهد، يغنون كلمات مبتذلة وسخيفة: “الطشت قالي يا حلوة يا للي قومي استحمي” (0:37:13). وعندما يُسأل رجب عن معنى هذه الكلمات، يقدم تفسيرًا ساخرًا ومصطنعًا للأغنية، مما يكشف سطحية شخصيته.
يعكس مظهر رجب في هذا المشهد مرة أخرى انهيار القيم؛ فهو مستعدّ لتجاوز حدود العادات والتقاليد وارتداء ملابس نسائية من أجل كسب المال والشهرة. ومن المهم ملاحظة أنّ النسخة السينمائية بأكملها بالأبيض والأسود، باستثناء هذا المشهد الذي تم تصويره بالألوان. هذا التحول الرمزي يعكس موضوعات الأفلام، والأهم من ذلك، حالة الإعلام في ذلك الوقت، حيث كان المشهد جذابًا ظاهريًا بالألوان لكنه يفتقر للعمق، مما يعكس تدني الذوق العام.
لم يقتصر دور الإعلام على تدمير الذوق العام، بل كان له تأثير كبير في تعميق كآبة تلك الفترة. في مشهد آخر غير مذكور في الرواية، تسأل الصحفية سمارة: “تتوقعوا ان مشكلة الشرق الأوسط تتحل امتى؟” فيردّ مصطفى رشيد قائلاً: “لما نقرا في الجرايد إنها اتحلت” (1:20:41). يعكس هذا الرد فساد الإعلام في ذلك الوقت. وقد يكون رشيد أيضًا يشير إلى المذيع أحمد سعيد، الذي أعلن بفخر أثناء حرب 67 أنّ الجيش المصري قد أسقط عشرات الطائرات ودمر مئات المعدات الإسرائيلية، بينما كانت الحقيقة هي تعرض القوات المصرية والسورية لهزيمة ساحقة انتهت بسقوط سيناء في يد القوات الإسرائيلية.
النهايات المتناقضة: الأمل في الرواية مقابل اليأس في الفيلم
النهاية في النسخة السينمائية أيضًا كانت مختلفة تمامًا عن نهاية الرواية. اختتم محفوظ روايته بأمل في التغيير، حيث يُسلم رجب نفسه للشرطة بعد دهسه لأحد المواطنين بسيارته، وهو “رجل مسكين لعله من مهاجري الريف” (152). أما في النسخة السينمائية، فقد تم استبدال المواطن بفتاة فلاحة، وأدى موتها إلى ظهور واحدة من أكثر الجمل أيقونية في تاريخ السينما المصرية: “الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا” (1:52:17). يكرر أنيس هذه العبارة خلال نهاية الفيلم، مما يجعل من الواضح أن الفلاحة ترمز إلى مصر. في الوقت ذاته، يرفض رجب تسليم نفسه، مفضلاً البقاء في العوامة، بينما يخرج أنيس إلى الشوارع ليصرخ بعبارته الشهيرة ولكن دون جدوى، لأن كلماته لن تغيّر شيئًا؛ مرة أخرى، هذا التغيير يجعل النسخة السينمائية أكثر قتامة.
مراجع:
– نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل. دار الشروق، 1966.
– نجيب محفوظ . زقاق المدق. دار الشروق، 1947.
– حسين كمال مخرج. ثرثرة فوق النيل [فيلم]، إنتاج جمال الليثي، 1971.
إعلان
