عن ظاهرة الوظائف التافهة (مترجم)
الفذلكة في خلق الوظائف

المقال الذي بين أيديكم كان هو بذرة كتاب الوظائف التافهة “Bullshit jobs” للكاتب عالم الأنثروبولوجيا “ديفيد جريبر”. تُرجم الكتاب لعدة لغات لكن تلك هي المرة الأولى بالعربية.
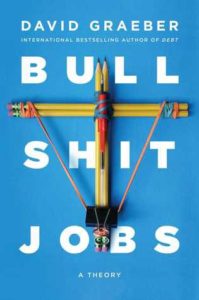
بعد انتشار المقال على الشبكة عام 2013، والذي كان دليلًا على اتفاق الناس مع المقال ومؤشرًا عامًا على وجود شيء ما خاطئ بالنظام ككلّ لدرجة اعتراف بعض الناس أنّ وظائفهم “تافهة”. قام بعض المجهولين عام 2015 بلصق بعض الاقتباسات من المقال تزامنًا مع انتهاء عطلات أعياد الميلاد وأول يوم عمل بالسنة الجديدة.


تنبأ جون مينارد كينز عام 1930 أنه مع نهاية القرن ستكون التكنولوجيا تقدمت بما يكفي ليكون عدد ساعات العمل الأسبوعية في دول مثل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة لا يتخطى 15 ساعة أسبوعيًا. وكان هناك فيض من الأدلة يدعم تنبؤه. ورغم أننا قادرون فعلًا على تحقيق تلك النبوءة من الجانب التكنولوجي، إلا أن هذا لم يحدث أبدًا. بل نُظمت التكنولوجيا لغرض واحد، وهو إيجاد سبل لدفعنا جميعًا لنعمل أكثر. ولهذا تم خلق وظائف لا معنى ولا أثر لها على الإطلاق. فيؤمن سرًا قطاع كبير من الناس – خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية – بأن حياتهم المهنية بأكملها غير ضرورية ولا حاجة إليها إطلاقًا. وينتج عن هذا الاعتقاد ندوب أخلاقية وروحية عميقة تغور عبر النفسية الجماعية ورغم ذلك لم يتحدث أحد فعليًا في هذا الأمر.
لماذا إذا لم تتحقق اليوتوبيا الكينزية الموعودة والتي ما زالت قيد الانتظار بشغف ممتد من الستينات؟ لأنه فشل في توقع التزايد الرهيب في النزعة الاستهلاكية. فعندما خُيرنا بين تقليل ساعات العمل وبين زيادة مشترياتنا، اخترنا بشكل جماعي الاختيار الثاني. مما يقدم لنا قصة أخلاقية لطيفة. لكنّ دقيقة تفكير بسيطة توضح أن هذا لا يمكن أن يكون حقيقيًا. شهدنا منذ العشرينات خلق العديد والعديد من الوظائف الجديدة المتنوعة، القليل منها له علاقة بإنتاج وتوزيع السوشي أو هواتف الأيفون أو الأحذية الرياضية الفاخرة.
إعلان
إذًا ما هي تلك الوظائف الجديدة على وجه التحديد؟ يوفر لنا تقرير حديث يقارن التوظيف في الولايات المتحدة بين عامي 1910 – 2000 رؤية واضحة للأمر (وأذكر أنه تكرر كالصدى في المملكة المتحدة). يوضح التقرير أنه على مدار القرن المنصرم حدث انخفاض مهول في عدد العمالة بقطاعات مثل الخدمة المنزلية والصناعة والزراعة. وفي نفس الوقت، استفحلت العمالة بقطاعات “الإدارة والأعمال المكتبية الروتينية والمهن الخدمية وخدمة المبيعات” وتضاعفت من “ربع إلى ثلاثة أرباع”. بعبارة أخرى، تحولت الوظائف الإنتاجية إلى يد الآلات بشكل كبير كما هو متوقع (حتى لو وضعت في حسبانك كل العاملين دوليًا مثل الجموع الكادحة في الهند والصين فلن يمثلوا نسبة كبيرة من سكان العالم كما كانوا في الماضي).
لكن بدلًا من السماح بتخفيض عدد ساعات العمل بشكل كبير لعتق رقاب سكان المعمورة للتفرغ إلى مشاريعهم الخاصة ومتعهم ورؤاهم وأفكارهم، شاهدنا تضخمًا في قطاع “الإدارة” وليس في قطاع “الخدمة” وصولًا إلى إنشاء صناعات جديدة بالكامل مثل الخدمات المالية أو التسويق عبر الهاتف، وكذلك التوسع غير المسبوق في قطاعات مثل “قانون الشركات” والإدارات الأكاديمية والصحية والموارد البشرية والعلاقات العامة. ولا تشمل هذه الأرقام حتى كل الأشخاص الذين تتلخص مهنتهم في توفير الدعم الإداري والفني والأمني لتلك الصناعات، أو تلك المجموعة الكاملة من الصناعات الفرعية (غسيل الكلاب، توصيل البيتزا طوال الليل) التي توجد فقط إثر إنفاق الآخرين الجانب الأعظم من وقتهم بالعمل في المجالات الأخرى.
“وتلك هي الوظائف التى أقترح تسميتها الوظائف التافهة”
“فيبدو الأمر كما لو أن هناك شخصاً ما يتولى مهمة خلق وظائف لا طائل منها لمجرد إبقائنا مشغولون.” وهنا بالذات يكمن الغموض. فهذا تحديداً ليس من المفترض أن يحدث تحت مظلة الرأسمالية. كان مفهوماً في الدول الاشتراكية القديمة الغير فعالة كالاتحاد السوفيتي حيث كان العمل يعتبر حقاً وواجباً مقدساً. فكان النظام يخلق قدر ما يستطيع من الوظائف (وهذا هو سبب مرورك على ثلاثة موظفين لشراء قطعة من اللحم في أحد المتاجر السوفيتية). لكن تلك المشاكل تحديداً هي المطلوب حلها عن طريق المنافسة في سوق العمل. فوفقاً للنظرية الاقتصادية على الأقل، إن آخر شيء ستفعله شركة تبحث عن الربح هو صرف مرتبات لعمال لا يحتاجون إلى توظيفهم. ومع ذلك فهذا ما يحدث.
وحتى عندما تحاول الشركات والمؤسسات تقليص العمالة الموجودة، سيكون كبش الفداء هؤلاء ممن يصنعون الأشياء أو يحركونها أو يحافظون عليها أو يقومون بصيانتها. والنتيجة: خلال بعض الوصفات الغريبة مستعصية الشرح والفهم، يزداد عدد الموظفين المكتبيين بلا نهاية، ليجد المزيد والمزيد من الموظفين أنفسهم – مثل الموظفين السوفييت- يعملون 40 أو 50 ساعة رسميًا على الورق بينما ينتجون فعليًا ما يساوي 15 ساعة كما تنبأ كينز، لأنهم يقضون فارق الوقت في ترتيب وحضور الندوات التنشيطية أو كتابة منشورات على الفيس بوك أو تحميل مجموعة برامج تلفزيونية لتزجية الوقت.
إن الإجابة على ما سبق ليست اقتصادية: بل أخلاقية وسياسية. أدركت الطبقة الحاكمة أن السكان السعداء والمنتجين والذين في نفس الوقت لديهم أوقات فراغ يشكلون خطرًا عظيمًا (تذكر ما حدث في الستينات عندما كاد أن يكون هذا هو الحال). بالإضافة إلى فكرة أخلاقية العمل في ذاته التي تؤدي بدورها إلى اعتبار أي شخص لا يرغب في وهب نفسه إلى روتين عمل صارم شخصًا لا يستحق أي خير؛ تمثّل مصدر راحة فائقة بالنسبة لهم.
ذات مرة، عندما كنت أفكر بالنمو اللامتناهي للأعمال الإدارية الروتنية في أروقة الأكاديمية البريطانية، تبادر إلى ذهني تصور محتمل للجحيم. حيث يكون عبارة عن مجموعة من الأفراد يقضون الجزء الأعظم من وقتهم في العمل على مهام لا يحبونها وليسوا جيدين بها بشكل خاص. تخيل أن يكون قد تم توظيف بعض الأشخاص لأنهم نجارون محترفون، ثم يكتشفون أنهم يقضون أغلب وقتهم في قلي السمك. وهي مهمة غير ضرورية بالأصل لسير العمل – أو في أفضل الأحوال يحتاج العمل إلى عدد محدود جداً من السمك المقلي. وبرغم هذا – وبشكل ما – أصبحوا مهووسين بفكرة أن زملائهم يقضون وقتهم في النجارة ولا يهتمون بمسؤوليتهم في قلي السمك والمشاركة معهم. وهكذا لن يمر وقت طويل حتى تجد أكواما من الأسماك سيئة الطبخ عديمة الفائدة منتشرة في ورشة العمل بأكملها، واستمرار تكدس تلك الأكوام هو الوظيفة الوحيدة لشخص ما. أظن أني وفقت في تقديم وصف دقيق لآليات أخلاقيات العمل تحت نظامنا الاقتصادي.
أنا أدرك بالطبع أن تلك الحجة ستُواجه باعتراضات فورية على شاكلة: “من أنت لتقرر أي الوظائف (ضرورية) فعلًا؟”؛ “ما هو (الضروري) بكل الأحوال؟”؛ “أنت أستاذ أنثروبولوجيا، لمَ قد نحتاج تلك الوظيفة؟” (ويعتبر معظم قراء الصحيفة بالفعل أن وجود وظيفتي كأستاذ أنثروبولجيا هو التعريف الأمثل لسوء الإنفاق الاجتماعي)، ومن جانب ما فإن هذا صحيح بشكل واضح لأنه لا يوجد مقياس موضوعي للقيمة الاجتماعية.
لكني لا أحاول هنا إقناع شخص ما مؤمن بأهمية وظيفته وأنه يقدم خلالها إسهامًا ذا مغزى للعالم، بالعكس. لكن ماذا عن الذين يعتقدون أن وظيفتهم بلا جدوى؟ منذ فترة ليست بالبعيدة تواصلت مع زميل دراسة لم أقابله منذ 12 عامًا وانبهرت إبّان معرفة أنه خلال تلك الفترة عمل أولًا كشاعر، ثم كواجهة فرقة روك مستقلة، سمعت بعض أغانيها على الراديو دون معرفتي أن هذا المغني هو صديقي. كان واضحًا للعيان كم هو مبتكر ومبدع وأن أعماله ألهمت وغيرت حياة العديد من الناس حول العالم. ومع هذا، وبعد فشل ألبومين له، فُسخ عقده، وغرق في ديونه مع مسؤولية طفلته الرضيعة فوق عاتقه. وهكذا انتهى به المسار إلى “اتخاذ الخيار التلقائي لهؤلاء منعدمي الطموح: مدرسة القانون” على حد تعبيره. وهو الآن محامٍ يعمل بشركة بارزة في نيويروك. كان هو أول من اعترف بلا جدوى وظيفته وافتقارها إلى المعنى، حيث لا تساهم بأي شيء ذا مغزى إلى العالم، وبالتالي لا يجب أن توجد بالأصل حسب تقديره الخاص.
وهكذا تطرح العديد من الأسئلة نفسها هنا مثلاً لا حصرًا: أي مجتمع هذا الذي يكون الطلب فيه على الشعراء الموسيقيين محدودًا بينما يحتاج عددًا لا محدودًا من المتخصصين في قانون الشركات؟
(الإجابة: إن كان 1% من السكان يتحكم بمعظم الثروة المتاحة، فإن ما نسميه “السوق” سيعبر عمّا يراه هؤلاء مفيد أو مهم، لا أحد آخر)
وما زاد الطين بلة، أنّ من يشغلون تلك الوظائف واعين تمامًا بانعدام جدواها. حتى أني لا أتذكر أنني قابلت محامي شركة لا يؤمن بتفاهة وظيفته. وينطبق الكلام أيضًا على جميع الوظائف والصناعات المذكورة أعلاه. فهناك طبقة كاملة من المهنيين مدفوعي الأجر يجب أن تقابلهم في أحد الحفلات على سبيل المثال وتبدأ الحوار بأنك تملك وظيفة تعدّ من الوظائف الشيقة (وليكن هدفك أستاذ أنثروبولوجي مثلًا) وستجده يتجنب مناقشة أي شيء يخص عمله بطريقة أو باخرى. الآن أعطه بعض كؤوس الشراب وستجد أن لسانهم قد انحل إلى خطبة مسهبة عنيفة عن مدى لا جدوى وغباء وظائفهم.
ألا يعتبر هذا اعتداءً نفسيًا قاسيًا؟ فهل للمرء التحدث عن كرامته الوظيفية بينما يؤمن سرًا بلا جدوى وجودها من الأصل؟ فكيف لا يخلق هذا شعورًا عميقًا بالغضب والسخط. ومع ذلك يجب الاعتراف بالعبقرية الفريدة لمجتمعنا حيث توصل حكامه إلى طريقة – كما في حالة قلي السمك – يضمنون بها توجيه هذا الغضب ضد أولئك ممن يعملون الأعمال ذات المغزى. يبدو على سبيل المثال أن هناك قاعدة عامة في مجتمعنا: كلما كان كان عمل الفرد يفيد الآخرين، كلما كان أجره أقل. وأؤكد مجددًا أنه من الصعب إيجاد مقياس موضوعي، لكن هناك طريقة سهلة لفهمٍ أعمقٍ للفكرة، وهي: تخيل ماذا سيحدث لو اختفت طبقة كاملة من الناس فجأة؟ قل ما تريد عن الممرضات، جامعي القمامة أو ميكانيكيّي السيارات، لأنه في حالة اختفاء هؤلاء في لمحة بصر ستكون النتيجة كارثة فورية. وعالم بدون مدرسين وعمال الموانئ سيكون مليئًا بالمشاكل، حتى هذا العالم الخالي من كتاب الخيال العلمي وموسيقي السكا* (السكا هو نوع موسيقي نشأ في جاميكا خلال العقد 1950، ومنه اشتق الريغيه والروكستيدي) سيكون عالمًا أقل قيمة. لكن ليس واضحًا تمامًا كيف ستعاني البشرية إن اختفى بنفس الطريقة كل المديرين التنفذيين، اللوبيات السياسية، الباحثين في العلاقات العامة، خبراء التأمين، المسوقين عبر الهاتف، حاجب المحكمة والمستشارين القانونيين (في الواقع يظن العديد أنه سيصبح العالم مكانًا أفضل). بالطبع بعيدًا عن بعض الوظائف المهمة وفي نفس الوقت ذات الأجر الجيد (الأطباء كمثال) فإن القاعدة تنطبق بشكل مدهش.
والأكثر سوءًا أن هناك ما يبدو أنه إحساس متفشٍّ أنّ هذا ما يجب أن تكون عليه الأمور، وهذا الإحساس يمثّل أحد نقاط القوة الخفية التي تفسر شعبية “اليمين”. فيمكنك رؤية هذا عندما قلّبت الصّحف النفوس ضدّ سائقي الحافلات لشلّ الحركة اليومية في لندن أثناء الإضراب: حقيقة أنّ سائقي الحافلات قادرين على شلّ لندن توضّح ضرورة وجودهم، ويبدو أن هذا تحديدًا ما يسبب السخط الشعبي. ويبدو هذا أوضح في الولايات المتحدة حيث النجاح الوحيد الذي حققه تيار اليمين هو تقليب النفوس ضد المعلمين في المدارس أو العاملين في مجال السيارات (وبشكل ملحوظ ليس ضدّ مديري المدارس وملّاك صناعة السيارات ممن هم أصل المشكلة) بسبب رواتبهم ومزاياهم المفترضة، كما وكأنك تصيح بهم “هل كل ما تفعله هو تعليم الأطفال وتصنيع السيارات! هل تظن تلك وظائف حقيقية! ورغم هذا تملك الجرأة لتتوقع المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية الخاصة بالطبقة الوسطى؟!”
لو أن شخصًا ما تمّ تعيينه لتصميم نظام عمل مناسب تمامًا للحفاظ على قوة الاقتصاد الرأسمالي، فقد قام بعمل لا يضاهى. حيث يتعرض العمال الحقيقيون والمنتجون الفعليون للضغط والاستغلال بلا هوادة. والباقي ينقسم بين طبقة يتم ترهيبها ووصمها عالميًا بالعار وهم العاطلون عن العمل، وبين طبقة أكبر يتم الدفع لها لفعل لا شيء حرفيًا وقد تم تصميم مواقعها الوظيفية لتتوافق مع وجهات نظر وأهواء الطبقة الحاكمة (المديرين، الموظفين المكتبيين، إلخ.). وبشكل خاص مع تجسداتها المالية. ولتعمل كحاضنة للسخط المتصاعد ضد أي شخص يشغل وظيفة ذات قيمة اجتماعية واضحة لا يمكن إنكارها. بالطبع لم يتم تصميم النظام عن عمد، لكنه خرج منذ قرن تقريبًا نتيجة التجربة والخطأ. ولكن ما سبق هو الإجابة الوحيدة على سؤال: لماذا -رغم قدرتنا التكنولوجيا- لا نعمل جميعًا لمدة 3-4 ساعات في اليوم؟
كتابة: ديفيد جريبر
ترجمة: عبدالله أمين
إعلان
